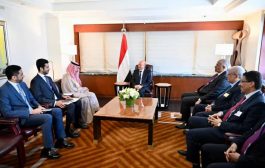حسن إسميك
ما دفعني لكتابة هذا المقال على حلقات وبعد انقطاع، أنني لمناسبة الموضوع الذي تناولته حول الرسائل والفيديوات والأنواع الأخرى من المحتوى، والتي تهدف إلى أن تلصق بالقرآن الكريم كل نتائج العلم وقوانينه ومقولاته، دخلت في حوار مع أحد الأصدقاء حول العلاقة بين العلم والإيمان. وفي الحقيقة كنت أظن فيه مثقفاً أصيلاً بناء على القليل مما رأيت من كتاباته، لكن الحوار المباشر ليس ككتابة ننتقيها عن تمهل وروية.
صاحبنا هذا كان متحمساً لخلط الحابل بالنابل وهو يعتقد أن البحث عن التوافق بين حقائق العلم وآيات الكتاب الحكيم عمل فكري عظيم، فيه الرد على المنكرين والملاحدة والزنادقة. ولما قلت له على رسلك يا رجل، أين هؤلاء الزنادقة والملاحدة الذين ترد عليهم وأنت وغيرك لا تنشرون هذه الرسائل والفيديوات إلا بين أهلكم واصدقائكم وبعض معارفكم؟ ثم قلي بربك كم ملحداً تعرف وكم حديثاً خضته معه عن الإيمان؟!
نفى صاحبنا أي أهمية لما قلت، وتحول الحوار إلى جدل عقيم عندما أدخلني في مسألة أخرى أظنه ندم ندماً شديداً بعدما أدخلني فيها. إذ أراد أن يشرح لي بأسلوب متعالٍ، أن التوفيق بين العلم والدين هو امتداد لتراث فلسفي عظيم شهدته الحضارة الإسلامية، وبرز فيه فلاسفة كثيرون مثل ابن رشد والفارابي وابن سينا وغيرهم، فتركته حتى ينتهي من الحديث في كل ما أعرفه من دون مقاطعة، ثم أخذت منه العهد أن يستمع اليّ للآخر كما فعلت معه.
ومجمل ردي كان الآتي: مشكلة العلاقة بين العقل والنقل، أو الفلسفة والشريعة، أو النص والتأويل، هي إحدى المشكلات المهمة في الحضارة الإسلامية كما قال، أما الخلط بين العلم من جهة، والفلسفة والعقل والتأويل من جهة ثانية، فهذا خطأ منهجي كبير. فالعلم ليس فلسفة بل هو علم كما نسميه، وليس عقلاً بل تجربة، وليس تأويلاً بل تعبير واضح مباشر وصريح عن ظواهره. وإذا كانت العلاقة بين الدين والفلسفة وطيدة وذات قضايا ومشكلات ونظريات وحجج وبراهين، فهذا لأنهما طريقان لهدف واحد ولغاية واحدة. لذلك فإن فلاسفة المسلمين ومتكلميهم ناقشوا هذا الأمر وكتبوا حوله وتفلسفوا فيه. في المقابل مَن مِن علماء المسلمين تناول هذا الأمر؟ لا أحد! وهم كُثُر: الحسن بن الهيثم وابن النفيس والخوارزمي والزجّاج والقزويني وابن البيطار وابن حيّان والحموي وعباس بن فرناس وغيرهم بالمئات، وهم بطبيعة الحال أكثر من الفلاسفة، فلماذا لم يتناولوا هذا الأمر المهم في علومهم، وإذا كانت لهم بعض الآراء في هذا الأمر (وهذا يبقى من الفلسفة على أي حال) فلماذا لم تنتشر آراؤهم ويشتهروا بها كما اشتهر الكندي وابن رشد والفارابي والغزالي؟
مؤسف حقاً أن مثقفينا اليوم لا يفهمون العلم كما فهمه أسلافنا، ويخلطون عن تجهيل وإصرار بين ما هو عقلي وما هو تجريبي وما هو إيماني غيبي. ومؤسف أيضاً أن بعض البسطاء من رجال الدين يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فبدل أن يقولوا بأن العلم حق لأنه ثمرة العقول التي كرمنا الله بها، ينحرفون للقول بأن الدين حق لأنه يتفق مع هذه العلوم.
يقول ألبرت إنشتاين: “ليس من العسير أن نتفق على المعنى المقصود بكلمة “علم” “Science”، فالعلم هو السعي عبر القرون من طريق التفكير المنظم نحو تجميع كل الظواهر الممكن إدراكها حسياً في هذا العالم من ارتباط شامل بقدر الإمكان”. إذن فهو طريق طويل وليس حقيقة تنزل واحدة ومكتملة كما هو الإيمان، وهو جهد إنساني يصيب ويخطئ وليس حكماً ربانياً لا يأتيه الباطل من أمامه أو خلفه، وهو معني بالظاهر والظواهر، ولا يتعلق بالجوهر والماورائيات وما خلف الظواهر، وهو مدرك حسي وليس مقولات إيمانية اعتقادية، وهو مختص بهذا العالم فلا يمكن مقارنته بكتب العالم السماوي وأحكامها.
لقد طالب الفيلسوف الشهير باسكال بأنه يجب على المشتغلين بالعلم أن يضعوا إيمانهم وعقيدتهم جانباً قبل أن يدخلوا باب المختبر العلمي. لم يكن باسكال ملحداً ولا زنديقاً بل هو من الفلاسفة المؤمنين وصاحب الرهان الإيماني الشهير الذي يعرف باسمه (رهان باسكال)، والذي فيه يؤكد ضرورة الإيمان بالله. وصية باسكال هذه بأن نفصل بين إيماننا بالله وبين علومنا المادية هي تأكيد لعدم إفساد الأمرين، لنضمن بذلك أن نفسر الظاهرة العلمية كما هي وبأسباب حدوثها وشروطها الطبيعية والمحسوسة، وفي المقابل أن يكون إيماننا بالله إيماناً مطلقاً راسخاً ثابتاً دائماً وكلياً. وليس في العلم شيء من هذه الصفات الأربع!
إن الدفاع عن الدين بالعلم تهديد للعقيدة، والاحتجاج بصحة الإيمان من طريق صحة القانون العلمي هو الفهم الخاطئ والتجديف بعينه في حق الإيمان وحق الله سبحانه، فالله لا يحتاج لألف دليل علمي على وجوده، بل يكفي لذلك الثقة التي عُقدت عليها قلوب عجائز نيسابور، لأن الإيمان بالله هو الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها. وبعد الإيمان بالله نصدق كتبه وشرائعه وأحكامه لأنها صادرة عنه سبحانه.
وليس في هذا القول تقليل من قيمة ما بذله الفلاسفة وقدموه ودافعوا عنه من أدلة عقلية وبراهين منطقية للتدليل على وجود الحق، بل كان ذلك عملاً عظيماً منهم وجزءاً أصيلاً في بناء مذاهبهم الفلسفية ومنظوماتهم الفكرية، وقد خصصوا هذه المعارف لطلابهم وفي كتبهم، ولم ينشروها بين أصدقائهم ومعارفهم وجيرانهم كما يفعل مدعو الثقافة اليوم.
يجب أن نجعل عقولنا محوراً لتصرفاتنا، فالعقل نورٌ يهدي صاحبه إلى الطريق الصحيح، ولكن يجب علينا بشكلٍ دائمٍ أن نقوم بصقله وتنميته، عبر التفكّر والتأمّل والحوار والنقاش، وهو ما يسمى بـ: “تنمية العقل النقدي”، أي أن يتحوّل العقل إلى “جهاز رقابة وفحص”، فيتحرى المعلومات بدقة كبيرة ضمن معايير ثابتة، فإذا وجد في المنشورات والفيديوات أفكاراً سطحية تستخف بوعينا وفيها بصمات خداع أو تضليل يجب إبعادها عن دائرة تفكيرنا، فالعاقل لا يصدّق كلّ ما يُقال أو يُنشر، لأنه يمتلك المعيار والميزان.
ولذلك لا بد من تدقيق المعلومة حتى نتحرى فيها الصدق وفقاً لمجموعة من المعايير البسيطة، وأهمها:
– ابحث عن مصدر المعلومة.
– اقرأ بتمعّن ولا تكتفِ بالعناوين.
– دقّق لمعرفة الكاتب أو الناشر وفتش عن مصداقيتهما وأمانتهما العلمية.
– تحقّق من التاريخ.
– لا تهمل قناعاتك السابقة، ولا تكن أسيراً لها أيضاً.
– اسأل خبيراً.
لقد ابتليت البشرية اليوم بمشكلة السطحيّة والتعامل مع القشور بلاء لم نعهده من قبل، وقلة هم من يتعاملون مع القضايا والأفكار المطروحة محلياً أو عالمياً بالتحليل والنقد وإبداء الآراء والحلول، قلة فقط من لديهم الشجاعة للدخول في قلب الحقيقة وصناعة الحدث.
نقلاً عن “النهار” العربي