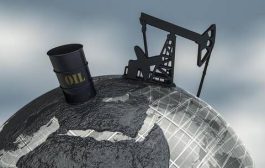غسان عبدالخالق
كاتب أردني
كل من قيّض له الاطلاع على رواية (1984) لجورج أورويل، أدرك سبب تصدّرها القائمة الخاصة بأفضل مئة رواية منذ عقود طويلة؛ فهي ليست الرواية الأقوى على صعيد الخيال العلمي السياسي فقط، وليست الرواية الأفضل على صعيد تفكيك وتشريح النظم السياسية الشمولية أيضاً، ولكنها الرواية الأعجب على صعيد التنبؤ بكل ما حدث ويحدث على صعيد الصراع السياسي العالمي بوجه عام، وعلى صعيد تطوير استراتيجيات ووسائل تطويع الجماهير وإخضاعها بوجه خاص.
وإذا كان التساؤل عن الكيفية التي تمكّن أورويل وفقها من صياغة وتأثيث (1984) بما لا يُعد ولا يحصى من التفاصيل الدقيقة والشخصيات المعقّدة والنادرة، يمثل الجامع المشترك بين كل من كتبوا عن هذه الرواية الساحرة والمرعبة في آنٍ واحد، فإنّ من حق القرّاء الأعزّاء أن يحاطوا علماً بأنّ الرواية تحكي قصة السيد وينستون سميث الذي يُعدّ من أعضاء الحزب الذي يحكم أقدونيا التي تمثل واحدة من ثلاث إمبراطوريات تسيطر على شعوب ومقدّرات الكرة الأرضية.
وهو ككل مواطني الإمبراطورية التي قامت على أنقاض النظام الرأسمالي الغربي (أمريكا وبريطانيا بوجه خاص)، يعمل ويأكل ويشرب وينام على مرأى ومسمع من شاشات المراقبة وميكروفونات التنصّت التي ترصد كل كبيرة وصغيرة وتحلّلها، للتأكد من مدى انصياع الشخص المراقب لتعليمات الحزب المكتوبة وغير المكتوبة، بما في ذلك ملامح وجهه ومشاعره وأفكاره الداخلية؛ فالحب والحماسة والحزن والكراهية غير مسموح بها، إلا لإظهار الولاء للزعيم الأوحد الذي تملأ صوره كل الميادين موشّحة بعبارة واحدة هي: (الأخ الكبير يراقبك)!
ورغم أنّ وينستون سميث – بحكم عمله في وزارة الحقيقة- يعرف كيف يعمل النظام على تطويع الجماهير، إلا أنه في أواخر العقد الرابع من عمره يجد نفسه مدفوعاً لمعرفة (لماذا يعمل النظام على هذا النحو)؟ وفي خضم محاولاته للإجابة عن هذا السؤال؟ يتعرف إلى زميلته جوليا التي تشاطره كثيراً من أسباب التمرّد المبطّن على النظام، وتخوض معه تجربة عاطفية تنتهي بإلقاء القبض عليهما متلبّسين بجرم الحب، على يدي الشخصين الوحيدين اللذين وثقا بهما، ثم يتبين لهما ولنا لاحقاً أنهما ليسا أكثر من ضابطين كبيرين في الحزب الحاكم. وقد تعمّدا تهيئة كل الظروف المناسبة لهذين العاشقين المتمرّدين، كي يبلغا أقصى الحدود الممكنة في علاقتهما بوصفهما حالة دراسية استثنائية. وعلى مدى صفحات وصفحات من وصف وتحليل آليات تحطيم الإرادة والجسد التي تعرض لها العاشقان المخدوعان، نقف على ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، من ضروب التحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والنفسي والحضاري، الذي يتجاوز حدود الهجاء المباشر للنظام الشيوعي البائد في الاتحاد السوفيتي، ويمتد ليطال كل سلطة على وجه البسيطة. وبغض النظر عن توجهاتها الأيديولوجية.
إنّ الميزة الأساسية لرواية (1984) لا تتمثل في كونها مصاغة بأسلوب فاتن وأخّاذ ومؤثر، رغم مضمونها السياسي الأمني القائم فقط، ولا تتمثل في كونها متماسكة ومقنعة جداً أيضاً، بل تتمثل كذلك في كونها نجحت في التنبؤ بكل أو بمعظم ما أقدمت عليه النظم السياسية الشمولية بعد عام صدورها أي بعد عام 1984، وخاصة في الاتحاد السوفيتي وألمانيا الشرقية، وكثير من أقطار دول العالم الثالث، إلى درجة الاعتقاد بأنّ هذه النظم لم تفعل أكثر من تطبيق ما جاء في هذه الرواية على مواطنيها، كلياً أو جزئياً.
وإذا كان أورويل قد تفرّد بتسليط الأضواء على أساليب النظم الشمولية، بخصوص تجهيل الجماهير بدعوى تثقيفها والدفاع عن قيمها ومبادئها الأخلاقية العليا، فإنّ ما أترع الرواية به من ضروب التفكير المزدوج (إمكانية تصديق حدوث الشيء ونقيضه في آن)؛ يدفعنا فور الانتهاء من ملحمته الفكرية هذه، إلى التساؤل فعلاً وليس مجازاً، عن الكيفية التي تمكن وفقها من حشد ورصد وتحليل كل هذه التفاصيل التي يصعب تصديق أنها من ابتكار عقل واحد، وخاصة إذا نظرنا بعين الاعتبار الشديد إلى حقيقة أنّ مجرى حياة أورويل لا يدعو للثقة والاطمئنان أبدًا؛ فقد انضم إلى صفوف الجيش الامبراطوري الاستعماري ثم تمرّد عليه، وانضم إلى الشيوعيين ثم انشق عنهم، والتحق باليسار الديمقراطي ثم أدانه، وانخرط في الإعلام الإذاعي وهجره، وقد دفع حياته ثمناً لهذا التقلّب الذي يسري في دمه، حينما أصرّ على أن يسكن في أحياء المعدمين تعبيراً عن احتجاجه على انتهازية الطبقة الوسطى، فأُصيب بالسلّ الذي ظل ينهش صدره حتى قضى عليه، وهو لم يكد يبلغ الخمسين.
وإذا كان الإنجاز الأكبر لأي رواية بعد الانتهاء من قراءَتها، هو شروع القارئ في إبداع روايته الخاصة، فإنّ الرواية الأكثر إقناعاً على صعيد الإجابة عن تساؤلنا العتيد، تتمثل في أنّ فريقاً مكوناً من الخبراء المتخصصين في التاريخ والسياسية والاقتصاد والإعلام والأمن وعلم النفس والأدب والفن، قد زوّد أورويل بكل هذه التفاصيل التي عمل هو على صبها في قالب روائي وأسلوب أدبي، سرعان ما آتى أكله على الجانب الآخر سخرية وتشكيكاً؛ إذ مما لا شك فيه أنّ (1984) بوصفها شكلاً من أشكال البروبوغاندا السياسية المضادة، قد أحدثت – طوال أربعة عقود من الحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالي والمعسكر الاشتراكي- تصدعات في الجبهة الفكرية والنفسية الخاصة بالمعسكر الثاني، تجاوزت من حيث الخطورة أثر أي سلاح عسكري، بما في ذلك أثر القنبلة الذرية. وأياً كان حظ هذا التصوّر من الحقيقة، فإنّ (1984) ستظل مختبراً فكرياً ونفسياً وسياسياً وأدبياً نابضاً بالدروس وعلامات الاستفهام، التي لن تزول إلا بزوال نظم الحكم الشمولية التي لن تزول قريباً أو في المدى المنظور!
نقلاً عن حفريات