كأننا في محاكم التفتيش يوم “الاحتفال” الرسمي بجنازة معارض
كتب : إبراهيم العريس
بشكل ما بدا المشهد منتمياً إلى محاكم التفتيش القروسطية أكثر من انتمائه إلى النصف الثاني من القرن العشرين. وكان في الأصل مشهد جنازة، وبالأحرى محاولة متعرجة لدفن ميت. لكن الميت لم يكن شخصاً بسيطاً ولا كان المكان عادياً، المكان كان براغ عاصمة تشيكوسلوفاكيا التي كانت تمردت قبل سنوات على المنظومة الشيوعية فاحتلتها قوات وارصو خانقة أنفاسها. وأما الميت فكان واحداً من كبار فلاسفة أواسط القرن العشرين، يان باتوشكا. ولكن قبل الحديث عنه لا بد من أن نتخيل الظروف التي أحاطت بدفنه. ويعفينا تلميذ له من هذه المهمة حيث يصف المشهد على الشكل التالي:
“مات يان باتوشكا يوم الثالث عشر من مارس (آذار)1977، فجابهتنا صعوبات عدة في محاولاتنا مع أجهزة الشرطة التي لم تكن تريد لعملية دفنه أن تكون ذات سمة استعراضية. وهكذا، لئن كان قد مات صبيحة الأحد، فإن السلطة لم تصرح لنا بدفنه قبل صبيحة يوم الأربعاء التالي، شريطة أن يكون ذلك في مقبرة صغيرة نائية في براغ. وفي تلك الأيام حدثت أشياء في غاية الغرابة لا تصدق، منها أن السلطات منعت بيع الزهور في طول المدينة وعرضها، بحيث أن ذاك الذي كان يريد شراء زهور لجنازة باتوشكا كان عليه أن يبتعد نحو أربعين كيلو متراً عن المدينة قبل أن يجد زهوراً. إضافة إلى هذا كان هناك، خلال الجنازة، رجال شرطة بالثياب المدنية يصورون الحاضرين عن قرب. لكننا، رغم تفرس رجال الشرطة فينا بشكل استفزازي آلينا على أنفسنا ألا نستجيب أبداً لاستفزازاتهم. ومن ناحية أخرى كان هناك حول المقبرة، رجال شرطة آخرون يمتطون الدراجات النارية يدورون بها محدثين ضجة لا تطاق، محاولين أن يغطوا على صوت القسيس الذي كان يتلو الصلاة فوق قبر باتوشكا. وفي الوقت نفسه كانت طائرات مروحية تتجول فوق رؤوسنا، تصورنا وتراقبنا وتمعن في إحداث الضجيج…”. قد يكون في هذا الوصف بعض المغالاة. لكنها (على أي حال) الشهادة التي أراد الشاعر التشيكي يان فاديسلاس، تلميذ يان باتوشكا، ومترجم بودلير، أن يقدمها حول اليوم الذي دفن فيه أستاذه باتوشكا. والغريب في الأمر أن الرجل الذي أثار دفنه كل تلك الاحتياطات من قبل السلطة، لم يكن سوى فيلسوف، أي رجل فكر، تتسم كتاباته بالصعوبة، وأفكاره بالتعقد. فيلسوف لم يكن ليحلم هو نفسه قبل ذلك بسنوات أن يكون لموته كل ذلك الضجيج، ولدفنه كل ذلك الصخب.
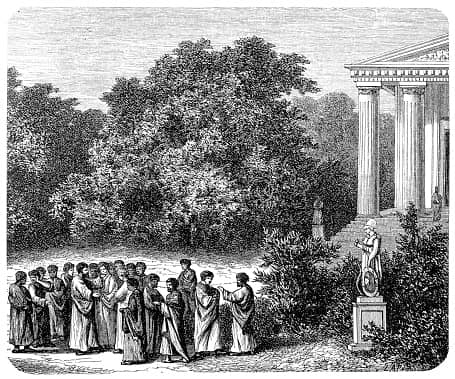
السلطات ضد التأمل
فهو بعد كل شيء، كان فيلسوف تأمل، وكان هادئاً لا يحبذ العنف ولا المغالاة، على رغم توقيعه مثل كثر على بيان انطلاقة ربيع براغ. كان باتوشكا واحداً من المفكرين الذين صنعوا ذلك الربيع، لذلك شاء تلامذته في المقام الأول، وسكان براغ الغاضبون في المقام الأعم، أن يحولوا جنازته نفسها إلى مناسبة تعلن غضبهم. وهكذا كان.
غير أن المهم هنا هو في مكان آخر. في الفكر الذي أراد باتوشكا نشره وحالت السلطات دون ذلك. فكانت النتيجة مشابهة بعض الشيء لما حدث للإيرانية آذر نفيسي وروته لنا في كتابها الرائع “قراءة لوليتا في طهران”. فباتوشكا وخلال السنوات الأخيرة من حياته، إذ منعته السلطات من النشر والتعليم الجامعي وإلقاء المحاضرات، راح يجتمع بشكل دوري في بيوت الأصدقاء حيث يحاضر ويناقش ويفكر ويساجل. ولقد نتج عن تلك الجولات كتابه الأشهر اليوم “أفلاطون وأوروبا” الذي كان حصيلة ما دُوّن من تلك المحاورات، وبداية استعادة الفكرة الأوروبية في براغ، على حساب الفكرة الستالينية.
بالنسبة إلى كثر يعد كتاب “أفلاطون وأوروبا” أهم كتب باتوشكا، بل الكتاب الذي حمله جوهر فكره ووصيته الفلسفية، إن لم نقل السياسية. فهذا الكتاب المعتبر نوعاً من “عمل قيد الإنجاز” إذ تابع فيه المفكر إيصال أفكاره وقد طورها جلسة بعد جلسة على ضوء نقاشاته، التي تكاد تكون سقراطية في نهاية الأمر، مع رفاقه من المفكرين الغاضبين على أوضاع بلادهم، يتناول بشكل أساس تاريخ الفلسفة في الفكر الغربي، معتبراً أن العناية بالروح هي المبدأ الأساس في هذا الفكر ومن منطلق أخلاقي بالتحديد. وهو لكي يطور فكرته استند أساساً إلى ثلاثة من الفلاسفة الإغريق، أفلاطون وديمقريطس وأرسطو، وقد وجد فكرة العناية بالروح مشتركة بينهم، فقد “انطلق الثلاثة من التساؤل حول الكيفية التي يجب بها أن يُجعل العالم عالم حقيقة وعدالة”.
الأهمية القصوى للروح
انطلاقاً من هنا، اشتغل باتوشكا على ثنايا كتابات الفلاسفة الثلاثة ليجد أن ما كان يهمهم أكثر من أي شيء آخر كان الروح، التي تقف دائماً في نقطة المركز من تلك الكتابات مبرهناً بعد كل شيء كيف أن تلك الفكرة كانت وظلت على الدوام “الإرث الروحي الحقيقي لأوروبا” أي منذ حلت في حياة الإنسان مكان الأسطورة لتخلق ذلك الحس الجماعي الذي لا يزال يسم “أوروبا الحقيقية حتى الآن”.
ولد باتوشكا في1907 لأب كان مدرساً للفلسفة الكلاسيكية، وتلقى دراسته الجامعية في براغ وباريس وفرايبورغ وبرلين، وتعرف باكراً على هايدغر كما على هاسرل وتأثر بهما. ولقد فتحت له أطروحته للدكتوراه المعنونة بـ”العالم الطبيعي كمعضلة فلسفية” (1936) أبواب جامعة شارل في براغ، حيث صار أستاذاً للفلسفة وداوم العمل هناك على رغم انقطاعات عديدة حدثت في مساره التعليمي، أولاً بسبب الغزو النازي (1939) ثم بسبب استتباب السلطة الشيوعية في البلد (1948)، وأخيراً من جراء التطهيرات التي تلت ربيع براغ (1968). ومع هذا كله تمكن يان باتوشكا من أن ينشر خلال حياته أكثر من 130 دراسة هامة حول “الظواهرية” والفلسفة اليونانية والفلسفات الألمانية والتشيكية والفرنسية. ولقد اعتنى عناية خاصة بفلسفة التاريخ (على خطى هيغل)، وبمصير الحضارات القومية والعالمية (على خطى نيتشه الذي كان يعتبره أستاذه الأكبر)، والبنيوية (التي كان من أوائل الذين أدخلوها في الحياة الجامعية التشيكية)، ومشكلات علم الجمال (حيث كان هنا أيضاً متأثراً بهيغل وإن حاول أن يوجد مزيجاً يضم هذا الأخير إلى كانط، كما تجلت أفكاره الجمالية في “نقد ملكة الحكم” بخاصة). والملفت هنا أن معظم دراسات يان باتوشكا، على رغم براءتها العلمية، قد نشرت في مجلات أجنبية، بخاصة في عديد من المجلات التي كان يصدرها المنفيون التشيكيون في الخارج. ويعود هذا بالطبع إلى أن المفاهيم الفلسفية التي كان يستخدمها ويدافع عنها كانت لا تتلاءم مع ما كانت السلطات هناك تعتبره الفلسفة الرسمية (“الماركسية وقد شوهت من قبل الستالينية، فلم تعد لها علاقة حقيقية بماركس”، كما كان يحلو ليان باتوشكا أن يقول بين الحين والآخر، حتى من دون أن يتنطح للدفاع عن ماركس).
المجابهة المبكرة مع السلطة
أما كتاب باتوشكا الأساسي “أرسطو، أسلافه وورثته” فإنه صدر في براغ وحقق نجاحاً كبيراً، خلال فترة طغى عليها نوع من نزع الجليد الستاليني. وفي المقابل فإن كتابه الأخير والهام “دراسات هرطوقية حول فلسفة التاريخ” (1975) الذي أتى على شكل توليفة تختصر آراءه الأصلية حول مراحل التاريخ الكوني، لم يطبع وينشر إلا بشكل سري أثار عداء السلطات له. مهما يكن، فإن عداء السلطات ليان باتوشكا بدأ باكراً، أي قبل “تورطه” في العمل السياسي، بفعل الصدام بين أفكاره وأفكار الفلسفة الرسمية، لكن العداء اتخذ بعده الأخطر حين انطلق يان باتوشكا من نضاله إلى جانب الطلاب في ربيع براغ، ليواصل تحركه دفاعاً عما كان في ذلك الحين يسمى “حقوق الإنسان” حيث نراه بين أوائل الموقعين على “ميثاق 77” الشهير. وكان ذلك آخر عمل نضالي يقوم به، ولقد “كافأته” السلطات عليه يومها عبر “الاحتفال” الكبير الذي خصته به يوم موته، ثم يوم دفنه، وكانت صورته على النحو الذي بدأنا به كلامنا أعلاه.
نقلا” عن أندبندنت عربية






















