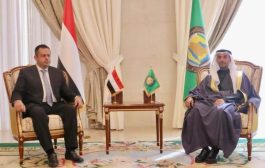كتب : سعد القرش
هذا مقال شائك، محفوف بالمكاره، لا يسعى إلى المناورة، ولا يتوسل بالمراوغة، ولا يدّعي الحياد وإن التزم أقصى درجات الموضوعية. ولسلامة الخروج، ستكون الكلمات أقرب إلى كاميرا تستعرض تفاصيل موجودة بالفعل. ولا تطمح الكاميرا إلى أكثر من استعراض المشاهد إلى ما وراءها، وهذا الماوراء يحتمل ربط أسباب بنتائج وتأويلات متنوعة، ولكني لا أنشغل الآن بأكثر من التصوير؛ تفاديا لاستفزاز كائنات عارية الأعصاب، مسلحة بأدوات الهجوم والتكفير.
أحاول اتقاء شرور وُعول تقتات أعشابا تعزّ في صحراء الاستبداد، وتجد في أي جدل فرصة للجهاد في المعركة الخطأ. ولا يتقصى المقال أسبابا جعلت الحجاب فريضة غائبة، وأحيانا الركن السادس من أركان الإسلام.
ليست الكتابة الآن في قضية الحجاب ترفا، ولهذا الحجاب علاقة وثيقة بالأمان الاجتماعي، وهناك جرائم تُرتكب تقربا إلى الله؛ بعقاب غير المحجبة، وفي المترو تم جزّ شعر زميلة. ويسهل التعميم بأن أكثر من 90 في المئة من المصريات يتعرضن للتحرش، والنسبة الضئيلة الباقية لا يعصمها من التحرش حجاب أو نقاب. يتسامح المصريون مع تاركي الصلاة والزكاة وآكلي أموال اليتامى، ويدعون لهم بالهداية، ويطبّعون مع الفاسد والمرتشي والفهلوي واللص، ولا يكفّرونهم، ولكنهم يؤمنون بأن غير المحجبة ستعلّق من شعرها في النار، واستباقا لهذا المصير فهي مستباحة، تتعرض للنهش والمضايقة والتعنيف الذي يبلغ حدّا يعاقب عليه القانون، في أي بلد يحكمه القانون.
ومنذ منتصف سبعينات القرن الماضي صعد الحجاب، بدرجاته المتنوعة، من الزي المحتشم إلى ستر الجسد دون الوجه والكفين، وصولا إلى النقاب والنقاب المشدد الذي يخفي العينين، ويُبطل تطبيقَ فضيلة غضّ البصر. وكان مصطلح الحجاب، حتى ثورة 1919، يعني النقاب. وقد استهدف قاسم أمين، بدعوته إلى “السفور” والتخلي عن الحجاب، طبقة اجتماعية عليا مستلبة، تتشبه بتقاليد تركية تلتزم فيها النساء بستر الوجه، للتمييز الطبقي عن طبقات أدنى تمنع نساءها من التشبه بالهوانم. وبعيدا عن الدائرة العليا الضيقة، كانت المصريات في مكان آخر، ولا يخجلن من وجوههن، ولا تشغلهن دعوة السفور؛ لأنهن سافرات، “شقائق الرجال” حقا، يقتسمن الأعباء في الحقول والمصانع الصغيرة.
في الصور القديمة يقف قراء القرآن بجوار زوجاتهم وبناتهم غير محجبات، ولم يترصدهم الناس بالانتقاد والتكفير. وإحدى الصور الدالة لمدير جامعة الأزهر الشيخ أحمد حسن الباقوري وزير الأوقاف وابنته التي قالت إنه لم يلزم بناته الثلاث بغطاء الرأس، ولم يكلمهن عنه. وكان المشايخ، حتى بدايات سبعينات القرن الماضي، يقومون بالتدريس في المعاهد الأزهرية لطالبات مكشوفات الرؤوس. هذا هو حديث صور وثقت ذلك الزمن، ولعله من آثار الشيخ الإمام محمد عبده الذي كتب في نهاية القرن التاسع عشر “لو أن في الشريعة الإسلامية نصوصا تقضي بالحجاب… لوجب عليّ اجتناب البحث فيه.. لأن الأوامر الإلهية يجب الإذعان لها دون بحث ولا مناقشة”.
90 في المئة من المصريات يتعرضن للتحرش، والنسبة الضئيلة الباقية لا يعصمها من التحرش حجاب أو نقاب
ويضيف في الأعمال الكاملة التي حققها محمد عمارة أن النقاب عادة نتجت “من مخالطة بعض الأمم فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التي تمكنت من الناس باسم الدين والدين منها براء». وتساءل «كيف يمكن لامرأة محجوبة أن تتخذ صناعة أو تجارة لتعيش منها إن كانت فقيرة؟”. وينفي أن تكون لحجاب المرأة أو سفورها علاقة بالأدب “وعلى أي قاعدة بني الفرق بين الرجل والمرأة؟ أليس الأدب في الحقيقة واحدا بالنسبة للرجال والنساء؟ وموضوعه الأعمال والمقاصد لا الأشكال والملابس؟ وأما خوف الفتنة فهو أمر يتعلق بقلوب الخائفين من الرجال وليس على النساء تقدير، ولا هن مطالبات بمعرفته”.
ولا يجتمع النقاب وغضّ البصر، يقول الشيخ “عجبا! لم يؤمر الرجال بالتبرقع وستر وجوههم عن النساء إذ خافوا الفتنة عليهن؟ هل اعتبرت عزيمة الرجل أضعف من عزيمة المرأة، واعتبر الرجل أعجز من المرأة عن ضبط نفسه والحكم على هواه؟ واعتبرت المرأة أقوى منه في كل ذلك، حتى أبيح للرجال أن يكشفوا وجوههم لأعين النساء مهما كان لهم من الحسن والجمال… إن زعم زاعم صحة هذا الاعتبار رأينا هذا اعترافا منه بأن المرأة أكمل استعدادا من الرجل”. ويخفي النقاب شخصية المرأة “فلا تخاف أن يعرفها قريب أو بعيد… فهي تأتي كل ما تشتهيه من ذلك تحت حماية ذلك البرقع وهذا النقاب”.
ويجد البعض من المتحرشين مسوّغا يريح الضمير، باستباحة “العاصيات”، ولكن استمراء السوك المَرضي وانتفاء الردع القانوني مدّا الأذى إلى المحجبات والمنقبات، فلا يسلمن منه. القضية عنوانها الحرية الشخصية، وهي لا تقل أهمية عن التحرر السابق من الاستعمار واللاحق من الاستبداد، وكانت ثورة 25 يناير 2011 عنوانا لهذه الحرية، ولم يشهد زحام ميدان التحرير حالة تحرش واحدة حتى السادسة من مساء 11 فبراير 2011، حين أعلن عن خلع حسني مبارك. الوعي بالحرية أدى إلى احترام حرية الاختلاف، ثم أوصلنا صعود قوى الثورة المضادة إلى انتكاسة مرعبة، لا تضمن معها امرأة قررت خلع الحجاب عواقب هذا السلوك. وكنت أظن هذا خاصا بمصر.
وتبين لي غياب فقه الأولويات عن المسلمين في العالم الإسلامي وخارجه. وتكفي ردود أفعال الخائفين على هذه الفريضة الغائبة، ممن لا تنفر عروق رقابهم بالغضب، لنهب المال العام والعدوان على الطرق ونهر النيل. هؤلاء شغلهم قبل سنوات خلع الممثلة عبير صبري للحجاب، وأعلن محام مهووس بالشهرة في فضائيات تحترف الإلهاء عن مقاضاتها بتهمة الإساءة إلى الدين. وهؤلاء يشغلهم حاليا خلع المغنية الفرنسية سورية الأصل منال ابتسام لغطاء شعرها، ومن تعليقاتهم وفتاواهم “الحجاب زيّ الصلاة، والصلاة عماد الدين يبقى الحجاب عماد الدين»، «إذا لم تؤمني بأن الحجاب فرض من الله، فأنصحك بمراجعة عقيدتك»، «الحجاب فرض بالقرآن والسنة والإجماع وإنكار فرضيته كفر”.
بين الحجاب والأمان الاجتماعي علاقة وثيقة
أحب المصريون نجيب الريحاني واستيفان روستي، ولم يسألوا عن دين الأول أو جنسية الثاني، ولم تكن ليلى مراد استثناء، وظلت الأعلى أجرا في زمانها؛ لإقبال الجمهور على أفلامها. وفي عام 1946 اختارت التحول من اليهودية إلى الإسلام، حين فاجأت زوجها أنور وجدي بسؤال: لماذا لم يطلب إليها أن تُسلم حين أراد أن يتزوجها؟ فأوضح أن اعتناق الدين مسألة شخصية جدا، “وكل واحد حرّ في دينه”، فأبدت رغبتها في اعتناق الإسلام. ولم يترتب على اختيارها لدينها الجديد أي تغير في سلوكها أو علاقاتها الأسرية أو عملها. ولم يؤثر إسلامها في زيادة شعبيتها، بل لم يجذب انتباه أحد، ولم تهتم به الصحافة.
السطور السابقة رصد موضوعي لا ينقصه الانحياز. ولن أحرم نفسي من تعليق يخص الرهان على المستقبل في حسم القضايا الخلافية. أؤمن بأن التاريخ دائم الحركة في تفكيك الألغام، وكسح المستعصي منها على التفكيك، وإرشاد البشر إلى المتفق عليه من الأخلاق، وقد اختفت العبودية، وانتهت تجارة الرقيق واقتسام سبايا الحروب. وفي تركيا حرّمت المطبعة، وفي مصر حرّم تسجيل القرآن في أسطوانات، وارتبك الفقهاء في إباحة الوضوء من ماء الصنبور لولا شجاعة مفتي “الحنفية”، وأوذيت الطبيبة نوال السعداوي لدعوتها إلى تجريم ختان الإناث، ثم انتصر الزمن والعلم للأخلاق، فصدرت فتاوى تنهى عن الختان. والآن تثار قضية زواج المسلمة من الكتابيّ، معركة للمستقبل.