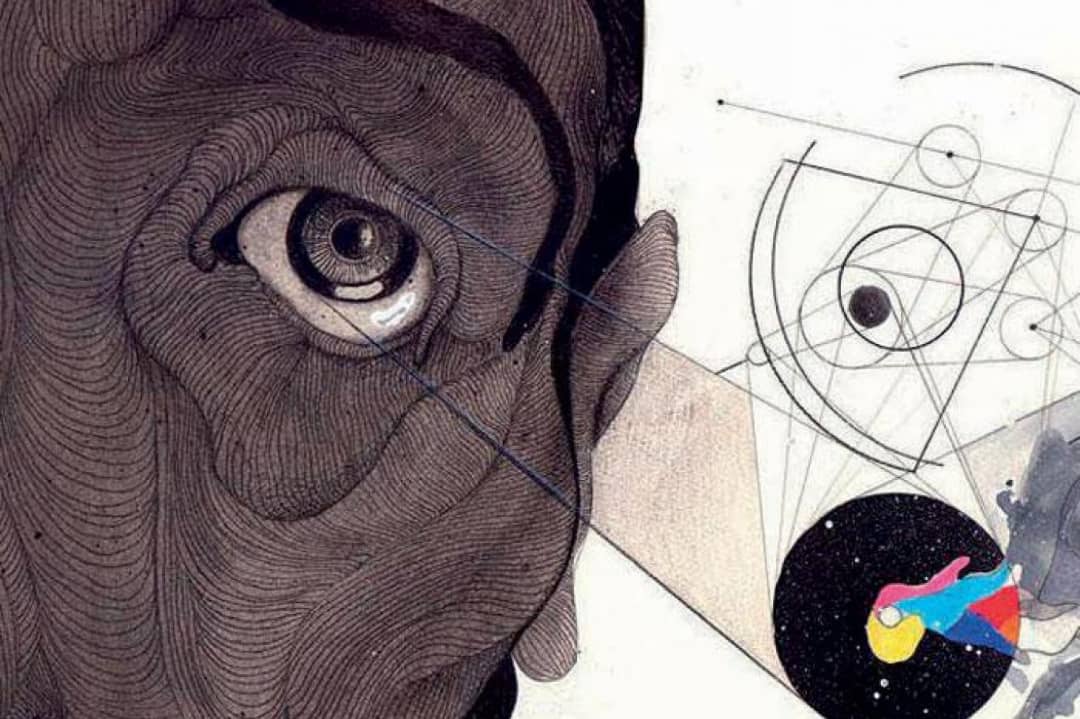سارتر الشيوعي والماوي انتقد بقسوة انحرافات الستالينية وهايدغر خلط بين الهوية الجرمانية والنازية
مشير باسيل عون مفكر لبناني
كان الفيلسوف الألماني- الأميركي ليو شتروس (1899-1973) يصر على التمييز بين العلوم السياسية والفلسفة السياسية، وفي اعتقاده أن علم السياسة يعنى بالنظر في طبيعة النظام السياسي والتشريع السياسي في المدينة الإنسانية، في حين أن الفلسفة السياسية تنظر في مسألة الحقيقة وتجلياتها في صميم الفعل السياسي. لا ريب في أن الحقلين متقاربان، إذ إن السياسة تجمعهما في رباطٍ وثيق. بيد أن الفلسفة تحرص على الغوص في عمق المفاهيم التي تستند إليها العلوم السياسية. من المعروف في الزمن الحاضر أن معظم الكتابات الفلسفية تنطوي على أبعاد سياسية تتفاوت نسب اعتلانها في هذا الفكر أو ذاك. أما إذا أراد المرء أن يقرأ مصنفاً في الفكر السياسي اكتسب شهرة عالمية، لاسيما من جراء الإقبال الفلسفي عليه، فليس له إلا أن يتصفح كتاب نظرية العدالة الذي أنشأه الفيلسوف الأميركي الليبرالي جون رولز (1921-2002).
يساعدنا مثل هذا التمييز بين العلوم السياسية والفلسفة السياسية على التفكير السليم في مقام الفيلسوف ووظيفته ودوره ودعوته في نطاق المدينة الإنسانية، خصوصاً في حقل الالتزام السياسي. قد يقبل المرء أن ينخرط أستاذ العلوم السياسية في صميم الواقع السياسي الشائك المعقد، وأن يستثمر كل أدوات المعرفة وآليات التحليل التي يكتسبها من حقل اختصاصه حتى يفوز بإدراك أفضل لملابسات الالتزام السياسي الذي يسوغه نظريا ويؤيده وجوديا. غير أن الفيلسوف لا يجوز له على الإطلاق أن ينغمس في معترك الفعل السياسي اليومي، فيحازب ويناصر ويبايع ويشايع. قد يستغرب الناس حدة هذا الموقف. غير أن الفلسفة لا تطيق التسويات والمساومات والملاينات، فالحقيقة الإنسانية العليا التي ينشدها الفيلسوف إنما هي شديدة التطلب، تحث العقل على اجتناب الوقوع في شراك المحازبة المهلكة. وعلاوة على ذلك، فإن حقل الالتزام السياسي لا يمكن فصله عن التصورات الأيديولوجية التي تسكنه، وعن إعجازية أو موهبية (charisme) القيادة السياسية التي تطبع العمل السياسي بطابعها الشخصاني الملزم.
إخفاقات الفلاسفة سياسياً
يعلم الجميع في هذا السياق أن تاريخ الفلسفة والفلاسفة حافل بجميع أنواع الالتزامات السياسية المتعثرة، المخفقة، المعيبة. من الأمثلة الساطعة طموح أفلاطون السياسي في جزيرة صقلية حيث زين له الدهر أن حاكم سيراكوزا ديونيسيوس الأول (431-367 ق. م.) جدير بالتهذيب الأخلاقي، مستحق التنشئة المعرفية، قابل التوبة الفلسفية. فإذا به يتقرب منه، ويسدي إليه النصح والمشورة، عله ينهض نهوض الأبطال من أجل تجسيد مثال الفيلسوف الملك. غير أن الحاكم هذا سرعان ما طفق يتبرم بإرشادات أفلاطون ويضيق ذرعاً به، فإذا به يطرده من قصره طرد الإهانة والذل. لم يرتدع الحكيم الفيلسوف، بل عاود الكرة مستنجداً صداقة ابن عم الحاكم ديون (408-354 ق. م.)، وفي ظنه أنه يستطيع أن يصادق الطاغية السياسي. شهيرة خاتمة القصة، ومحزن مصير أفلاطون الذي بيع في سوق النخاسة، من بعد أن غدر به الحاكم الشاب، وخيب له آماله الفلسفية البريئة. في إثر الصدمة الوجودية هذه، أيقن أفلاطون أن الملك لا يستطيع أن يكون فيلسوفاً، وأن الفيلسوف أيضاً لا يمكنه أن يكون ملكاً في الحكم والسياسة.

من الأمثلة أيضاً التزام عظيم فلاسفة الألمان في القرن الـ 20 مارتن هايدغر (1889-1976)، وهو الذي لم يتورع عن الخلط بين عشقه الهوية الجرمانية وانضوائه إلى الحزب النازي. براءة هايدغر السياسية ومثاليته الفلسفية وجذريته الفكرية أفضت به إلى العمى السياسي، فامتنعت عليه حقائق الانحراف الذي كان يضمره الحزب النازي في مستهل نشأته. كان هايدغر يحلم بوسطية حضارية جرمانية تعتق الشعب الألماني العظيم من سطوة المعسكرين الأيديولوجيين الشيوعي والرأسمالي. في رأس اهتماماته الفكرية مصير أروبا الثقافي، وقد أوشك أن ينهكها التحلل الفكري والأخلاقي والسياسي الذي جرته عليها مقتضيات الدموقراطيا التي تجعل صوت الجاهلين في الأكثرية الناخبة يعلو على صوت الحكماء في المدينة الإنسانية. لم يلبث فيلسوف الكينونة أن انكفأ عن رئاسة جامعة فرايبورغ الألمانية وعن التزامه الحزبي النازي، وراح يتأمل في نصوص الفلاسفة الإغريق الأوائل الذين كانوا يبنون المدينة الإنسانية (polis) على حقيقة الكينونة، ويقلب النظر في قصائد الشعراء الألمان الذين كانوا ينحتون الهوية الجرمانية نحتاً أدبياً يستصفي فيها خصائص التفكر النبوغي في الجليل من حقائق الوجود الإنساني.
من الأمثلة أيضاً التزام عظيم فلاسفة الألمان في القرن الـ 20 مارتن هايدغر (1889-1976)، وهو الذي لم يتورع عن الخلط بين عشقه الهوية الجرمانية وانضوائه إلى الحزب النازي. براءة هايدغر السياسية ومثاليته الفلسفية وجذريته الفكرية أفضت به إلى العمى السياسي، فامتنعت عليه حقائق الانحراف الذي كان يضمره الحزب النازي في مستهل نشأته. كان هايدغر يحلم بوسطية حضارية جرمانية تعتق الشعب الألماني العظيم من سطوة المعسكرين الأيديولوجيين الشيوعي والرأسمالي. في رأس اهتماماته الفكرية مصير أروبا الثقافي، وقد أوشك أن ينهكها التحلل الفكري والأخلاقي والسياسي الذي جرته عليها مقتضيات الدموقراطيا التي تجعل صوت الجاهلين في الأكثرية الناخبة يعلو على صوت الحكماء في المدينة الإنسانية. لم يلبث فيلسوف الكينونة أن انكفأ عن رئاسة جامعة فرايبورغ الألمانية وعن التزامه الحزبي النازي، وراح يتأمل في نصوص الفلاسفة الإغريق الأوائل الذين كانوا يبنون المدينة الإنسانية (polis) على حقيقة الكينونة، ويقلب النظر في قصائد الشعراء الألمان الذين كانوا ينحتون الهوية الجرمانية نحتاً أدبياً يستصفي فيها خصائص التفكر النبوغي في الجليل من حقائق الوجود الإنساني.
من الأمثلة أيضاً الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر (1905-1980) الذي ظن يوماً أن اليسار الفكري تجسده الشيوعية أفضل تجسيد. في نهاية حرب الجزائر (1962)، انقسمت النخبة الفكرية الأوربية اليسارية بين المعسكرين السوفياتي والصيني المتصارعين، فمال سارتر إلى الماوية يستطلع فيها وعود العدالة الاشتراكية الحق. في كتاب “نقد العقل الجدلي” انتقد سارتر انتقاداً قاسياً انحرافات الشيوعية الستالينية، وأكب يستجلي الحدود التاريخية والأونطولوجية في الاشتراكية التي كانت تسحر آنذاك معظم المثقفين الفرنسيين. أما في المناظرة العلنية التي انعقدت بين سارتر والفيلسوف الفرنسي الماركسي البنيوي لوي ألتسر (1918-1990) في معهد الدراسات العليا (باريس) في العام 1960، فإن فيلسوف الوجودية ارتبك ارتباكاً بالغاً في الدفاع عن مذهبه. فأقعدته عن الجواب أسئلة المشاركين الذين كانوا يستفسرونه عن قدرة الفنومنولوجيا الوجودية على تفسير التاريخ، وتزويد الفعل الإنساني أدوات التغيير البنيوي الفعلي الناجز. في إثر تلك المناظرة، راح سارتر يجتهد في التوفيق بين الوجودية والماركسية. ولكنه ما لبث أن أدرك أن المثقف العضوي في المجتمعات الصناعية المتقدمة يتنازعه تصوران متعارضان. يملي عليه التصور الأول أن يتكلم باسم المثل العامة والقيم الجامعة والمبادئ الأساسية، في حين أن التصور الثاني يجبره على الانخراط في صراع المصالح الاجتماعية المحلية الضيقة. ومع أن ثورة الطلاب في أيار 1968 أظهرت أن مقولات الإرادة الذاتية الحرة التي أذاعتها كتابات سارتر ومحاضراته تستهوي المزاج الباريسي التغييري بمقدارٍ يفوق إغواءات الفلسفات البنيوية والماركسية، فإن أصوات الطلاب في قاعات جامعة السوربون كانت تصدح: “سارتر فنان في الفكر الأنيق، ولكنه ضعيف البصيرة، قصير الحجة في السياسة”.
الحكمة الفلسفية في حقل السياسة
ما العبرة التي يستخلصها الفيلسوف المعاصر من الأمثلة الحية هذه؟ الأمثولة الأولى أن الفيلسوف ينبغي له أن يدافع عن المبادئ الأساسية والقيم الإنسانية المطلقة والمثل الأخلاقية السامية، وفي طليعتها الحقيقة والخير والصلاح والحرية والمساواة والعدالة والسلام والازدهار الكياني الأشمل في كل إنسان وفي كل الإنسان. الأمثولة الثانية أن السياسة حقل ملغوم من الانعطابات والتسويات والمساومات والمناورات والملاءمات والمجاورات التقريبية التي تطوع المبادئ والقيم والمثل تطويعاً يوشك أن يفرغها من رفعتها وسموها وبهائها. ما من حزب، مهما علا شأنه، يستطيع أن يدعي تجسيد شرعة حقوق الإنسان في مبادئه وفي مسلكه. ما من تصور أيديولوجي، مهما عظمت جدارته، يجوز له أن يحتكر قيم الإنسانية الرفيعة.

الأمثولة الثالثة أن التطلب النقدي الناشط في الفكر الفلسفي لا يجوز له أن يخضع لأي هيئة تاريخية، أو مؤسسة حزبية، أو مرجعية سياسية، أو دينية أو حتى علمية، فالفلسفة تخضع حتى العلوم عينها لاستفساراتها الجذرية التي تعري كل بناء معرفي، وتستنطقه عن خلفياته المكتومة. إذا كانت الفلسفة، وقد استنارت بمكتسبات العلوم الوضعية، تجرؤ فتسائل هذه العلوم نفسها، والمعرفة العلمية على هذه المرتبة السامية من الصدقية والفعالية، فكيف بالأحرى لا تجرؤ على مساءلة الانتظامات التاريخية الهشة المنعطبة التي تنعقد في مجرى الزمان النسبي، ومنها على وجه التحديد التجمعات السياسية التي تدعي أنها تطلب خير الإنسان؟ الأمثولة الرابعة والأخيرة أن الفيلسوف، من جراء طبيعته الجذرية المتطلبة البريئة من ملابسات أنصاف الوقائع وأنصاف الحقائق، لا يمكنه أن يهنأ في حضن سلطة تاريخية تعمد إلى احتضانه وتدليعه من أجل تطويعه وترويضه وإخضاعه واستثمار هيبته الفكرية وسلطانه الأدبي المعنوي.
هذا في الجانب النظري المحض. أما في معترك الحياة السياسية التي تشهدها الأوطان والمجتمعات، فالفيلسوف ينبغي له أن يعتصم بكلمة الحق في كل أمر. فلا يجوز له أن يكون قاسي القلب، خشن الجانب، فظ الأخلاق، فيطوي عن المظلوم رقة وجدانه، ويقبض عن المضطهد جناح رحمته. الفيلسوف فيلسوف على قدر ما يناهض الظلم والجور والقهر والمذلة والمهانة. والفيلسوف فيلسوف على قدر ما يناصر العدل والإنصاف والمساواة والحرية والسلام والأخوة الكونية. دعوته الأصلية أن يؤازر كل مسعًى تاريخي يضطلع به الناس في سبيل إبطال الباطل وإحقاق الحق. حين يعاين الفيلسوف المظالم التي تنزل بالمجتمعات البائسة المظلومة المضطهدة، لاسيما في القارات الآسيوية والأفريقية والأميركية الجنوبية، لا بد لفؤاده من أن يتصدع ولعقله من أن يصاب بالإرباك الوجودي الأعظم. أقرب المآسي إلينا المظالم التي حلت وتحل بالوطن اللبناني، والويلات التي نزلت وتنزل بالوطن الفلسطيني. على امتداد العالم العربي، ثمة مجتمعات تئن أنيناً مؤلماً، وثمة إنسان مستضعف يهان ويذل ويعفر وجهه حتى أمسى مهيض الجناح، مباح الكرامة.
كيف للفيلسوف أن يلتزم قضية الإنسان المعذب من غير أن يرتطم بانحرافات الأيديولوجيات السياسية التي تدعي الدفاع عن كرامة الأوطان والنضال في سبيل عزة الشعوب ونصرة المظلومين؟ السبيل الوحيد الاعتصام بجرأة الحق على غير استرهاب ولا ممالأة. الفيلسوف لا يهتف للزعيم، مهما ضخم أمره، بل للمبادئ والمثل والقيم. الفيلسوف لا يناصر الحزب، مهما صفت مقاصده، بل للقضية والمشروع والتدبير الإصلاحي الأشمل. الفيلسوف لا يعترك في السياسة، بل يعاركها حتى يقوم اعوجاجها، على قدر المستطاع التاريخي، من على مشارف صدقيته الكيانية ونزاهته الأخلاقية. لا يحكم الفيلسوف بالسلطة المترجرجة، بل يحاكم ضمائر السياسيين بسلطان الحق الراسخ.
أندبندنت عربية