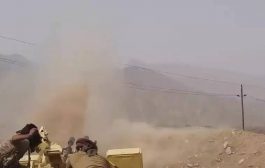حاتم النقاطي
يظل الحوار شرط سلمية كل اجتماع سياسي ومبدأ كل وعي عقلاني بالمعرفة إذ هو منهج بداية التفلسف، ذلك أن الفيلسوف اليوناني سقراط منذ القرن الخامس قبل الميلادي تبنى هذا التمشي الذي مهد لقيام الحداثة الغربية في مجال المعرفة والسياسة.
ذاك ما يتطلب من المثقفين قبل السياسيين البحث في جذور الأزمة، بردها إلى غياب الوعي العقلاني وبفهم حركة التاريخ بتفحص مسلماته المعرفية والسياسية لبناء عقل سياسي جديد ووعي مغاير. فأين نحن من خطاب الحداثة المعرفية كما فهمها الفيلسوف ديكارت في القرن السابع عشر؟ وهل من وعي بجوهر بناء الدولة كما صورته لنا الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر؟ وهل من تصالح بين المختلفين السياسيين في وطننا بتبنيهم لغة الحوار أي خطاب العقل بمعناه السقراطي كطريق أوحد لبناء الحاضر والمستقبل؟
لا مناص من تغيير الموضوعات ولا مناص من إعادة النظر في «أدلة الحساب والربط» فالعقل أضحى منذ القرن الديكارتي (السابع عشر) فضاء جديدا لمحاسبة الذات والعالم ذلك «أنه لا يمكن أن نطمئن أبدا إلى من يخدعنا ولو مرة واحدة» فعلاقة الذات بالعالم عند ديكارت هي علاقة ريبة من الأشياء وهي ريبة لا يمكن أن تقام على العقل باعتباره المراد والمنتظر، بل هي ريبة ستكون الحواس أساسها، وهو ما يصرح به ديكارت منذ التأمل الأول من كتابه التأملات “كل ما تلقيته حتى الآن على أنه أصدق الأمور وأوثقها قد اكتسبته بالحواس. غير أنني وجدت الحواس خداعة في بعض الأحيان”.
من هذا المنطلق يتبين لنا أولا أن الفضاء الديكارتي هو فضاء يتجاوز المعرفة الحسية وهي صورة عن المعرفة المباشرة. ثانيا مغادرة الفضاء الديكارتي للفضاء التراكمي للمعرفة الأرسطية والكنائسية والأفلاطونية كمعارف هيمنت على العصرين اليوناني والكلاسيكي. ثالثا استعداد ديكارت لبناء فضاء جديد قوامه «العقل»: وهو ما سيعلن عنه الموقف الديكارتي إبان تأسيسه للكوجيتو “أنا أشك ـ أنا أفكر ـ إذن أنا موجود”، فالكوجيتو عندئذ قائم على شك : أولا في المعارف السابقة: الأفلاطونية والأرسطية والكنائسية. ثانيا في أداة المعرفة وواسطتها أي الحواس.
◙ الشك عند ديكارت سوف يستند بالضرورة إلى المنهج “حتى لا يختلط باب الحداثة مع السابق”
ولعل هذا الشك لا يشابه الموقف الريبي في المعرفة، اعتبارا لطابع الاشتراك في المعرفة بين كل الناس «فالعقل أعدل قسمة بين الناس”، وهو ما يخالف التصور الريبي في إصراره على جانب الاختلاف بين الأفراد.
ولذلك فإن الشك عند ديكارت سوف يستند بالضرورة إلى المنهج «حتى لا يختلط باب الحداثة مع السابق”، وهو ما سعى ديكارت لتقديمه بكتاب «مقالة الطريقة» المشفوع بكتاب «التأملات».
وفي كتاب «مقالة الطريقة» يقدم لنا ديكارت منهجه «مكتفيا بالقواعد الأربع التالية:
الأولى: أن لا أتلقى على الإطلاق شيئا على أنه حق ما دام لم أتبين بالبداهة أنه كذلك، أي أن أعنى بتجنب التعجل والتشبث بالأحكام المسبقة، وألا أدخل في أحكامي إلا ما يتمثل لعقلي في وضوح وتميز لا يكون لدي معهما أي مجال لوضعه موضع شك.
والثانية: أن أقسم كل واحدة من المعضلات التي أبحثها إلى عدد من الأجزاء الممكنة والأزمة لحلها على أحسن وجه.
والثالثة: أن أرتب أفكاري، فأبدأ بأبسط الأمور وأيسرها معرفة. وأتدرج في الصعود شيئا فشيئا حتى أصل إلى معرفة أكثر الأمور تركيبا، بل أن أفترض ترتيبا بين الأمور التي لا يسبق بعضها بعضا بالطبع.
والأخيرة: أن أقوم في جميع الأحوال بإحصاءات كاملة ومراجعات عامة تجعلني على ثقة من أنني لم أغفل شيئا.
فالمنهج إذن هو عماد المبحث الديكارتي، فما هو «عقلاني» هو ما كان واضحا ومتميزا للذات، وما بدا «يقينا» للعقل هو ما اعتمد على «البداهة» والقدرة على التحليل والتركيب والمراجعة فلا حديث مع «الديكارتية» إلا عن الأشياء المعقولة ضمن محك الكوجيتو كإرادة للشك والبناء التمثلي المتيقن بالذات وبأشياء العالم.
من هذا المنطلق الواضح والمتميز تنطلق «الحداثة» في تأكيدها على التمثل العقلاني للعالم ضمن جدلية اليقين بالذات و«العالم» أو هي علوية الذات في اختزالها للموضوعات باعتبارها النتاج الحتمي للانقلاب الديكارتي، كانقلاب يسعى إلى تغيير الإنسان ووعيه بذاته وبالعالم وتشابك موضوعاته.
فقد جاء هذا «الانقلاب» مؤكدا على تخليص الإنسان من سلطة «المثال» ـ أفلاطون ـ ومن سلطة غائية الحركة كما هي عند أرسطو، ومن سيطرة «الكنيسة» على تعاليمه وماهيته في مراوحتها بين البعدين الأرسطي والمسيحي، فلكي ينهض الإنسان كان بحاجة لقوة جديدة، قوة تتجاوز «غائية السعي». هي قوة الكوجيتو في إرادته الواعية بالشك وبتعالي ذاته عن كل غائية .ذات لا سعي لها غير العالم في وجود جديد.
لقد أعلن التفكير الديكارتي وضمن “الكوجيتو” (أنا أشك أنا أفكر إذن إنا موجود) لـ «فلاسفة الأنوار» روسو فولتير مونتسكيو… القرن الثامن عشر عن قدرة العقل وحده على صناعة قوانينه، لذلك سعت «الحداثة» على تأكيده ضمن فهمها للإنسان في علاقته بالسلطة السياسية. لقد عوضت «الدولة» كجهاز حكم سياسي وكتصور معرفي جديد للإنسان أنظمة الحكم الملكية والإمبراطورية وكل السلطات الاستبدادية التي بنت حكمها على الأفراد باعتماد نظرية “الحق الإلهي”، والتي تجسدت في الفترة “الكنائسية” كمرحلة حكم تلت «المدينة» اليونانية التي عبر عنها جون جاك شوفالييه في كتابه «تاريخ الفكر السياسي» قائلا «لقد كان المفكرون اليونانيون يتصورون المدينة باعتبارها تجمعا أخلاقيا للعيش المشترك وفق قواعد الخير من أجل الخير، وكانت المدينة تسعى إلى هدف أخلاقي، وتبين طريق الوصول إليه”.
لقد استطاعت الدولة الحديثة منذ القرن الثامن عشر أن تطور مفهوم المدينة اليونانية وأن تعمق علاقته بالوجود السياسي وبفعل التعاقد لتضع الإنسان أمام تصور حديث لنظامه واجتماعه ومسيرته، فهو فرد يختار ما يتلاءم مع ذاته ويطابق حريته التي غادرت كل سلطات «الوهم» الغائي وأساسا سلطة الإلهي.
لقد استطاع روسو أحد فلاسفة عصر الأنوار من خلال فلسفة «العقد الاجتماعي» أن يصور لنا الإنسان الحر بأنه ذاك الذي يختار الحاكم ويخضع في الآن نفسه لسلطته من غير أن يفقد حريته، فـ «الإرادة العامة» مصدر القانون لا يمكن بحال أن تتناقض مع «معقولية» الإنسان، فهي كما عرفها روسو «المبدأ الأول للاقتصاد العام والقاعدة الأساسية للحكم». هذه الإرادة السياسية ما كان لها لتكون لولا الفضاء الذي فرضه الفضاء الديكارتي ـ قبل مئة عام ونيف من روسو ـ لاستئصال داء التواكل على الذات وداء الغاية التيولوجية كمصدر لكل حقيقة للإنسان والعالم.
ولعل «الحداثة» الغربية في انطلاقها فعلا وممارسة لا تعدو أن تكون غير سليلة لهذا التحول في الإنسان والعالم، لأن شرط الحديث عن «الحداثة» يكمن بالأساس في وجود «الاستنارة» وشرط الحديث عن «التراث» يكمن أيضا في الحديث عن «أداة الاستنارة» أي «العقل» كمنهج وكإرادة تسلط على ركام المعارف، فالموروث لا يعدو أن يكون غير المشكوك في جدارته إلى حد «الإثبات» وهذا الإثبات يشترط بالأساس «التفكير المعقول»، الذي يشترط «الإرادة» التي هي ذاتها فعل في الزمن، ولعل «الأمة العربية» في محاولتها لقيام حداثتها تشترط الوعي الجديد الفاعل في الزمن أي إعادة النظر في التاريخ، ذاك الذي ما كان غير عجلة تجري فلا تدركها وتفتش عن «المكاشفة» فلا تبصر غير «النقل» سمة أساسية لتاريخها.
◙ العقل أضحى منذ القرن الديكارتي (السابع عشر) فضاء جديدا لمحاسبة الذات والعالم
فهل بمقدور الأمة العربية أن تؤسس جدوى حضورها الفكري بين الأمم، وأن تقرأ ماضيها بغير العقل كمنطق أصلي للوجود وللموجود؟ أي هل بإمكان الأمة أن تؤسس فضاءات المعقول خارج الفهم الديكارتي للذات وللعالم ضمن مقولة “أنا أشك ـ أنا أفكر ـ إذن أنا موجود”؟
قطعا إن الأمر ما هو باليسير ولكن منطق تاريخية الإنسان أملى علينا ضرورة الخضوع لهذا المنهج باعتبار أن منطق «العقل العربي» هو منطق التسليم وحاضر «العقل العربي» هو حاضر المحاكاة من غير وعي، ومنتجات «العقل العربي» هي منتجات الاستهلاك.
وقد لا نرى عندئذ من ملاذ لنا غير إعادة هضم تاريخ «الآخر» لبداية انكشاف وعينا بذواتنا الذي لا يمكن بحال أن يستقل عن كل دروس «الآخر» في تعامله العقلاني مع ماضيه والاتجاه إلى الشك فيه باعتماد النظر المنهجي والإرادي لتغيير وضع الذات في علاقتها بذاتها والعالم. إن دروس «الاستنارة» الديكارتية واستتباعاتها السياسية والتقنية ضرورية لتأسيس حياة مدنية متطورة ودخولنا فضاء معرفة عقلانية نقدية في مجال فهمنا للماضي وللآخر بغاية بناء أمة العيش الإرادي في مجالات الدين والمجتمع والسياسة .
“الحوار منطق الاجتماع” ذاك هو الدرس الديكارتي ونداء لعقل المعرفة ومحاولة لاحقة من المفكرين السياسيين لبناء إنسان قادم يفكر في مدنية الدولة وفي الصالح العام. درس يتجاوز الغرب ليصل كل الأمم وكل الدول التي تؤمن بحداثة إنسانها وبرقيه ضمن تحديث العقل وتبني وضوح التمشي.
إن الحوار هو لغة العقل وهو سبيل أوحد للترقي فهو ممارسة واعية لنقد الذات للماضي ولتجاوز معيقات الحاضر وصولا إلى معقولية معرفية وسياسية تختار وجودها في دولة العدل والإنصاف. ولا نخال أمتنا بمتخلفة عن السعي نحو الإرادة المفكرة والبناءة لإعادة حضور مؤسسات الدولة وأسس ارتقاء إنسانها نحو نظام سياسي حديث يتصالح فيه الفرد مع الآخر ومع التاريخ. هو الحوار الذي شكل منذ القرن الخامس قبل الميلاد مع سقراط إعلان بداية التفلسف لبناء العقل والحرية.
نقلاً عن العرب اللندنية