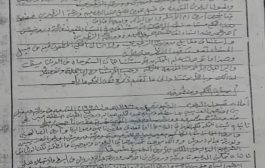محمد برهومة
كاتب أردني
يتضح يوماً بعد يوم أنّ التنوير الفاعل الذي يكبح التطرف هو التنوير الذي تقوده المجتمعات. إنه إستراتيجية طويلة المدى، وهو ما يفتقر إليه العرب والمسلمون، حتى الآن.
والواقع أنّ تنوير المجتمعات لا يشتغل إلاّ بشرطين يتعلقان في معالجة عائقي الثقافة والسياسة. فالحوكمة تنزِعُ الطاقة الاحتجاجية السالبة التي تنطوي عليها الأيديولوجيا الدينية.
وحكمُ القانون والمؤسسات واحترامُ الحريات، ينزعُ من الخطاب الديني مبرراته للتسييس والتعبئة وقدرته على الهدم. بمعنى آخر، إنّ التطرف الديني هو أن يكون للخطاب الديني المتشدد وللمعرفة الدينية المغلقة القدرة والسلطة على مصادرة حقوق الآخرين وحرياتهم، وامتلاك القدرة على الإضرار بالمخالفين وإيقاع الأذى بهم، أفراداً أو حكومات، وإذا فعل ذلك صار إرهاباً.
إنّ التنوير الأول/ الدولتي قد يُشخِصُّ الأزمة بإلقاء اللومِ على “ثقافة تُنتج تطرفاً وإرهاباً”. فيما التنوير الثاني/ تنوير المجتمعات، يَتَغيّا حضورَ التديّن، كمحفزٍ على الخيرية والرقي الروحي، من دون سلطة على المصادرة أو الاصطدام بالحرية وحقوق الإنسان. والثاني إذْ يشتغل على الثقافة والسياسة معاً، يحول دون أن يكون إلقاءُ الأولِ اللومَ على “الثقافة المتطرفة” باباً للتضييق على الحريات الفردية والعامة، وانتهاك القوانين، وتقوية السلطة بإضعاف المجتمع وكبح قدرته على التنوير.
إنّ التنوير الديني الذي تقوده المجتمعات، ينطلق وهو يدرك جملة من الحقائق الأساسية، منها: أنّ السلطة الغاشمة والحكومات المستبدة تؤبّد أكثر المضامين سلبية وسواداً في ثقافة أيّ مجتمع، ومن هنا أثرُ السياسة في الثقافة وانعكاس ذلك على أنماط التديّن. زد على ذلك أنّ الأخلاق والفضيلة إنّما تتأسسان على الحرية، وأنها شرط شارط لهما. كما أنّ الإصلاح الديني الفاعل يَدمِجُ مفهوم الإيمان والتديّن بالتنمية بمفهومها الشامل، ومنها التنمية الروحية التي تتناغم مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعززها. بمعنى أنّ أيّ إيمانٍ أو تديّن لا يرتقي بشروط الحياة ولا يزيد التفاعل الإيجابي مع العالم والعصر والآخر، ولا يزيد التضامن مع الإنسان ويحرره، سيكون مثلُه مثل الفقر والبطالة والفساد والآداب الرديئة التي تُعطّل دورة الاقتصاد وتُهمّش تطور الاجتماع وتشوّه الذائقة وتُهدر الموارد والطاقات.
ثقافة عامة يحميها القانون
لن تتبلور فكرة الحرية ونبذ الاستخفاف بكرامة الإنسان وعدم إهانته بسبب لونه ودينه إذا لم تتحول إلى ثقافة عامة يحميها القانون والمؤسسات، ولن تنتشر الفكرة وتترسخ إذا لم نتفق في خطبة الجمعة على قول ذلك بذكر كلام عمر بن الخطاب، رضي الله عنه “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً” ونورد القصة المشهورة حول ذلك. ثم يقول الفكرة الناقد الفني حين ينتقد غناء السيدة فيروز: “رُدّي منديلك رُدّي.. بيضا والشمس حدي.. بُكره بيجي محبوبك وبيلاقيك مِسوَدّه”؛ بالقول إن ذلك قد يكون مظنة نفَس عنصري أو تمييزي يسيء، بدون قصد، إلى أصحاب البشرة السوداء. كما لن تكتمل الجهود بشأن حماية تلك الفكرة إذا لم يعتقد الأكاديمي والباحث الجامعي أنّ من المهم، مثلاً، أن يثير نقاشاً مع طلبته يحلل فيه قول سارتر: “أكره الضحايا الذين يحترمون جلاديهم”! يعقبه (النقاش) توّلد قناعة عامة وفهم مشترك بقيمة الحرية وأهمية مقاومة الاستبداد والتخلص من دور الضحية.
مطواعية النصوص للتشدد
إننا نضعف مطواعية النصوص الدينية للتشدد وشرعنة العنف ضد المختلف حين نخرجها (النصوص) من دائرة الالتباس والاحتمالات المتناقضة. فـ”داعش” ومن شابهها يشتغلون على هذا “الالتباس الديني”، وهو نفسه من يقنع كثيرين، ممن رأوا تدمير “داعش” لآثار مدينة تدمر بين عامي 2015 و 2017 وعلى رأسها تدمير “التترابليون” وواجهة المسرح الروماني وتدمير قوس النصر (الذي يبلغ عمره 1800 عام) … يقنعهم بأنّ هذا قضاء على أصنام ينبغي أن يكون هذا مصيرها! وكأنما لم يمرّ مسلمون على هذه الديار منذ مئات السنين، ويتركوا تلك الآثار شاهدة على الإبداع الإنساني!
“الالتباس الديني” يتبدى ونحن نقرأ، مثالاً لا حصراً، كتاب “فقه الدماء” للمصري أبي عبدالله المهاجر، أستاذ أبي مصعب الزرقاوي، فنكتشف كمية النصوص الدينية الكبيرة الموظَفة في الكتاب لشرعنة العنف والدموية وجعلهما جهاداً وجسراً إلى الجنّة. كلُّ هذا يدفعنا لأن ندرك مدى حاجتنا إلى تنوير تقوده المجتمعات والنخب التي تحظى بثقتها؛ لمعالجة دائرة “الالتباس الديني” التي تتيح إلباس عنفنا وبطشنا غطاءً دينياً مقدساً. ويبقى السؤال: كيف لنا أن نقضي على هذه الثغرة وإلى الأبد؟ تلك هي المهمة لتنوير دائم يحفظ للمقدس منزلته عبر منع قابلية تدنيسه.
لهذا كلّه يقترح هذا المقال على تقارير التنمية البشرية والإنسانية، الإقليمية منها والدولية، أن تضع مؤشر التنمية الروحية في صُلب تقاريرها المقبلة، بعدما صار التطرف الديني مشكلة عالمية تتكلف المجتمعات والدول والمنظمات جرّاءها مليارات الدولارات سنوياً.
لقد أقام تنظيم “داعش” الإرهابي (المستند في حكمه إلى مقولات إسلامية وتقليد تراثي، لم يتعرض للنقد الجذري المطلوب أوالرفض الكامل) طيلة حكمه الغابر في العراق وسوريا، على زعم نشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة، وجعل في صُلب ذلك التقييد الصارم على النساء وعلى لباسهن وحركتهن وتصرفاتهن وحرمة معالجتهن من قبل أطباء رجال وسوى ذلك، وكذلك التضييق على هيئة الرجال وشكلهم ومحاسبتهم على أدق التفاصيل، مثل لبس الجينز وقص الشعر واستخدام الكريمات والتدخين، وسوى ذلك من أمور تُحيلنا إلى موضوع هذه المقالة التي تهجس بالحثّ على ضرورة أن تؤسس هذه التجربة المُرّة في العالم العربي لثقافة جديدة تُعيد تعريف الفضيلة، عبر الحسم الكامل بأنه لا فضيلة في ظل قمع حرية الإنسان وامتهان كرامته والنيل من حقوقه وذاتيته، ومن ذلك حرية جسده.
إنّ التحدي أمام إنتاج ثقافة دينية جديدة في مرحلة ما بعد القضاء العسكري على “داعش”
(واستمرار خطره الأمني والفكري) تكمن في أن تكون حرية الإنسان وكرامته والاعتراف بحقوقه وذاتيته في صلب أي إصلاح ديني. والمؤسف أنّ ما نراه حتى اللحظة هو وعي ديني مأزوم ومرتبك ومشوش ومتردد أمام خيارات الحداثة والعصر، ويحاول التعويض عن عدم اتساقه الذاتي أمامهما بالاتجاه إلى وعي ضِديّ أو تشدد ديني يُعنى بالشكل، وينهض على تشييء الإيمان، الأمر الذي يجعل الإيمان غير متصالح مع المعرفة، والتدين خالياً من الثقافة، وهي أصولية تنداح في خطّ العولمة والسوشال ميديا، وتستعين بتقنياتها وأدواتها في التوسع والانتشار والترويج لذاتها، وتكثير مناصريها الطامحين لمواجهة حداثة ليست من صنعهم وعالمٍ غريبٍ عليهم، لكنه يبقى يستهويهم ويجذبهم، وهذا مصدر الأزمة في وعيهم؛ أيْ مصدر تشددهم.
نقلاً عن حفريات