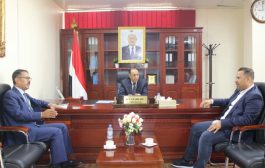حسن إسميك
“اقرأ”.. كان هذا أول أمر إلهي بلّغه جبريل للنبي محمد عليهما السلام، لما كان يعتكف للتأمل في غار حراء قريباً من مكة عام 610. أجاب عليه السلام: “ما أنا بقارئ”، كرر جبريل الأمر مرتين، وكانت الإجابة نفسها: “ما أنا بقارئ”!
ثم أتبع جبريل الأمر السماوي بأولى آيات القرآن الكريم: “(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿1﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿2﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿3﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿4﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿5﴾).
(ويعلمكم الله)
وهكذا بدأت رحلة الوحي الإسلامي من السماء إلى الأرض، حيث لا حديث عن التوحيد أو الصلاة أو الحج أو المحرمات، بل عن القراءة والمعرفة والكتابة، ومع الله كمعلم.
جعلني التأمل العميق لهذه الآيات منفتحًا على القراءة في معتقدات الديانتين الإبراهيميتين الأخريين، المسيحية واليهودية، بما في ذلك الدراسة المتعمقة لكتبهم المقدسة؛ التوراة والإنجيل وغيرهما. واعتقدت، خلافًا لآراء الآخرين، أن الوحي الأول: “إقرأ”، وكذلك الآيات اللاحقة التي تدعو إلى العلم والتفكير لا تتفق ولا يمكن أن تتفق مع تحريم قراءة الكتابين المقدسين المسيحي والعبري.
(وإنا له لحافظون)
يجادل البعض بناء على الآية الكريمة (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) [الحجر:9]، أنه لا يجوز قراءة ما سبق من الكتب السماوية على اعتبار أنها ليست محفوظة من التغيير. لكن تأويلي للآية يجعلني أرى أنها تعني أن مشيئة الله اقتضت أن يحفظ كتابه الذي أنزله على نبيه كما هو ودون تغيير، ولم يشأ الله أن يُحفظ ما قبله. وأيٍ يكن سبب ذلك فهو لغاية قدرها الله بعلمه، أما ما نعلمه منها فهو أن القرآن الكريم آخر الكتب السماوية، وأن محمداً عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء.
وسيجد كل مهتم ومتأمل أن ترتيب الكتب المقدسة الثلاثة وتطورها يرسمان معًا رحلة طويلة من الوحي الإلهي الذي واكب رحلة البشرية من الجهل بالخالق الواحد إلى معرفته، ومن إنكار وجوده إلى عبادته، ومن التعلق بحياة دنيوية مؤقتة وزائلة إلى ملكوت إلهي خالد.
خُلاصة القول أنه رغم إدراك الإنسان منذ آلاف السنين تفرده وتميزه عن غيره من مخلوقات الله الأخرى، إلا أنه لم يدرك الغرض الأعظم من وجوده (عبادة الله وخلافته على الأرض) إلا بعد أن كشف الله له هذا الغرض في كلماته وشرائعه من خلال أنبياءه.
جذر مشترك
انتشر في السنوات القليلة الماضية الحديث عن إنشاء “دين” جديد يسمى الدين الإبراهيمي، وقد اعتمد الدعاة لهذا “الدين” المبتدع على أوهام باطلة تدعي الاستناد إلى وحدة الأصل والنسب المشتركين بين المسيحية والإسلام واليهودية. لكنهم بدل أن يدعوا إلى التقريب وتعزيز الحوار بين هذه الأديان انحرفوا نحو المطالبة باستبدالها بدين واحد وشريعة واحدة، غير أنهم فشلوا في ذلك فشلاً ذريعا، وسيفشلون مستقبلاً كلما عادوا لمحاولتهم تلك، والسبب أن دعوتهم تفتقر إلى عنصرين أساسيين من العناصر المميزة للأديان السماوية، هما الكتاب والنبي، وهذا ما سيعجز دعاة بدعة “الدين” الإبراهيمي الجديد عن توفيره مهما تكررت محاولاتهم ومهما خططوا وتكلفوا في سبيل إنجاحها.
ولكن.. ورغم أن الدعوة إلى دين إبراهيمي واحد دعوة باطلة، تبقى عقيدة جدنا إبراهيم في عبادة إله واحد هي الخيط الذي يربط بين نسيج جميع الكتب المقدسة. فالتوحيد وبقية أركان الإيمان تتفرع من أصل إبراهيمي واحد مشترك: الإيمان بالأنبياء والكتب والملائكة وبيوم الحساب (اليوم الآخر)، وبالقدر (أي أن الله هو خالق كل شيء ومدبر كل أمر، وأن كل ما يجري في الكون إنما يجري بعلمه ومشيئته).
عقيدة واحدة وشرائع متعددة
جاء المسيح عليه السلام مصدقاً للشريعة التي سبقته، حين قال: لاَ تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لأَنْقُضَ النَّامُوسَ أَوِ الأَنْبِيَاءَ. مَا جِئْتُ لأَنْقُضَ بَلْ لأُكَمِّلَ (متّى5: 17)، وبمثل هذا أيضاً جاء النبي محمد عليه السلام، فقال: (الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عَلَّاتٍ، وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ).
ولقد وضعت نصب عيني في بداية دراسة الكتب المقدسة والبحث فيها، قول الله تعالى: (وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ) [هود:118] وقوله تعالى ﴿۞شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ ﴾ [الشورى: 13].
وعليه.. فيجب أن تستند دعوة التوحيد هذه إلى أساس متين من اعتراف كل دين تجاه الآخر بأن توحيدنا واحد على الرغم من تعدد شرائعنا. وحيث أن المؤمنين بالديانات الإبراهيمية يشكلون الأغلبية في العالم، فإن اتحادهم على كلمة سواء سيجعل عالمنا أفضل مما هو عليه. هذا يعني بالمقابل أن افتراقهم وتفشي العداوة بينهم سيزيد من مآسي هذا العالم ومشكلاته وصراعاته.
لماذا تعددت الشرائع؟
وهذا سؤال لا بد منه: إذا كانت كل هذه الأديان والكتب والأنبياء والمرسلين والأحكام والشرائع من مصدر واحد فما علة تعدد الشرائع وما الحكمة منه؟ هل هي مسألة مشيئة إلهية لا يمكن إدراكها؟ أم ثمة حاجة بشرية إليه؟
لا فرق في الأصل ولا في الاعتقاد بين ما يقره الإسلام وما تُعلِمُه اليهودية والمسيحية. وعلى الرغم من اختلاف الشرائع وتغير الأزمنة وتنوع الشعوب، تبقى الركائز الأساسية للإيمان مشتركة في العقائد الثلاث دون أي اختلاف أو تعارض بينها.
وللكتب المقدسة، من بين هذه الركائز، أثر بالغ الأهمية في توثيق عرى مبادئ العقيدة التوحيدية. أول هذه المبادئ عام وكلي بين جميع الأديان يتعلق بوحدانية الله وصفاته وخلقه للعالم والإنسان والتكليف بالخلافة وإرسال الانبياء وتأكيد مبدأ الحساب بشقيه (الثواب والعقاب).
والثاني هو الخاص في التشريعات والأحكام والعبادات، وهنا تكمن حاجة الإنسان لتعدد الكتب السماوية، فكان لكل كتاب، رغم ما فيه من مشترك مع الكتب الأخرى في موضوع التوحيد، هويته الخاصة المتجذرة في الفترة التي نزل فيها. واللافت للانتباه أنه عند جمع هذه الكتب المقدسة إلى بعضها بعضاً سيتضح كيف أنها ترسم مجتمعة ملامح تطور العقيدة التوحيدية في الوعي البشرى.
عقيدة الكتاب المقدس العبري وأحكامه
يحتوي أول كتاب مقدس على الأصلين العقيدي والتشريعي للتوحيد. (ثمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ) [الأنعام- 154[. ويدلنا البحث في التوراة على أنه إذا كانت أحكام العقيدة واحدة فإن أحكام التشريع (القوانين الدينية) ليست واحدة، وأحكام الطعام مثال على ذلك، حيث حرم يعقوب عليه السلام طعاما معينا على بني إسرائيل، وهذا يدل على أن بعض أحكام التشريع قد وضعها الأنبياء حفاظا على استمرارية الجماعة المؤمنة وتميزها عمّا سواها من غير المؤمنين. بينما لم يرد هذا التشديد في المحرمات والعقوبات في الكتب المقدسة اللاحقة.
النزوع الروحي في الإنجيل المسيحي
بعد فترة اشتد فيها الإيمان الحرفي بالشريعة اليهودية، جاء الإنجيل المسيحي ليكرس قيم المغفرة والرحمة، ويدعو المؤمنين إلى دخول ملكوت الله وحظيرة الإيمان بغض النظر عن الالتزام بالأوامر الدينية الصارمة السابقة. كما أكد الإنجيل على الخصائص الأخلاقية للإنسان، والحض على مفاهيم التسامح والرحمة، وإعطاء الحب قيمة كبرى ليس بين البشر فحسب، بل وبينهم وبين خالقهم أيضا. وهكذا مثلت المسيحية حركة إصلاحية انبثقت من قلب اليهودية وأكملت الجانب الروحي للمجتمع.
وعلى الرغم من أن اليهودية كانت خاصة ببني إسرائيل ونسلهم فقط، إلا أن هناك نقطة أساسية فارقة أكدتها العقيدة المسيحية: إطلاق دعوة الإيمان إلى جميع البشر. وهي النقطة التي عاد القرآن الكريم فأكدها معتبراً أن الإسلام الذي نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولكونه آخر النبيين، لا يخص قومه فحسب، بل للعالمين جميعهم.
القرآن الكريم جامعاً لما قبله
اتسمت تعاليم القرآن الكريم وأحكامه بسمة الكونية وبالخطاب العام لجميع البشر، ولأن القرآن نزل عربياً وعلى نبي عربي، فقد أدى هذا إلى تحقيق هدف بالغ الأهمية، وهو توحيد العرب مع كل الخليقة، ومن هنا جاءت دعوة الإسلام لتنتشر في شرق الأرض وغربها. ولأن الإسلام لم يخرج عن دين قبله كما خرجت المسيحية عن اليهودية، بل جاء جامعا لهما في تشريعاته وعقيدته. فبذلك يمكن القول أن القرآن والشريعة الإسلامية هما النتيجة الكاملة للكتابين المقدسين السابقين.
من منظور آخر بالغ الدلالة والأهمية، يعكس هذا التدرج في تعاقب الأديان الإبراهيمية الثلاثة الرحمة الإلهية التي تضمنت تكريم الإنسان وتشريفه بالتكليف الإلهي مع منحه حرية إرادته ومسؤوليته عن أعماله في آن معاً.
سلاح الهوية
عندما انقسم البشر إلى جماعات توزعت في مناطق مختلفة، وصار لكل جماعة سماتها ولغتها وثقافتها الخاصة، فقد أدى ذلك إلى أن تتجاوز كل مجموعة الهوية الإنسانية المشتركة سعياً لإنشاء هويتها الخاصة التي تميزها عن الآخرين من خلال مجموعة خصائص فرعية؛ عرقية أو لغوية أو جغرافية أو دينية.. إلخ. ليتطور الحال فيما بعد ويتم استخدام الهوية كسلاح لحماية الجماعة والحفاظ على استمراريتها، وغالبا ما استوجبت هذه الحماية تكريس حالة العداء تجاه الآخر المختلف عنها في هويتها الفرعية.
وفي الحقيقة لم يختلف أتباع الديانات السماوية عن غيرهم من هذا المنظور، أقصد استعداء الآخر على أساس الهوية الدينية، فالتاريخ ما زال شاهدا على الصراعات والحروب القائمة على الدين، وحتى بين الجماعات الفرعية داخل الدين نفسه. ولأن التشبث بالهوية والتعصب لها عادة ما ينشط في حالات الصراع والاستقطاب بين مجموعة وأخرى، فقد تسبب هذا الأمر بلجوء كل مجموعة إلى هويتها الخاصة وزيادة استعداء الآخرين، حتى وصل هذا الاستعداء لدرجة عالية من عدم الثقة في أي مبادرة للحوار، وإلى تكريس حالة العداء المفتوح، والرغبة في القضاء على وجود الآخر تماما!
هوية مشتركة
لكن.. ورغم ما سبق، يرى المتأمل في نقاط اتفاق الأديان السماوية أن تبني هوية مشتركة وشاملة هو الشيء الحقيقي والأكثر منطقية مقابل سعي أي دين لتمييز نفسه عن الأديان الأخرى. خاصة وأن المقارنة الشاملة بين الموضوعات والعناصر المشتركة المتفق عليها في الكتب المقدسة الثلاثة لا تقتصر فقط على ما يخص جوهر العقيدة التي يتشاركها المؤمنون بهذه الأديان فحسب، بل وفي التفاصيل الأخرى المتعددة بشكل عام: العبادة، والأحكام، والمعاملات، والأخلاق، والعادات، والتقاليد، إلخ.
ولا أقصد هنا أن يتنازل أتباع الكتب السماوية عن عقيدتهم لصالح دين مستحدث كما في بدعة إنشاء دين إبراهيمي موحد. بل اقترح أن يرفع المؤمنون بهذه العقائد “مظلة التقارب” التي تضمن الحماية من الداخل ومن الخارج، فلا تضعف عقائدهم أو تنقسم على ذاتها أو تتعدى على غيرها أو تصبح هدفا للاستعداء.
وأعلم أن البعض قد يعدّ رؤيتي هذه طُوبَاوِيَّةٌ في ضوء الصراعات الدينية العالمية اليوم، والتي باتت حدتها تتناسب طرداً مع عزوف أتباع كل دين عن الانفتاح على الآخر وقراءة الكتب المقدسة التي لديه. وفي هذا مكمن خطورة ألا نقرأ باسم الله الذي علم بالقلم. فهل الأديان السماوية هي سبب غياب هذا الانفتاح؟ أم ثمة أسباب أخرى من خارج الدين ذاته؟
بعيداً عن السياسة.. وقريباً منها!
أثناء البحث في الكتب السماوية، سلّحت نفسي بأداة منهجية صارمة كنت قد استفدتها من دراسة الفلسفة الحديثة، تسمى: تعليق الحكم. تقتضي هذه الأداة بأن أقوم، وقبل الدخول في البحث، بتعليق أية أحكام مسبقة كنت قد كونتها، أو اطلعت عليها في أعمال الآخرين، وخاصة تلك التي تتضمن فساد العقائد الأخرى أو ضلالها. والأكثر صعوبة من الناحية المنهجية، أنني ذهبت ابعد من ذلك، فالتزمت عدم إطلاق أية أحكام جديدة طوال فترة البحث.
آتت هذه المنهجية الصارمة أُكُلها دائماً، وبخاصة لما فتحت أمامي عالماً من المعتقدات والقيم والأحكام والقصص المشتركة التي تزخر بها الكتب المقدسة الثلاثة، كان أهمها الآتي:
• الله خالق كريم ورحيم وله وحده سبحانه القداسة المطلقة والمكانة الأعلى في الوجود.
• شرّف هذا الخالق الكريم البشر بالعبادة والتكليف وحرية الإرادة والقدرة على التعلم والمعرفة.
• أنعم عليهم بالرحمة والكرم في البر والبحر على الأرض، وبالروح الخالدة بعد الموت.
• وأنزل لهم الشرائع التي يهتدون بها للطريق القويم.
إذا كانت هذه العطايا الإلهية تمثل قاسمًا مشتركًا بين جميع المؤمنين دون استثناء، فلماذا كل هذا الانقسام بينهم؟
الجواب هو: السياسة.
إن اشتداد حالات التعصب الديني، أو اندلاع الحروب الدينية بأنواعها، أو استعار الصراع على الهويات الدينية، كلها مظاهر مقيتة تترافق عادة مع اشتداد الصراعات السياسية بين المجتمعات والدول، أو داخلها. ومن جهة ثانية زادت الأمر سوءاً، فقد أدرك السياسيون مبكراً أهمية ما يحظى به الإيمان من قدرة على تشكيل الرأي العام. ووجد هؤلاء السياسيون أنه إذا تضافر الشغف الديني مع الحماسة السياسية، فإن هذا الأمر سيمكنهم من ترسيخ سلطتهم واحتكارها وحماية مصالحهم.
لذلك، لا ينبغي أن يكون هناك مجال للدين في السياسة. نعم للإيمان ولكن لا لاستخدام الإيمان ومضامينه كأداة في يد السياسة. وفي مقاله “الانحلال الأخلاقي”، وهو مقال من 450 كلمة حول القضايا المجتمعية والدينية والتعليمية، يشير ألبرت آينشتاين إلى فكرة قريبة من ذلك حين يقول: “أنا مقتنع تمامًا بأن الإرادة الشغوفة بالعدالة والحقيقة قد عملت على تحسين حالة الإنسان أكثر من حساب الذكاء السياسي الذي لا يولد – على المدى الطويل- سوى عدم الثقة. من يمكنه الشك في أن موسى كان قائدًا للبشرية أفضل من مكيافيلي؟ ”
إذن.. ولكي يكون الدين راعياً صحياً للسياسة ومرشداً لأفعالها، يجب كخطوة أولى فصلهما كي يصبح من الممكن إعادة بناء العلاقة بينهما على النحو الأمثل. إذا تم الفصل بين الاثنين، يصبح الدين، بمنظوماته العقائدية والقيمية والتشريعية، مستقلاً بما يكفي للقضاء على تأثير السياسة الوحشي وقمعها الاستبدادي. عندها فقط سيكون الدين قادرًا على توجيه السياسة والتاثير فيها بقوة وشمولية كبيرتين، بالإضافة إلى حفظها والحيلولة بين الفعل السياسي وبين الأهداف الضيقة التي تغلب مصالح طرف على طرف.
إن خطر الانعزال هو الدرس الأخير المستفاد من دراسة فلسفة الحضارات والأديان الإبراهيمية.
خاصة وأن انعزال أي جماعة يولد التعصب الذي يؤدي إلى جمود الفكر وضيق الأفق.
على الجانب الآخر، يُعد الانفتاح وقبول الاختلافات وتعزيز التنوع أهم شروط تطور الحضارة، ولما كان الدين هو أحد أهم عناصر الرقي الحضاري عبر الألفيتين الماضيتين فإن استعادته الكاملة لهذا الدور مشروطة بالعناصر الواردة أعلاه.
وفي الحقيقة فهذه ليست دعوة طوباوية أو حلماً بعيد المنال، بل لقد تحققت سابقا مرات عديدة، كما شهدنا في كثير من المدن العربية والإسلامية في الماضي: بغداد ودمشق والقدس والقاهرة ومدن الأندلس.
أخيراً.. عندما تتحرر الأديان الإبراهيمية من السياسة، فإنها ستعود لنقائها الأصيل، وستصل بسهولة إلى هدفها الموحد: حُسن خلافة الله على الأرض أولاً، ومن ثم جعل عالمنا هذا عالماً أفضل ثانياً. وكما قال أينشتاين: “جميع الأديان والفنون والعلوم هي فروع من نفس الشجرة.”
نقلاً عن “النهار” العربي