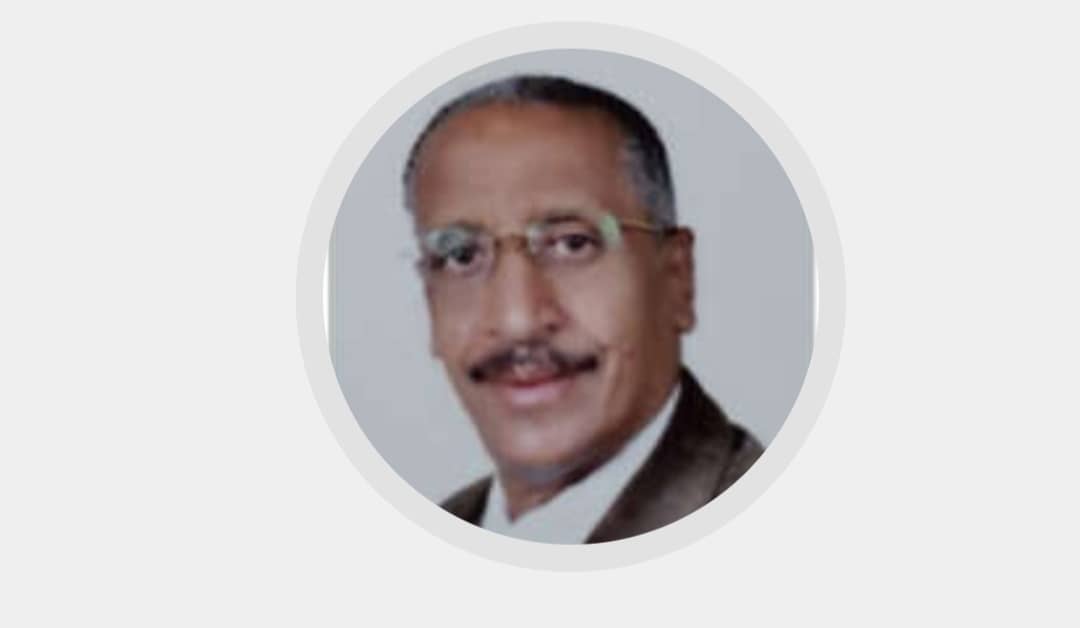قادري أحمد حيدر
الإهداء:
إلى روح الشهيد/ يحيى محمد المتوكل، في ذكراه العشرين، من أوقف اعتقالنا، بعد حرب 1994م مباشرة: أنا، والأصدقاء؛ الفقيد الشاعر/ إسماعيل الوريث، والأستاذ/ عبدالعزيز البغدادي، وهو ما تناهى إلى سمعي حينها من أكثر من مصدر، منها الصديق ، عبدالعزيز البغدادي، ولمزيد من حسن النية، وبغرض التعرف به عن قرب دعاني مع إسماعيل الوريث، الذي تربطه به صداقة حميمية، – كما هي مع البغدادي- إلى مأدبة غداء، حين كان وزيرًا للداخلية، وبعيد الحرب مباشرة، واعتبرتها في حينه شجاعة وموقفًا، وهو ما يكشف عمق معدنه السياسي والوطني، والأخلاقي، وأنا هنا لا أتفق مع من يقول أو يرى من خلال “نظرية المؤامرة”، أنّه كان من رموز وقيادة تنظيم “الهاشمية السياسية”، ومن أنّه كان “أمين المجلس السري للهاشمية”، ومن الداعين لعودتها، ومحتوى كتابه الحواريّ مع الأستاذ صادق ناشر، يقول غير ذلك، في كل تفاصيل حواره الذي اتسم في الغالب بالموضوعية، بل وبالنقد لبعض ما كان يراه صوابًا.
يكفي أنّ الصديق/ الشهيد، جار الله عمر -وغيره- كان يعدّه من أصدق الأصدقاء الخلص بالنسبة له، ويكيل المديح لوطنيته، ويمنيّته، ومشهد حزنه وبكائه على صديقه جار الله، وهو يوارى الثرى وفوق قبره شاهدٌ على ذلك، لروحه السلام والرحمة والخلود مع الصَّدَّيقين والصالحين.
مع ما يسمى اتفاقية جدّة للمصالحة، هل كنّا حقًّا أمام حالة سياسية واقعية لما يمكننا تسميتها مصالحة وطنية؟ وهل ما جرى فعلًا مصالحة وطنية، وفقًا لتسمية البعض لها؟ ثم ما هي الإضافة الوطنية التي قدّمها الاتفاق، أو المصالحة للحالة السياسية، والوطنية اليمنية في ذلك الحين؟ خاصة أنّ الاتفاق أو المصالحة جاء بعد انكسار الحصار، وانتصار المقاومة في السبعين يومًا، ولم يتبقَّ سوى بعض الجيوب الملكية الصغيرة مبعثرة في “صعدة”، ولا تدري ماذا تعمل، ولا إلى أين تذهب، بعد أن اختلف بيت حميد الدين فيما بينهم حول مستقبل الحرب وجدواها، ورأوا أن لا مستقبل للإمامة في اليمن المعاصر، ووجد الداعم السعودي بالمال والسلاح، أنّ استمرار الحرب صارت عبثية ومكلفة لهم، وبلا معنى. يجب الإقرار بَدءًا، بأنّ المصالحة الوطنية هي رؤية معرفية فلسفية، وهي ثقافة سياسية، وشكلٌ من أشكال الاعتراف بالآخر، وإقرارٌ بالتعدّد والتنوّع.
المصالحة الوطنية هي ثقافة سياسية حديثة لم يألفها العقل السياسي التقليدي (القبَلي العسكري الدينيّ/ الإسلاموي)؛ ذلك أنّ المصالحة الوطنية إنّما هي مفردة من مفردات ثقافة التسامح، وحين نقول التسامح الوطني، أو المصالحة الوطنية، إنما نعني بذلك أنّنا أمام حالة من ثقافة القَبول بالآخر، والاعتراف بحقّه في الحياة، وبحقه في الشراكة والمشاركة في اتخاذ القرار، وفي السلطة والثروة، وإذا ما أسقطنا مفهوم المصالحة الوطنية كحالة من حالات التسامح السياسي، على واقع وحقيقة ما جرى في العام 1970م مع السعودية، وكان من نتائجه عودة القوى الملكية، فإنّنا لا نرى فيما جرى مصالحة وطنية، ولا ما يعبر عن حالة من حالات التسامح الوطني تجاه الآخر، خاصة أنّ مقدّمات ما يسمى بالمصالحة الوطنية كانت عملية تصفيات دموية، وإقصاءات سياسية وعسكرية لقوى أصيلة في قلب القيادة الجمهورية، تم استبعادهم، وإقصاؤهم وسجنهم وتشريدهم؛ لأنّهم كانوا يحلمون أن يتم القَبول بهم شركاء في السلطة، بما يعني غياب الحدّ الأدنى من ثقافة التسامح والتصالح، ألم يكن الجمهوريون الشباب في قلب القيادة الجمهورية هم أحق بالمصالحة الوطنية والتسامح السياسي معهم، وعدم الاعتداء على حقّهم السياسي والوطني بالمشاركة، بدلًا من الذهاب إلى الملكيين، والسعودية.
إنّ أصدق وصف وتسمية لما جرى في جدة، إنّما هي تسوية سياسية انتقصت الحق السياسي والوطني لليمنيين، ومن السيادة الوطنية، تسوية ناقصة من موقع التابع، حدّدها، وفرض شروطها وبنودها، ومضمونها، الطرفُ السعودي، تسوية حرفت القضية الوطنية اليمنية عن مسارها، ووضعت اليمن الشمالي تحت الوصاية السعودية، منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.
فكرة التسوية مع السعودية بالطريقة التي تمت، هي فكرة كانت قائمة في عقل، وذهن، وحلم المجاميع المشيخية القبَلية، والإسلاموية، وبعض بقايا الأحرار اليمنيين، وبعض العسكريين الذين انحازوا لأسباب خاصة مع مشايخ القبائل، وهذه الأطياف السياسية والاجتماعية سعت جاهدة إلى تحميل مصر، وعبدالناصر، والقوى السياسية الاجتماعية الحديثة، مسؤولية الحرب واستمرارها، مع أنّ الحقائق والوثائق والاتفاقات، فضلًا عن الوقائع كلّها، تؤكّد أنّ الطرف السعودي والاستعماري البريطاني ومعهم الرجعية العربية هم من كانوا يقفون ضدّ إيقاف الحرب باشتراطهم التخلي عن النظام الجمهوري، ووضعه بين خياري الملكية، والدولة الإسلامية.
والحقيقة أنّ فكرة التسوية السياسية أو المصالحة كفكرة، إنّما بدأت مع مؤتمر “أركويت” في السودان عام 1964م، الذي رأس الوفد الجمهوري فيه الأستاذ محمد محمود الزبيري، وترأّس الوفد الملكي أحمد محمد الشامي، ومن برط دعا الزبيري كذلك لإيقاف الحرب، والسلام، والمصالحة، وهي مفردات لم تكن واضحة ومبلورة وناضجة في عقل الشاعر الزبيري، تغلبت فيها الرومانسية الوطنية الشعرية على الواقعية السياسية، وبعد اغتيال الزبيري 1/4/1965م، أخذ التيار “الجمهوري المشيخي القبلي الإسلاموي”، وبقايا الأحرار اليمنيين لواء الدعوة لوقف الحرب، “والسلام”، و”المصالحة”، دونما رؤية ولا برنامج سياسيّ، أو وضوح حول معنى ومفهوم المصالحة، والسلام، ومع تشكيل حكومة الأستاذ النعمان في أبريل 1965م، قدّم الأستاذ أحمد محمد النعمان برنامجه السياسي الذي دعا إلى تبنّي جملة من القضايا والأسس العامة، لمعنى بناء الدولة، والموازنة، داعيًا إلى المصالحة بين الأطراف المتحاربة (الجمهوريين، والملكيين) وإنجاز مشروع “السلام” في البلاد، مؤكّدًا على قضية بناء الدولة على أسّس المبادئ البرلمانية، في وضع لا علاقة له بالعمل البرلماني، ولا بالعمل المؤسسي، وبعدها مباشرة نهاية أبريل 1965م، تبنّى الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر الرمز السياسي لقيام دولة القبيلة، ووزير الداخلية، دعوة القبائل “الجمهورية” والملكية للمشاركة في لقاء أو مؤتمر وطني لتسوية القضية اليمنية، وكانت هذه الدعوات مقدمة سياسية لمؤتمر “خمر” الذي عقد في مايو 2/5/1965م، وأسّس عمليًّا وسياسيًّا لخطاب عمومي فضفاض مجرد عن المصالحة، محاولين استثمار اسم ودم الزبيري الشهيد في هذه المعركة السياسية الخاسرة، لقد كان “مؤتمر خمر” تعبيرًا سياسيًّا عن الإرادة المشيخية القبلية بامتياز، والدعوة للمصالحة، والسلام، وإيقاف الحرب، جاءت في حمى الهجوم الأيديولوجي والسياسي على مصر عبدالناصر تحت شعار “الذاتية اليمنية”، حيث دعا المؤتمر إلى إخراج القوات المصرية، ورفض دورها العسكري، ومساعداتها، وجاء مؤتمر الطائف 10/9/1965م، ليعلن المصالحة مع السعودية والملكيين، وقيام “الدولة الإسلامية اليمنية”، وهي الفكرة التي أخذ تبلورها أكثر من أربع سنوات، حتى اختمرت، وأنجز نصفها الثاني في جدة مارس 1970م.
إنّ مؤتمر “الطائف” وبنوده وقراراته التي حملت شعار “المصالحة”، وغطاء “السلام”، ووقف الحرب، والذي عُقد في مدينة الطائف السعودية في قلب الحرب السعودية والاستعمارية على الثورة والجمهورية، إنّما كان تقف خلفه القوى الإقطاعية، (المشيخة القبَلية، والجماعة الإسلاموية)، وبعض العسكريين المتذمّرين من السياسة المصرية في اليمن. مؤتمر الطائف الذي حمل شعار المصالحة والسلام، مثله مثل مؤتمر خمر، إنّما كان يهدف إلى تعزيز دور ومكانة السعودية في حل القضية اليمنية -كما يقولون- وفي هذا المؤتمر تم التنازل عن الخيار الجمهوري، أو وضع الخيار الجمهوري في موازاة ومقابل الخيار الملكي، باعتبارهم شعارَ “الدولة الإسلامية اليمنية” هو البديل المناسب لحالة اليمن. وفي شهر أكتوبر 1967م، ونتائج مؤتمر قمة الخرطوم التي رفضها السلال، وصفّ جمهوري واسع، وعلى إثر مظاهرة 3 أكتوبر 1967م، وتوتر الأوضاع الداخلية بين الأجنحة الجمهورية المختلفة- تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصالحة وطنية كاسم وشعار، وفي غفلة من الناس وبدون أية رؤية ولا مشروع سياسي حول ماذا نعني بالمصالحة السياسية والوطنية؟ وما هي المداخل العملية والسياسية لتنفيذها وتحقيقها؟ حيث أعلن الشيخ عبدالله الأحمر أنّ المصالحة ممكنة مع السعودية والرموز الملكية، وليس المصالحة داخل صف القيادة الجمهورية المصطرعة فيما بينها، والتي كانت بحاجة ماسة سياسيًّا ووطنيًّا إلى المصالحة الوطنية والانتقال بعدها للحديث عن المصالحة، أو التسوية السياسية مع الآخرين في الخارج، أعداء الجمهورية، والدولة اليمنية الحديثة، وعلى خلفية ذلك المنظور السياسي الأحادي للمصالحة عند بعض حاملي لوائها، فقد عقد في الحُديدة أول اجتماع لها على قاعدة ما سمي الحفاظ على النظام الجمهوري، وأهداف ومبادئ ثورة 26 سبتمبر، على أن ترفض وساطة اللجنة الثلاثية، ويحل اليمنيون مشاكلهم بأنفسهم عدا أسرة آل حميد الدين. وكانت هذه هي الخطوة السياسية الأخيرة قبيل إعلان قيام انقلاب 5 نوفمبر 1967م، الذي تبنّى بالكامل بعد ذلك، قضية “المصالحة” وعمل على إخراجها سياسيًّا على مراحل، ولكن على خلفية وقاعدة تصفية الجناح الثوري الجمهوري في قمة السلطة، والجيش والأمن، وأجهزة الدولة المختلفة، وإنهاء حالة التوازن الوطني في الجيش وفي السلطة والدولة، التي أشار إليها محقًّا الفقيد يحيى المتوكل، وجاءت أحداث 23/24 أغسطس 1968م، لتحسم حالة “ازدواجية السلطة” القائمة بين أجنحة وتيارات القيادة الجمهورية لصالح القوى التقليدية والمحافظة، وهو ما أشار إليه كذلك الأستاذ الفقيد يحيى المتوكل في حواره مع الأستاذ/ صادق ناشر، ومن حينها بدأت تتحول دعوات وشعارات “المصالحة” مع السعودية من خطاب، وقول سياسي، إلى خطوات عملية قيد الإعداد، والتنفيذ، وهو ما لم يكن في ظلّ قيام حالة التوازن الداخلي التي كانت قائمة إلى ما قبل أحداث 23/24 أغسطس 1968م.
إنّ فكرة التسوية مع السعودية بالطريقة التي تمت، هي فكرة كانت قائمة في عقل، وذهن، وحلم المجاميع المشيخية القبلية، والإسلاموية، وبعض بقايا الأحرار اليمنيين، وبعض العسكريين الذين انحازوا لأسباب خاصة مع مشايخ القبائل، وهذه الأطياف السياسية والاجتماعية سعت جاهدة إلى تحميل مصر وعبدالناصر والقوى السياسية الاجتماعية الحديثة، مسؤوليةَ الحرب واستمرارها، مع أنّ الحقائق والوثائق والاتفاقات، فضلًا عن الوقائع كلها، تؤكّد أنّ الطرف السعودي والاستعماري البريطاني ومعهم الرجعية العربية هم من كانوا يقفون ضدّ إيقاف الحرب باشتراطهم التخلي عن النظام الجمهوري، ووضعه بين خياري الملكية، والدولة الإسلامية، إلى جانب شرطهم حول عودة بيت آل حميد الدين، ورفض اتفاقية جدة بين عبدالناصر وفيصل عام 1965م، إلى جانب إفشالهم لمؤتمر “حرض”- خير دليل على ذلك. وبقيت فكرة المصالحة، أو التسوية كامنة وغير جاهزة للتطبيق، بسبب توسع وامتداد الحرب السعودية، والاستعمارية على ثورة 26 سبتمبر وامتدادها لتشمل أكثر من 40 جبهة عسكرية خلال 64، 65، 66م، وبقي الجناح السياسي القبلي التقليدي حامل لواء الجمهورية القَبَلية، والدولة الإسلامية اليمنية، “الكتلة الثالثة”، هو من يطرح فكرة “المصالحة”، و”السلام”، و”إيقاف الحرب” بين القوى المتحاربة، في محاولة للمساواة بين الجمهوريين، والملكيين، وبهدف وضع الشعار الجمهوري في مقابل وموازاة شعار الملكية والإمامة، ضمن شعارات وطروحات غير واضحة وغير محددة، تحوّلت معها شعارات ومفاهيم السلام، وإيقاف الحرب، والمصالحة، إلى مفاهيم وشعارات، سياسية ملتبسة، وغامضة، ومراوغة، وغير مفهومة، ويمكنني القول بكلِّ ثقة ومن خلال التجربة السياسية التاريخية إنّ القوى السياسية والاجتماعية التقليدية (المشيخية، والعسكرية، والدينية)، حاولت ممارسة الاستخدام الوظيفي السياسي لمفاهيم وشعارات “السلام”، و”المصالحة”، و”إيقاف الحرب” ضدّ الدور المصري المسلح في اليمن، وفي مواجهة التيار الثوري الجمهوري في قلب القيادة الجمهورية، مستخدمة أخطاء البيروقراطية العسكرية المصرية، والأداء السياسي المرتبك للقيادة اليمنية الجمهورية لصالح تمرير أهدافها وشعاراتها، قضية حقٍّ أريدَ بها ألفُ باطل.
إنّ المصالحة الوطنية، والتسامح الوطني، ليسا خطأ، ولا خطيئة، أو جريمة، وليسا عيبًا في حدّ ذاتهما، خاصة إذا ما كان هدفهما تنقية الأجواء الوطنية، وخلق مناخ سياسيّ وطنيّ صحيّ وسليم، يعزّز ويرسخ اللُّحمة الوطنية الداخلية. إنّ الدعوة للتسامح الوطني، والمصالحة الوطنية، ينبغي أن تكون مؤسسة على قضايا وأسّس ومفاهيم واضحة ومحددة، وفي سياق مشروع سياسي وطني كبير، وليس لخدمة مشاريع سياسية صغيرة تحت وطنية، ومعادية في جوهرها لقضية الدولة الحديثة، وهو ما كانه مشروع جمهورية نوفمبر عبر قاطرة ما يسمى “المصالحة” مع السعودية، ومن هنا رفضنا المبدئي والوطني لمشروع “المصالحة” عبر القاطرة السعودية، والذي وضع البلاد عمليًّا وسياسيًّا، تحت الوصاية السعودية باسم “المصالحة” حقًّا لقد تم اغتيال شعار ومفهوم المصالحة مرتين: الأولى، حين استخدم لتصفية المعارضين السياسيين الجمهوريين في قلب القيادة الجمهورية، بعد إفراغ مفهوم المصالحة من معناه، ومضمونه ودلالاته الفعلية، والثانية حين تحول مفهوم المصالحة إلى تبعية ووصاية، وفقدان للسيادة الوطنية، والقرار السياسي الوطني المستقل.
ومن ذلك اليوم، مارس ١٩٧٠م، دخلت البلاد في مرحلة التبعية الكاملة للسعودية، وما يحصل اليوم هو استمرار لما تم التأسيس له في ذلك التاريخ، أي إنّنا لا يمكننا أن نقرأ ما يحصل اليوم دون العودة لذلك التاريخ، وذلك الاتفاق المسمى زورًا بـ”المصالحة”.
•••
قادري أحمد حيدر
باحث وكاتب. مدير تحرير مجلة دراسات يمنية. له 13 مؤلفاً في قضايا الفكر والثقافة والسياسة.
نقلاً عن ( منصة خيوط)