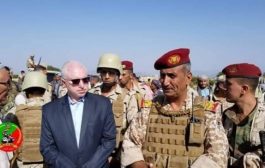جاد الكريم الجباعي
كاتب سوري
يذهب كثيرون إلى الاعتقاد بعدم وجود “سلطة دينية” أو إكليروس “كهنوت” في الإسلام، بوجه عام، ويميل آخرون إلى الاعتقاد بعدم وجود مثل هذه السلطة في الإسلام السني خاصة.
لكن بعضهم، يرى أنّ ثمة سلطة دينية في عالم الإسلام السني، لكنها “متناثرة بشدة؛ وأنّ “الإصلاح الديني” الإسلامي المحتمل مشروط بتوحيدها ومركزتها ومأسستها؛ (ما) يساعد مجتمعاتنا على التشكل والتوازن، ويسهل عملية الدمقرطة، وهو بعدُ “لحظة” في عملية علمنة لا نرى مجالاً للقفز فوقها”. ويرى، من ثم، “إن ضعف السلطة الدينية وتبعثرها، لا قوتها أو وحدتها، هو العقبة الكؤود دون عقلنة حياتنا الاجتماعية والسياسية والدينية وترتيب العلاقة بين الديني والسياسي في بلداننا على الفصل والاستقلال، أي دون العلمنة”[1].
*من غير الممكن أن يكون هناك استبداد من دون السيطرة على العقول والضمائر إذ كيف يكون استبداد والناس أحرار*
من المسلّم به أنّ ثمة سلطة مستمدة من الدين، في كل زمان ومكان؛ و”عالم الإسلام السني” ليس استثناء؛ لأن الدين مصدر من مصادر السلطة، بوجه عام، ومن مصادر السلطة السياسية، بوجه خاص، شأنه شأن الكتابة والمعرفة والثقافة والعلم والقوة والمال والملكية الخاصة …. إلخ. تمارس هذه السلطة مؤسسة راسخة نميل إلى تسميتها مؤسسة “الدين الوضعي”، التي ينضوي في إطارها “العلماء” والشيوخ والأئمة والفقهاء والمجتهدون والمفتون ووعاظ السلاطين و”المتمجدون” بمجد المستبدين، بتعبير عبد الرحمن الكواكبي، فضلاً عن مؤسسة الإفتاء ومؤسسة الأوقاف وغيرهما.
ومن الضروري، ما دمنا نسعى إلى تحرير فكرنا من قيود الأيديولوجيا و”الرأي العام” و”الحس السليم” و”الفهم المشترك”، أن نفحص مصطلح “السلطة الدينية”، الذي فرض نفسه علينا ردحاً طويلاً من الزمن، فنرده إلى السلطة المستمدة من الدين، بوصفه مصدراً من مصادر السلطة، لا سلطة في ذاته؛ وإلى سلطة المؤسسات الدينية، أو مؤسسات “الدين الوضعي”؛ السلطة، التي كانت ضرورية، على مر التاريخ، لتبرير كل ما يحتاج إلى تبرير وتقنيع كل ما يحتاج إلى قناع؛ فنميز الدين “السراطي”، بتعبير صادق العظم، من مؤسسة الدين الوضعي، بل من “الدين الوضعي”، التاريخي، فلا نحمل الدين السراطي أوزار المؤسسات الدينية وخطاياها، ونحرر، من ثم، مفهوم السلطة من أي حكم مسبق، ولا سيما تعيينها بالدين؛ فمن دون ذلك؛ أي من دون تحرير مفهوم السلطة من أي حكم مسبق ومن أي قيمة معيارية، لا نستطيع فهم السلطة وتعيين مصادرها وآليات تكونها وعوامل فعاليتها وآليات اشتغالها وأسباب كونها مستبدة وغاشمة أو عادلة ورشيدة، بدءاً من سلطة الأب على أولاده، بل على أسرته (رب الأسرة)، وصولاً إلى السلطة السياسية.
*الاستبداد هو حمى حامي الدين الوضعي والمؤسسة الدينية كذلك هي الحارس الأمين للاستبداد*
فإنّ سلطة المؤسسات الدينية، المستمدة من الدين، هي، في المقام الأول، سلطة على عقول المؤمنين وضمائرهم؛ ولذلك كانت حاجة المستبدين إليها، ولا تزال، حاجة ماسة لتأسيس مشروعيتهم. وليس بوسع أي بحث موضوعي أن يفصل سلطة المؤسسات الدينية عن الاستبداد، بوصفه بنية ونظاماً؛ لأنه من غير الممكن أن يكون هناك استبداد من دون السيطرة على العقول والضمائر؛ إذ كيف يكون استبداد والناس أحرار، والحرية هي، أولاً، حرية الفكر والضمير وحرية الرأي والتعبير؟!. الاستبداد هو حامي حمى “الدين الوضعي”، والمؤسسة الدينية هي الحارس الأمين للاستبداد؛ ولذلك، ربما، اتخذت المعارضة السياسية، في التاريخ العربي الإسلامي، حتى أواسط القرن التاسع عشر، طابع الانشقاق المذهبي، أو طابعاً مذهبياً، ولا يزال بعضها كذلك حتى يومنا. فعلى من يريد قيام “سلطة دينية موحدة وممركزة وقوية” تناهض الاستبداد المحدث، وتحد من “فرعنته” أن يفكر في انشقاق مذهبي جديد (عصري) في “عالم الإسلام السني”، وهذا ليس من قبيل الهرطقة والابتداع، فالوهابية، على سبيل المثال، حركة إصلاح ديني حديثة، اتسمت بنزعة تكفيرية.
*الله، عز وجل، لم يكن سبب شقاء الناس وبؤسهم وقهرهم ودوس كرامتهم بل الناطقون باسمه والحاكمون باسمه*
لكل من لا يرى رأيها ويأخذ بسنّتها، وأرادت نفسها مذهباً جديداً هو “الدين القويم”، وما يزال الناس يسمونها الحركة الوهابية والمذهب الوهابي؛ ولكنها لم تشأ، ولم تستطع، الاستقلال عن الاستبداد، وهي من أكثر المرجعيات السنية تماسكاً وصلابة ومركزية وسطوة، في بيئتها، وتسعى إلى منافسة المرجعيات الأخرى في غير مكان، وتبذل أموالاً طائلة في سبيل “الوعظ والإرشاد”.
ليس الدين ما أضفى طابع القدسية والعصمة على “العلماء” والفقهاء والمفتين، الذين شرَّعوا للاستبداد وللمستبدين؛ بل الاستبداد نفسه والمستبدون أنفسهم، واللافت أنّ المشرِّع كان أدنى منزلة من المشرَّع له؛ بل كان خادمه وتابعه وطوع بنانه. المؤمنون متساوون في الإيمان، الذي لا يقبل القياس.
والتفاضل بين الفقيه والمؤمن أو بين المفتي والمؤمن تفاضل في درجة العلم فحسب، لا في الإيمان والتقوى، والعلم يكتسب؛ ورب مؤمنين أعلم من الفقهاء والمفتين والمجتهدين والمراجع وأكثر استقامة.
لعلّ أساس ارتباك الخطاب العلماني وعجزه عن إعادة بناء العلاقة بين الدين والسياسة على مبدأ استقلال كل منهما في مجاله وميدانه، يكمن في استبطان معظم العلمانيين منطق المؤسسات الدينية، التي تتماهي بالدين، ومنطق الجماعات الإسلامية التي تتماهى هي الأخرى بالدين، والاعتراف بصحة ادعائها أنها وحدها من يمثل الدين (الإسلام) وينطق باسمه؛ أي عدم تمييز الدين من المؤسسات الدينية الوضعية وسلطتها على عقول المؤمنين وضمائرهم. ويكمن من جانب آخر في الإيحاء بأنّ العلمانية نقيض الدين، لا نقيض سلطة المؤسسة الدينية.
الله، عز وجل، لم يكن في يوم من الأيام سبب شقاء الناس وبؤسهم وقهرهم ودوس كرامتهم، بل الناطقون باسمه والحاكمون باسمه. الثورة الجذرية التي حققها مارتن لوثر في العالم المسيحي، كانت إسقاط اعتبار الإكليروس “الكهنوت”، ونقل الكنيسة من خارج الفرد، المؤمن، إلى داخله ضميراً فردياً ووازعاً أخلاقياً، على غرار الإسلام الأصلي؛ إذ “كنيسة” المسلم ومرجعيته الأصلية هي عقله وقلبه وضميره (استفت قلبك).
ولكن الأمور لم تجر على هذا النحو، بفضل “السلطة الدينية”، التي لا يمكن فصل تاريخ نشوئها وتطورها عن تاريخ الاستبداد، وعن حاجة المستبدين إليها، وعن تاريخ تديين السياسة وتسييس الدين. بفضل هذه السلطة (غير الشرعية، بجميع المعاني) التي يريد بعضنا أن يوحدها ويمركزها ويمأسسها ويقويها، لتصير ضد نفسها وضد أسباب وجودها، وضد مصالحها وامتيازاتها، صار الاستبداد مألوفاً وشرعياً جيلاً بعد جيل.
و”تديين السياسة” كان مطَّرداً في تجارب جميع “الشعوب”، بما فيها التجربة الإسلامية؛ وهو أصل تسييس الدين، بحكم التقليد والاقتداء بالسلف “الصالح”، لا كما يفترض بعضهم؛ فهل كان ممكناً فصل شخصية الصحابي المؤمن أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، مثلاً، عن شخصية الخليفة، الحاكم، رأس السلطة السياسية، الذي قاتل من امتنعوا عن أداء الزكاة؟ ألم يكن حكمه وحروبه من قبيل تديين السياسة؟
*تدببن السياسة كان مطَّرداً في تجارب جميع الشعوب بما فيها الإسلامية وهو أصل تسييس الدين بحكم التقليد والاقتداء بالسلف*
ولما كان الدين عاطفة ذاتية وإيماناً شخصياً وضميراً فردياً واجتماعياً ووازعاً أخلاقياً .. فسلطته من قبيل سلطة الإنسان / الفرد على ذاته، تتجلى في ممارسته في صيغة الواجب الديني، الأخلاقي، وهذا ما نعنيه حين نقول: إن الدين مبدأ معرفة ومبدأ حرية ومبدأ محبة ورحمة ومبدأ مجاهدة النفس الأمارة بالسوء، وحين نقول: الدين هو حسن المعاملة ومكارم الأخلاق؛ فلا نحمل الدين أوزار الاستبداد والمستبدين.
ومن ثم، فإنّ أي “سلطة دينية” خارجية، مفروضة على الفرد أو على الجماعة من خارجه ومن خارجها، هي بالأحرى سلطة ذات على موضوع، يصير معها المؤمن والمؤمنون مجرد موضوع هامد وتابع ومسلوب الإرادة؛ أي إنّها سلطة شخص أو مؤسسة أو نظام اجتماعي أو حكومة … أو “دولة”، تُمارَس على المؤمن وعلى المؤمنين باسم الدين، فهي من ثم سلطة مستمدة من الدين، بوصفه أحد مصادر السلطة، لا بوصفه سلطة في ذاته، فالدين ليس كذلك. إن فساد الدين يبدأ من اللحظة التي يتحول فيها إلى سلطة في ذاته، تنفي مفهوم الإيمان، أو إلى أداة لسلطة أخرى.
فالسلطة هي السلطة. تنبع من كل شيء، فتكون واحدة من سلطتين: إما سلطة ذات على موضوع؛ أي سلطة هيمنة واستتباع وإكراه وإرغام واستبداد متفاوتة الشدة ومختلفة المظاهر، ومزينة بالورود في كثير من الأحيان، وإما سلطة الذات على ذاتها، وهي مظهر من مظاهر الحرية، على صعيد الفرد والجماعة والمجتمع والأمة. “السلطة الدينية”، كالسلطة السياسية، يمكن أن تكون هذه أو تلك، وهما عندنا، حتى اليوم، سلطتا استتباع وإكراه وإرغام واستبداد، في سلطة واحدة.
ولذلك كان الاستبداد السياسي ملازماً للاستبداد الديني، يغذيه ويتغذى منه. وكانت المؤسسة الدينية ظهيراً للسلطة السياسية، تمنحها مشروعية أخلاقية وتسوغ سياساتها وتقنع مصالح أهلها.
ولا يمكن أن تكون “السلطة الدينية” من قبيل سلطة الذات على ذاتها، إلا حينما تستقل بذاتها عن السلطة السياسية وتنفك عن الاستبداد، وتكف عن كونها سلطة خارجية، وهذا غير ممكن مع وجود الاستبداد ودوامه؛ فالاستبداد هو من أنشأ “السلطة الدينية” سلطةً خارجيةً، كانت، ولا تزال، ضالعة في إثارة الحروب والنزاعات وزرع بذور الحقد والكراهية، لا العكس؛ فوجودها ودوامها سلطةً خارجيةً مقترنان بوجوده ومتوقفان عليه.
هامش:
_________
[1] – ياسين الحاج صالح، تأملات في السلطة الدينية والسلطة السياسية ومعنى العلمنة، موقع السؤال الإلكتروني، www.assuaal.com ، وموقع الأوان الإلكتروني، www.alawan.com. والاقتباسات الواردة في البحث من المقال نفسه.
نقلاً عن حفريات