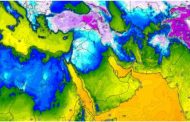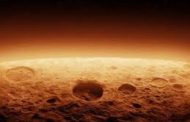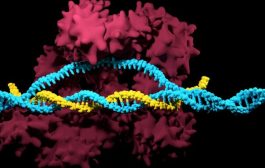سامح البدوي
في مايو/أيار عام 1812، اختفى مواطن يُدعى، راسل كولفين، على نحو غامض، ودون سابق إنذار، من بلدته مانشستر بولاية فيرمونت، وفيما نما اعتقاد بأن كولفين قُتل، كانت أصابع الاتهام تشير إلى شقيقي زوجته؛ جيسي وستيفن بورن، اللذين عُرفا بعدائهما الشديد له. لكن، ورغم ذلك، فإن مصير كولفين ظل، نحو سبع سنين، محض تكهنات، لا أكثر.
لاحقاً، وعقب سلسلة من الأحداث الغريبة، عاد الجدل مرة أخرى، حين عثر كلب على عظام مدفونة في ملكية آل بورن، ليعلن ثلاثة من أطباء البلدة أنها عظام بشرية. ونتيجة لذلك، قُبض على الأخوين، جيسي وستيفن، بتهمة قتل كولفين. ورغم إنكارهم في البداية، فإنهما عادا وقدّما اعترافاً تفصيلياً بالجريمة، بعدما ادعى بضعة شهود، أنهم سمعوهما يُهددان صهرهما يوم اختفائه، قبل سبع سنوات.
فعلياً، لم يكن هناك دليل واحد على وقوع جريمة من الأساس، فقد تبيّن قبل المُحاكمة أن العظام المكتشفة ليست بشرية، ومع ذلك فإن المحكمة قضت بالإعدام لأحدهما، والمؤبد للآخر. لكن، وقبل تنفيذ الإعدام، معجزة: راسل كولفين، الضحية المُتخيّلة، يعود إلى البلدة، على قيد الحياة.
بحسب المعلومات المتاحة، كانت هذه هي المرة الأولى، في تاريخ الولايات المتحدة، التي يعترف فيها شخص ما بجريمة لم يرتكبها. ثم بداية من عام 1989، بدأ استخدام الحمض النووي في معرفة ما إذا كان الشخص بريئاً أم لا، وتم اكتشاف أكثر من أربعمائة إدانة خاطئة حصلت نتيجة لاعترافات كاذبة.
بالطبع، هذا هو عدد الحالات المعروفة، منذ ذلك العام فقط، التي تمت تبرئة أصحابها بالفعل، أمّا عن العدد الحقيقي للذين قضوا حياتهم -أو يقضونها الآن- في السجن، بل وربما أُعدموا، نتيجة اعترافات كاذبة، فليس في المستطاع الإجابة عن هذا، بيد أنه في المستطاع، مع ذلك، الإجابة عن سؤال أهم: لماذا يعترف شخص عاقل بجريمة إذا لم يكن ارتكبها فعلاً؟
الاستجواب
وفقاً للخبراء، تكمن المشكلة الحقيقية في طريقة الاستجواب؛ «طريقة ريد» على وجه الدقة، تلك التي ظهرت في أربعينيات القرن الماضي، وتستخدمها اليوم معظم وكالات إنفاذ القانون حول العالم.
تقوم «طريقة ريد» على افتراض مُسبق بأن شخصاً ما مُذنب، باتباع حدس شخصي يسترشد بمجموعة من ردود الفعل اللفظية وغير اللفظية؛ فالشخص الذي يشيح بنظره، أو يحك أنفه، يُرجَّح أن يكون كاذباً. لكن، في حين تدّعي شركات الاستشارات الشرطية، أنها تُدرِّب المحققين على التمييز بين الصدق والخداع بدقة 85%، تؤكد الأبحاث أن دقتهم ليست أفضل حالاً من الاستعانة بعملة معدنية. ورغم ذلك، فإن ذلك الافتراض غالباً ما يكون محوراً باقي الاستجواب، فالمحقق لا يفكر في المتهم، إلا باعتباره مجرماً، يتعيّن انتزاع اعترافه. ولتحقيق ذلك، يلجأ إلى «العصا والجزرة».
تتبلور مهمة العصا في حمل المتهم على اليأس من إنكار الذنب، حيث يُخبره المحقق كذباً بوجود أدلة على تورطه، ويُهدده بعقوبة الإعدام حال لم يعترف. وعلى نحو مدهش، العصا تعمل.
في إحدى التجارب المعملية التي استهدفت بيان تأثير إبلاغ شخص بريء بوجود أدلة على تورطه، طلب باحثون إلى مجموعة من الطلاب استخدام بعض أجهزة الحاسوب، مع تحذيرهم من الضغط على مفتاح «Alt»، لأن ذلك سيؤدي إلى تعطلها. لم يعرف الطلاب أن الأجهزة مبرمجة مُسبقاً بحيث تتعطل تلقائياً. بعد توقفها، اتُهم الطلاب بأنهم المُتسببون في العطل، ورغم أنهم أنكروا في البداية مسئوليتهم عمّا جرى، فقد عادوا وغيّروا موقفهم، عندما أخبرهم الباحثون أن شاهداً رآهم يضغطون المفتاح.
لاحقاً، ولدى إصابة المتهم باليأس، تعمل الجزرة. وهنا، يتظاهر المُحقّق بالتعاطف معه، ويقدم المسوغات الأخلاقية للجريمة، كأن يخبره أنها لم تكن متعمدة، وأن أي شخص مكانه كان ليفعل الشيء ذاته. وبشكل ضمني، يوحي له أن الاعتراف سيساعده في ورطته. في النهاية، وعقب ساعات ممتدة من الاستجواب، بلا نوم، أو طعام، يُقرِّر الشخص، رغبةً في إنهاء التحقيق، أنه الجاني.
يُلخِّص «ألان هيرش»، رئيس برنامج دراسات العدالة والقانون في كلية ويليامز، التأثير السيئ لهذه الطريقة قائلاً:
أحياناً، يتجاوز تأثير هذا الأسلوب مجرد إجبار شخص بريء على الاعتراف، إلى حد إقناعه بالذنب. عام 1988، اتهم ستة أشخاص بقتل سيدة تُدعى، هيلين ويلسون، ورغم انعدام الأدلة على تورطهم، فقد دأب «عالِم نفس شرطي» على إقناعهم بأنهم مُذنبون، ولكنهم يقمعون ذكرى الحادث. وبالفعل، اقتنع الستة جميعهم بالجرم، لدرجة أنهم كانوا يصرخون لأقاربهم بندمهم العميق على فعلتهم. لكن، وعقب نحو عقدين، حصلوا جميعاً على البراءة، بعدما ربطت أدلة الحمض النووي رجلاً آخر بالجريمة.
فئات مُهدَدة
تؤدي الاستجوابات بـ«أسلوب ريد» إلى انتزاع اعترافات كاذبة من الجميع، ومع ذلك فإنها تؤثر في بعض الأشخاص أكثر من غيرهم. فاحتمالية تقديم اعتراف كاذب تزداد لدى الأفراد الحريصين على تجنب المواجهة، بخاصة مع منْ هم في السلطة. كما يلاحظ أن الأشخاص المضطربين نفسياً في خطر أكبر للاعتراف الكاذب عندما يكونون تحت الضغط.
كذلك، فإن المعتلين عقلياً مُهددون بدرجة أكبر من الآخرين، وذلك لجهلهم بحقوقهم في التزام الصمت، وطلب المشورة، فضلاً عن عدم استيعابهم عواقب الأقوال التي يُطلب منهم الإدلاء بها.
المراهقون هم مجموعة أخرى مُهددة بشدة، إذ ينصب تركيزهم على المكاسب الفورية، دونما التفكير في العواقب بعيدة المدى. فمن منظور علمي، لا يكتمل بلوغ الإنسان في سن الـ18، كما قد يظن البعض، إذ لا يصل الدماغ إلى مرحلة النضج الحقيقي إلا في العقد الثالث من العمر، حيث يُودِّع فعلياً مرحلة الطفولة ويدخل عالم البالغين.
لكن، وبإقرار حقيقة أن الاعترافات الكاذبة تحدث، فإن السؤال المنطقي الذي يتبادر إلى الأذهان؛ كيف يتضمن الاعتراف، إذا كان كاذباً، تفاصيل عن الجريمة، لا يمكن لأحد، أي أحد، باستثناء الجاني الحقيقي -والشرطة بالطبع- معرفتها؟
التلوث
يشير مصطلح التلوث إلى عملية تسريب تفاصيل الجريمة إلى المشتبه بهم خلال الاستجواب. ورغم أن التلوث يمثل انتهاكاً خطيراً لقواعد التحقيقات، فإنه يحدث بصفة مستمرة.
بالنسبة للأبرياء، يتسبب هذا الخطأ في تزويدهم بالحقائق الرئيسة حول الجريمة، فعلى مدار الاستجواب، يلقنهم المحققون معلومة تلو الأخرى، لذا فإنها تصبح تلقائياً جزءاً من روايتهم عندما ينهارون. في تحليل لـــ(38) اعترافاً كاذباً، وجد أحد الباحثين أن 36 اعترافاً يتضمنون تفاصيل دقيقة بشأن الجريمة.
خطورة تلك التفاصيل تكمن بشكل أساسي في خصوصيتها، إذ يفترض أنها لم تصل إلى وسائل الإعلام، وأن الجاني وحده يعرفها، لذا فإن احتواء الاعتراف عليها، يكون قاتلاً خلال المُحاكمة.
على أن ثمة مشكلة أخطر، بحسب دكتور «فابيانا ألسيستي»، أستاذة علم النفس بجامعة بتلر، وهو أن عملية التلوث لا تقتصر على مجرد الحقائق الموضوعية، وإنما تتجاوز ذلك إلى الدوافع، والأعذار، وأفكار ومشاعر المعترف، والضحية، عند ارتكاب الجريمة، ما يجعل الاعتراف يبدو وكأنه قادم من ذاكرة الشخص.
يقع المحققون غالباً في خطأ التلوث، عندما يحاولون التوفيق بين أقوال المشتبه به، والحقائق التي لديهم حول الجريمة، بدلاً من التفكير في أن ذلك التناقض ربما يعني براءة الشخص. تفسر دكتور فابيانا ذلك بالأحكام المسبقة لدى المحققين: «حسناً، أعرف أن هذا الشخص فعل ذلك. لماذا أهتم بعدم تسريب المعلومات إليه؟! هو لديه بالفعل جميع المعلومات، لأنه فعل ذلك».
ما يزيد الطين بلة، هو أن عملية الاستجواب لا يتم غالباً تسجيلها، وإنما الاعتراف النهائي فحسب، لذلك يصعب اكتشاف أن التفاصيل الدقيقة التي أدلى بها الشخص، قد حصل عليها في الحقيقة من قبل المحققين، وليس لأنه ارتكب الجريمة.
لكن، حتى وإن سُجل الاستجواب بالكامل، وشوهدت انتهاكات المحققين لقواعد عملهم، فإن أحداً لن يصدق أن الاعتراف حدث فقط بسبب الإكراه، فمتى أدان الشخص نفسه، يصبح من المتعذر تدارك الضرر الناجم عن ذلك.
قوة الاعتراف
هناك اعتقاد شائع مفاده أن بمقدورنا التعرف على الاعترافات الكاذبة في حال حدوثها. مع ذلك، فإن الأبحاث العلمية تنفي بصرامة صحة هذا الاعتقاد. الاعترافات، صادقة كانت أو كاذبة، تملك قوة هائلة، بصرف النظر عما إذا كانت تناقض الحقائق المعروفة، أو انتزعت بالإكراه.
ببساطة، تعد الاعترافات مقنعة بقوة من حيث المنطق والفطرة السليمة، فلا يمكن أن يدلي شخص باعتراف ضد مصلحته الذاتية، ما لم يكن مذنباً فعلاً. الأسوأ أن هذه الاعترافات لا تقتصر على مجرد الإقرار بالذنب، بل تتجاوزه إلى تفاصيل دقيقة لا يعلمها إلا الجاني، التي يُسرِّبها المحققون، بطبيعة الحال، إلى الشخص من خلال الاستجواب.
سبب آخر في كون الاعترافات شديدة الخطورة، وهو قدرتها على تلويث الأدلة الأخرى، فإذا عرف فاحص البصمات، مثلاً، أن شخصاً ما اعترف، فعلى الأرجح سيخبر بأن بصمة الشخص المُعترِّف تتطابق والبصمة في مسرح الجريمة. ولعل ذلك يفسر كون 78% من الإدانات التي حدثت نتيجة اعتراف كاذب، وأثبت خطئها الحمض النووي، كانت تحتوي على خطأ واحد أو أكثر في أدلة، تم الحصول على معظمها بعد الاعتراف.
ربما يدهشك ذلك، لكن الاعترافات قد تتفوق حتى على أكثر الأدلة موثوقية. ففي عام 1991، اتُهم جيف ديسكوفيتش، 16 سنة، باغتصاب سيدة وقتلها. ورغم اعتراف ديسكوفيتش بارتكاب الجريمة، فإن أدلة الحمض النووي أثبتت أن اعترافه كان كاذباً، وأنه ليس الجاني الحقيقي، ومع ذلك فإن هيئة المحلفين اتخذت قرارها بإدانته. بعد خمسة عشر عاماً قضاها في السجن، أُطلق سراح ديسكوفيتش، عقب مطابقة الحمض النووي مع القاتل الحقيقي.
إعادة نظر
في أغسطس/آب 2012، وافقت ولاية نبراسكا على دفع 500 ألف دولار لمواطن يُدعى، داريل باركر، كتعويض عن إدانته بالخطأ في اغتصاب وقتل زوجته خلال خمسينيات القرن الماضي. حدث ذلك عندما رجع باركر من عمله ليجد زوجته، وقد تعرضت للاغتصاب والخنق. بعد دفنها مباشرةً، هاتفته الشرطة، وطلبته للاستجواب. اثنتا عشرة ساعة، وكان باركر، الزوج المحطم، مُعترفاً بمسئوليته عن الجريمة، ورغم أنه عاد فوراً وتراجع عن اعترافه، فإن أحداً لم يصدقه.
حدث ذلك عام 1955، وكان ضابط التحقيق شرطياً يُدعى، جون ريد.
نعم، الرجل نفسه الذي ابتكر الطريقة التي تستعملها اليوم معظم وكالات إنفاذ القانون حول العالم، والسبب الأول في حدوث الاعترافات الكاذبة.
منذ ذلك الوقت، ولسنوات عديدة لاحقة، اتبع المحققون خطى جون ريد في استجواب المتهمين، إذ لم تكن تتوافر بعد المعرفة بخطورة أسلوبه. اليوم، وبفضل استخدام أدلة الحمض النووي في تحديد الجاني الحقيقي، وما تبع ذلك من اكتشاف عشرات الاعترافات الكاذبة، فإن وعياً متزايداً قد تشكل بشأن مساوئ تلك الطريقة.
في 2017، أعلنت «Wicklander-Zulawski & Associates»، وهي إحدى أكبر مجموعات الاستشارات الشرطية في الولايات المتحدة، أنها ستوقف تدريب المحققين عليها. كذلك، سلّط عدد من الأعمال الوثائقية والفنية الضوء على تأثيرها السيئ، ولعل أبرزها المسلسل القصير «When they see us»، المُستوحى من قضية «خماسي سنترال بارك». ليس هذا فحسب، ففي أبريل/نيسان الماضي 2022، أقرّت ولاية إنديانا قانوناً يحظر على الشرطة الكذب على الأطفال، بغرض الحد من احتمالية تقديمهم لاعترافات كاذبة.
لكن، ومن وجهة نظر خبيرة، فإن معالجة الاعترافات الكاذبة، تقتضي ما هو أكثر من ذلك؛ بدايةً من تجنب الأحكام المسبقة بناءً على الحدس، وعدم استخدام ما يُعرف بأجهزة كشف الكذب، وتسجيل عملية الاستجواب، ووضع سقف زمني معقول لها، فضلاً عن الاعتماد على الاعترافات حال فقط كانت تُقدِّم معلومات جديدة، لا يعرفها سوى الجاني.
المصدر “إضاءات”