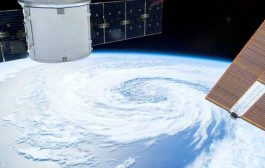سامح إسماعيل
كاتب مصري
لعلّ الفارق بين المجتمع البدائي والمجتمع الحديث، يدور حول جملة من المعطيات التي تميّز الثاني عن الأول، وهو ما انتبه إليه عالم الاجتماع، هنري ماين، في معرض تحليله لتطور المجتمعات الإنسانيّة، وأبرز هذه المعطيات؛ مفهوم التعاقدية، ومفهوم المكانة التي تؤسس لنوعية الدور الوظيفي للأفراد، وفق القدرات والمهارات الشخصية، بالتالي؛ تتحلل المجتمعات المركزية، التي تقوم على أواصر مثل: القرابة والعرق والدين، لصالح الجماعة الوطنيّة الحديثة، التي تقوم، وفق توصيف دور كايم، على التضامن العضوي الحرّ بين أفرادها.
من هنا نشأت فكرة الوطن القومي، وتجلّت في التاريخ الحديث، كمحصلة لتطور الجماعة البشرية على كافة المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ حيث بدأت الجماعة القبلية/ الدينية في الانحسار تدريجيّاً، لصالح فكرة الدولة القائمة على مفهوم العقد الاجتماعي الذي نظّر له روسو.
وسرعان ما تفجّرت الحالة القومية في التاريخ، مع تراجع دور المؤسسة الدينية التقليدية، ليصبح الانتماء لوطن واحد، تجمع بين أفراده مجموعة جديدة من المعايير، مثل: التاريخ المشترك، والتراث الثقافي/ الاجتماعي الواحد؛ فالقومية تنطلق من وجود مكون نفسي جمعي، في محيط جغرافي تحدده قدرة الجماعة المتسقة عضوياً على تحقيق السيادة فيه، وبظهور ألمانيا الموحدة وإيطاليا الموحدة، ظهرت تنظيرات متعددة لفكرة القومية، احتلت فيها العناصر الإثنية واللغوية صدارة المشهد السياسي، الذي وجهت النخبة البرجوازية عناصر التغيير القومي فيه، وهو ما وصل تأثيره إلى المنطقة العربية، مع تراجع نفوذ الإمبراطورية العثمانية، قبيل سقوطها التدريجي.
وسرعان ما تطورت الفكرة القومية، بصورة أكثر شمولية، لتكرس المزيد من العناصر المكونة لفكرة الوطنيّة، التي أدارت ظهرها لفارق اللغة والعرق، لصالح إدارة التنوع في الدولة الواحدة، طالما اجتمعت الجماعة في بقعة جغرافية، اتفقت على بسط سيادتها وتحقيق مصالحها فيها، بالتالي؛ تحللّت مركزيات أخرى متعددة، وظهرت أنماط اقتصادية أكثر تعاونية وميلاً نحو اليسار، عن تلك التي أسّست لها النخبة البرجوازية في مرحلة التأسيس، كما ظهرت الأدوار الفرديّة بصورة أكثر تأثيراً، وهو ما ساعد في انطلاق القدرات الكامنة في الأشخاص.
في هذا السياق المفاهيمي المفعم بالوطنية القومية، ذات القدرة على الانتشار الشعبي، كان لدى جماعة الإخوان المسلمين تصورات مغايرة، أدارت من خلالها ظهرها لحركة التاريخ، فيما يتعلق بتطور الجماعات البشرية، لتستدعي مركزية الدين في غير موضعها، لابتلاع الدولة الوطنية، وتفكيكها مؤسسيّاً، لصالح جماعة ربانيّة، ادّعت امتلاك نوع رديء من الخلاصيّة المطلقة.
الأمميّة الدينية ووهم أستاذية العالم
على عكس النزعة الذاتية/ الفردانيّة التي قادت عمليات التحول الاجتماعي في العصر الحديث، والتي سرعان ما بدأت تتشكّل في صورة موجات الوحدة القوميّة في أوروبا، وبلورتها في العالم الثالث حركات التحرر الوطني في مواجهة الاستعمار، استدعت جماعة الإخوان المسلمين مجموعة من المفاهيم القروسيطيّة، التي تدور في فلك الانتماء لكيان مفارق، هو الدولة الدينيّة المقدسة ذات الأدوار الوظيفية التي انتهت إكلينيكيّاً، وهو ما يعكس حالة من حالات اغتراب الوعي في تيه الصعود الأيديولوجي، بشكل مضاد تماماً لحركة التاريخ، في محاولة لقلب وتطويع الواقع؛ لصالح تصورات سياسية مغلقة، في قوالب مفعمة بالمقولات الدينيّة، ذات الأفق المحدود، والفقر الواضح في عناصرها المكونة.
في ذروة صعود المدّ العروبي، الذي جاء كمحاولة لتأسيس شخصيّة قوميّة مستقلة في محيط تلك الوحدة الثقافية، المتسقة عضوياً من المحيط إلى الخليج، بعيداً عن مساعي الهيمنة الغربية التي دشّنها مشروع أيزنهاور، عام 1957، والاستقطاب السوفييتي الحاد، بدءاً من صفقة الأسلحة التشيكية، عام 1955، وفي سياق واحدة من أشرس معارك التحرر الوطني، اختار الإخوان المسلمون نوعاً آخر من أشكال الانتحار السياسي، بتقسيم العالم دينيّاً إلى أرض حياد وأرض جهاد، وتكفير تيارات نضالية بعينها، رغم وحدة المصير والمعركة، واختلاق نوع آخر من الأمميّة، هي الأمميّة الدينية، رغم صعوبة تخلّق معطياتها أو تشكلها من الناحية السياسيّة، واستحالة هذا الطرح جغرافياً، واللافت أنّ الإخوان الذين حشدوا لمعركة فلسطين، ووظفوها دعائيّاً في إطار الحرب الدينية على اليهود، أداروا ظهرهم لمعركة التحرر الوطني في الجزائر، والتي حمل التيار القومي تبعات دعمها حتى النهاية؛ بل ورأت الجماعة في رموز النضال الأممّي ضدّ الهيمنة الاستعمارية، والرأسمالية الغربية، رموزاً للكفر والإلحاد، رغم ما بذله هؤلاء من تضحيات فائقة.
وفي الوقت الذي تطوع فيه عشرات الآلاف من دول الكتلة الشيوعية، للقتال في معركة السويس، إبان العدوان الثلاثي على مصر، عام 1956، لم يُسمع للجماعة صوت! وقد تبدو محنة الحظر والسجن التي مرّت بها الجماعة مبرراً لصمتها المريب آنذاك، إلا أنّ موقف شحاتة هارون، اليهودي المصري الذي بعث إبان حرب حزيران (يونيو) 1967، رسالة من سجنه، يطلب فيها التطوع للقتال ضدّ إسرائيل، يفضح الجماعة ويكشف مبرراتها الواهية، لتفسير تخاذلها في واحدة من أبرز المعارك الوطنية.
لقد أودت تصورات الأمميّة الدينيّة، والرغبة المحمومة في أستاذية العالم، بالمشروع الإخواني إلى هاوية تاريخيّة، سبحت به عكس التيار، في دوائر تيه أبدية داخل مدارات المستحيل.
الاقتصاد الريعي وطبقية التنظيم
منذ لحظة التأسيس؛ احتفى الإخوان المسلمون بنمط الاقتصاد الريعي القائم على التجارة، وفق قاعدة “تسعة أعشار الرزق في التجارة”، وكثيراً ما احتفى المرشد الأول حسن البنا بالأثرياء، وسعى إلى التقرّب إليهم، وضمّ من يستطيع منهم إلى الجماعة، والمدقِّق في البنية الاقتصادية عند الجماعة، يلاحظ وجود هيكل رأسمالي بدأ بسيطاً، وانتهى كبنية شديدة التعقيد، تراعي في مساقاتها تراتبية طبقية صارمة، متقاربة هرمياً عند القاعدة، شديدة الاتساع صعوداً نحو القمة.
ذلك النهج الطبقي، بغطاء ديني لتبرير الفوارق الفجّة، جعل الجماعة في بُعد آخر، بينما الإصلاحات الاقتصادية تكتنف العالم من الشرق إلى الغرب، وقد ظهرت إبان ثورة الشباب عدة تنظيرات سياسيّة أخذت الرأسمالية الغربية، وبشكل متفاوت نحو اليسار، بصعود الأحزاب والتيارات الاشتراكية، وتدشين طروحات الطريق الثالث، والاشتراكية الاجتماعية، مع سنّ قوانين الرعاية الاجتماعية، وحقوق العمال، وغير ذلك من المتغيرات، التي حركت وطورت من كافة النظريات الاقتصادية حول العالم.
وحدها الجماعة ظلّت تدير ظهرها للسياسات الاشتراكية، وتكرس للمزيد من التوجهات اليمينة في بنيتها الداخلية، وهو ما جعل الفجوة تتسع، والقدرة على ممارسة الأدوار الاقتصادية بشكل سياسي تتضاءل، وهو ما تجلّى في مشروعها للنهضة، إبان ثورات الربيع العربي، القائم على المتاجرة في النقد السائل، والهيمنة الرأسمالية على الأنشطة الاقتصادية، وافتقد لأيّ بعد إنساني يدعم الطبقات الفقيرة.
نقلاً عن حفريات