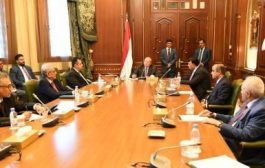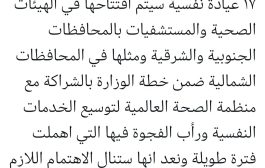أدونيس غزالة
كاتبة سورية
منذ ما يزيد على قرنٍ ونصف قرن من الزمن، وقف سياتل آخر زعماء سكان أمريكا الأصليين (الهنود الحمر) مخاطباً غزاة أرضه (الرجل الأبيض): “نحن نعرف أنّ الرجل الأبيض لا يفهم طباعنا، هو لا يفرّق بين جزءٍ وآخر من الأرض، فكلها عنده سواء؛ لأنّه غريبٌ يأتي ليلاً ويأخذ من الأرض ما يروق له، الأرض ليست أمّه بل هي خصمه، وحين يستولي على أرضٍ يواصل البحث عن أخرى، يسرق الأرض من أبنائها، غير مكترثٍ بشيء، يتعامل مع أمه الأرض وأخته السماء تعامله مع أشياء للشراء والنهب، أو للبيع كالخراف والخرز الملوّن، جوعه سيلتهم الأرض ولن يترك وراءه غير الأرض اليباب”. ويبدو أّنّه بعد كل هذه السنين ماتزال خطبة سياتل تحدّد بوضوح المنطق الذي يسود العالم، والخطاب الذي يهيمن عليه.
فعلى الرغم من أنّ عالم اليوم محكومٌ بقوانين أممية، وشرعة حقوق الإنسان، ومنظمات وهيئات دولية، مهمتها فض النزاع وتجفيف العنف، ولكنّ الواقع يؤكد أنّ نهج الطغاة الذي وصفه سياتل مايزال مستمراً؛ فالحروب والنزاعات والصراعات تغطي مساحاتٍ واسعة من الكوكب، وخطاب الكراهية يزدهر في كثير من المجتمعات وبينها.
فعقل (الرجل الأبيض) الذي روّج سابقاً لهمجية وتوحش الهندي الأحمر، برر إعلان الحرب عليه واحتلال أراضيه والاستيلاء على ثرواتها، هذا العقل الإقصائي مايزال يدير عالم اليوم بالطريقة نفسها، فليس هناك ما هو أفضل من اتهام الآخر بالهمجيّة كوسيلةٍ لإخفاء همجية المعتدي وتبرير عنفه.
إنّ خطاب الكراهيّة في الحقيقة يسبق أيّ عنفٍ يمكن أن يحدث، ويمهد له ويبرر حدوثه، فلا تنظر مبررات هذا العنف إلى المعطى الواقعي لطبيعة الجماعات البشرية واختلافها، بل إنّ هذه المبررات تنظر فقط لطبيعة المصالح التي يمكن تحقيقها، فالهمجيّة والتوحش اللتان وسمت بهما القوى الكولونيالية شعوب مستعمراتها، إنما تهدف إلى تبرير إخضاعهم والسيطرة عليهم بذريعة أنهم كائنات لم ترتقِ إلى المستوى الإنساني، ليصبح كلّ تنكيلٍ بهم مقبولاً ومشروعاً، فوصف “كريستوفر كولومبس” لسكان أمريكا الأصليين بالمتوحشين وأكلة لحوم البشر، وأنهم شعوب لا تملك أرواحاً، وأنهم أقرب إلى الحيوانات منهم إلى البشر، أنتج خطاب كراهية أدّى إلى إفناء الملايين منهم.
فهل تم وصفهم بالمتوحشين؛ لأنهم لم يفهموا “كيف يمكن شراء نقاء الهواء وتألق الماء”، وأنهم لم يروا “معنى للحياة بدون الاستماع لصرخة بومة وصخب الضفادع حول برك الماء في الليل”؟ أو بالهمجيين لأنهم يدعون في صلواتهم “أن يُفتح أمام أعينهم طريق الجمال، وأن تُلهم أيديهم احترام الأشياء، وأن يتحلوا بالحكمة لاستيعاب الدروس المخبئة في كلّ ورقة من أوراق الشجر وعلى كل صخرة من صخور الجبال”؟ أم لأنهم “يطلبون القوة لا ليتنافسوا بل لمجاهدة النفس الأمارة بالسوء، والقدرة على الرحيل عن هذه الحياة بيدين نظيفتين ونظرة خالية من الدنس كيلا تشعر أرواحهم بالخجل”؟ إنّ من تم وصفهم بأكلة لحوم البشر، استقرؤوا المستقبل الموحش لمئات السنين.
“ماذا سيحصل عندما تطغى رائحة الإنسان على زوايا الغابات، أو عندما تشوّه الأسلاك الكهربائية مناظر الجبال؟ هذه هي نهاية العيش وبدء صراع البقاء”. هذا الاستقراء يحدّد تماماً أيّ الأطراف اتسم بتوحشه وهمجيته.
إنّ سلوك (الرجل الأبيض) ولغته لم يتغيرا منذ ذلك الوقت حتى الآن، بالتالي فإنّ المسألة برمّتها تبتعد عن كونها تنبؤاً أو نبوءة، إنها تتعلّق بالحكمة الإنسانيّة، فبالقليل منها يمكن أن نعرف أنّ ثمار الغد هي ما نزرعه اليوم، أو بحسب سياتل، إنّ المنطق الذي يقوم على الاعتداء سينتهي بأصحابه عاجلاً أم آجلاً، ولأنّ كل شيء لدى أصحاب هذا المنطق يُنظر إليه كخصمٍ، ولأنّ التنافس يمضي على أشدّه مدفوعاً بحمى التملّك والاستحواذ، فلا شكّ أن طبول الحرب لن تتوقف، وصدى هذه الطبول سيبقى يتردد في كل مكان من عالمنا.
“الوجه الشاحب” التسمية التي أطلقها الهنود الحمر على الرجل الأبيض، هو النقلة المتقدمة لثقافة يثوي في جذورها العنف، إنه وجهٌ لا يعرف من هو ولماذا وُجد وإلى أين سيمضي، فعندما تصبح الأرض خصماً سيصبح الجميع ذوي وجوه شاحبة، وعندما يريد الكائن أن يُخضع كلّ شيء لشروطه وفق قانونٍ وحيد، الربح، الفوز، الغلبة، سيخسر كينونته ويتماهى مع العدم، وعندما يعتقد الكائن أن كلّ التاريخ تاريخه وحده، وكل الوجود وجوده وحده، لن يتوقف جشعه عند حدّ، وما إن يحصل على شيء سيسعى للمزيد، وحين يصبح النهب شريعةً، والاعتداء ثقافةً، حينها لن يترك خلفه سوى الأرض اليباب.
لا شكّ أنّ نهاية العام الميلادي وبدايته مكانٌ خصبٌ لتفتّح التنبؤات وازدهارها، فالجوع العالمي الحاد لمعرفة المصير الذي ينتظر البشرية، يشكّل ركيزة قويّة لنمو هذه الظاهرة، وتزايد أعداد متنبئيها حول العالم، كما ويترافق هذا التزايد أيضاً مع إحياءِ تنبؤات لعرّافين قضوا ومازالت تنبؤاتهم تتردد، وتحظى إلى اليوم باهتمامٍ عالمي واسع من جمهور يتزايد سنوياً، تنبؤاتٍ تشير إلى فناءٍ وشيك، تتلخص بأوبئةٍ فتّاكة، وكوارث طبيعيّة وبشرية، وحروبٍ يمكن أن تندلع هنا وهناك وتفتك بالجميع. فهل نحن حقاً بحاجة لمعرفة الواقع من خلال قراءة المستقبل، أم أنّ قراءة الواقع تكشف أمامنا المستقبل؟ إنّ “سياتل” لم يكن متنبئاً ولا عرّافاً، إنّه الحكيم الذي قرأ الواقع واستقرأ منه المستقبل، وبأعينٍ متسعة يمكن لنا أن نكون سياتل والكثيرين غيره، فلماذا نصرّ أن نمضي مغمضين، نقف على أبواب العرافين والعرافات نتسوّل مستقبلنا؟
نقلاً عن حفريات