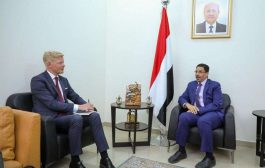أمين الزاوي
كاتب ومفكر
ملخص
إن الأمة المثقفة ثقافة حرة تنتج مواطناً حراً في اختياراته السياسية، وتؤسس لمجتمع قادر على تجاوز جميع المحن السياسية والاقتصادية والهوياتية التي قد تعترضه.
في المجتمعات التي تسود فيها الثقافة والفنون، مع كل موعد انتخابي سياسي حاسم، يكون المواطن فيها قادراً على اختيار الأفضل، الاختيار الذي يعكس جزءاً من أحلامه وطموحاته الفردية والجماعية التي تنتجها حاسته وحدسه الثقافي.
هناك معادلة تاريخية موثقة ومؤكدة تقول، الأمة المثقفة تضمن لمستقبلها، وبصورة أوتوماتيكية اختيارات سياسية إيجابية.
لكن علينا أن نفرّق ما بين الثقافة الحقيقية من جهة وثقافة البروباغندا من جهة ثانية، إنهما أمران مختلفان بل متعارضان.
إن الثقافة التنويرية هي فعل سياسي – اجتماعي، إذ إن حرية التخييل والخيال لدى منتجي الفنون والآداب مكفولة وخصبة، ويكون فيها الهدف الأساس هو إسقاط كل أشكال الجدران المرفوعة ضد الحرية الفردية والجماعية التي تمارسها السلطة السياسية القمعية.
وأما ثقافة البروباغندا التي سادت لمدة طويلة العالم العربي والمغاربي، ولا تزال قائمة بصورة من الصور في كثير من المؤسسات الثقافية في هذه البلدان، فهي عبارة عن نشاط عقيم ومشبوه يتستّر بغلاف خارجي ثقافي أو جمالي كاذب، أدبي أو مسرحي أو سينمائي أو تشكيلي، لكن يكون فيه الخيال الإبداعي موظفاً، في النصوص الأدبية أو فنون الفرجة، لصعود ثقافة الشر، وتكريس عبادة الزعيم وتعميم الرداءة والغباء الحداثي.
إن الأمة المثقفة ثقافة حرة تنتج مواطناً حراً في اختياراته السياسية، وتؤسس لمجتمع قادر على تجاوز جميع المحن السياسية والاقتصادية والهوياتية التي قد تعترضه.
يقوم المثقفون، منتجو السعادة الاجتماعية بوصفهم مهندسي العقل والنقد لا النقل والاتباع، من خلال الأدب والموسيقى والأغنية والفن التشكيلي والمسرح والسينما، بدور مركزي في الدفاع عن “المدينة” بمفهومها الأفلاطوني، بمفهومها التعددي السياسي والثقافي والإثني.
إن الثقافة ليست أبداً، ويجب ألا تكون، العربة الأخيرة في قطار التاريخ المتهالك والبطيء، وهو الحاصل للأسف في مجتمعاتنا العربية والمغاربية.
إن الثقافة التي تصنع الأمم الكبيرة هي تلك المتحررة من كل المظاهر الفلكلورية الكرنفالية التي يريدها أصحاب الحل والربط أن تكون استجابة لنداء الزعيم السياسي العطشان المتلهف للسلطة، أو الحزب السياسي المنتهية صلاحيته أو للقبيلة المزكومة بفيروس الفيتوهات.
إن تاريخ الرواية الجزائرية الحديثة، على سبيل المثال، تقدم لنا درساً كبيراً في معنى دخول الكتاب مباشرة في الحركة الوطنية وثورة التحرير الكبرى، دخولهم في صناعة التاريخ، فالتاريخ صناعة البشر بأيادٍ متعددة وحساسيات مختلفة، ومن يصنع تاريخه يصنع مستقبله.
إن الأدب السردي أو الشعري الذي أبدعته أسماء مركزية من أمثال محمد ديب ومولود معمري وجان عمروش وبشير حاج علي ومالك حداد وكاتب ياسين ومولود فرعون ومفدي زكريا، بالعربية والأمازيغية والفرنسية، كان سلاحاً قوياً ضد الاستعمار الفرنسي الثقافي والعسكري.
يجب ألا نستصغر أو نستهين بالدور الذي تقوم به الآداب والفنون في اللحظات التاريخية الحاسمة في مسيرة الأمم والشعوب، كما يجب ألا نحتقر أو نقلل من الدور الذي يضطلع به المثقفون والفنانون بوصفهم المجموعة الاجتماعية التي تنير الضمير الجمعي وتحركه وتشحذه من خلال أسئلة قادرة على فعل المراجعة والنقد والتجاوز.
إن قراءة رواية جيدة عالمية أو عربية أو مغاربية، قراءة روايات سرفانتس أو بالزاك أو هنري ميلر أو فيليب روث أو حنا مينه أو نجيب محفوظ أو الطاهر جاووت أو عبدالحميد بن هدوقة أو عبدالرحمن منيف أو الطاهر وطار أو الطيب صالح أو إبراهيم الكوني أو عبداللطيف اللعبي أو رشيد بوجدرة، هي القراءة التي توصل المواطن – القارئ إلى موقع اختيار الرجل السياسي الأفضل، بغض النظر عن مركزه الاجتماعي أو درجة السلطة الموكلة إليه.
الاستمتاع والتمتع الداخلي بالموسيقى، الموسيقى الراقية، هو أيضاً الطريق الناعم السالك والمضمون للدفاع عن سلوك سياسي إيجابي. السماع معرفة، وأن تعرف كيف تستمع لآيت منقلات وجاك بريل ومحمد عبدالوهاب وإيدير وجورج براسانس ودحمان الحراشي وصباح فخري ورضا دوماز ولويس أرمسترونغ وسيلين ديون ومعطوب الوناس وأحمد وهبي وفيروز وخليفي أحمد وعثمان بالي… أن تعرف السماع إلى هؤلاء وغيرهم فأنت تملك قوة خارقة تمنحك القدرة على التحليل والنقد حيال السياسي الغارق في خطابات لا تنتهي وبلاغة فارغة لا تقول شيئاً.
إن المواطن الذي له القدرة الفكرية والجمالية على تأمل لوحة تشكيلية، تفكيك كودات ألوانها وأشكالها، الوقوف على أبعاد رسالتها وعمق فلسفتها، لوحة لمحمد خدة أو بيكاسو أو محمد إيسياخم أو ماتيس أو محمد راسم أو سلفادور دالي أو باية أو رينار أو رشيد قريشي أو يوسف عبدلكي أو دينيس مارتينيز أو فرومنتان أو عائشة حداد أو جمال قطب أو الطاهر ومان أو بهجوري أو كريم سرقوة أو إيتيان دينيه أو جودت قسومة أو ناجي العلي… هذا المواطن يكون له من الذكاء ما يمكّنه من تقييم الوضع السياسي تقييماً سليماً.
المواطن الذي يملك معرفة صحيحة بتاريخ بلده لا يمكنه أن يضيع بوصلته السياسية، إن الذي يظل على ارتباط وتواصل مع رموز تاريخه العريق والقديم والحديث والمعاصر يكون بمنأى عن أي استلاب أو اغتراب، من يعرف جيداً انتماءه إلى سلالة ماسينيسا ويوغرطة وسانت أوغسطين وسان دونا ويوبا الثاني وأبوليوس والكاهنة وكسيلة والأمير عبدالقادر والشيخ الحداد وفاطمة نسومر وأحمد زبانا والعربي بن مهيدي ومصطفى بن بوعلي ومليحة حميدو وديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي وجميلة بوحيرد… لن يسقط في شرك المناورات السياسوية التي يمارسها أشباه السياسيين، وحين يختار سياسياً لن يكون اختياره إلا في الجهة الإيجابية لأن أصوات هذه السلالة النقية التي ينتمي إليها تحرك فيه ناقوس الحضارة باستمرار.
في المجتمعات المثقفة حيث الثقافة أمر يومي معيوش، يتمتع المواطن بنوع من المناعة السياسية الطبيعية والعميقة الصادقة.
إن الثقافة الحقيقية، ثقافة العقل والنقد والتحليل هي سلاح فاعل ضد الرداءة السياسية، فالثقافة الجيدة استثمار طويل المدى، والمجتمعات التي تتمتع بصحة جيدة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً هي قبل كل شيء مجتمعات في صحة جيدة ثقافياً.
إن الاختيار الجيد والإيجابي في المواعيد السياسية كالانتخابات الحاسمة المحلية أو الوطنية، الاختيار المدافع عن ممثلي القيم الإنسانية الكبرى كالحرية والعدالة والمساواة وعن حقوق المواطن البسيطة والمبدئية المنهوبة كالحق في العمل والسكن والتعليم والصحة، لا تتحقق إلا في مواطن حامل لرؤية ثقافية عادلة، صحية ونقدية.
ولأن الثقافة الحقيقية غائبة فمعظم انتخاباتنا السياسية في البلدان العربية والمغاربية هي مواعيد كرنفالية وأعراس موسمية ببارود مبلل.
نقلاً عن اندندبندنت عربية