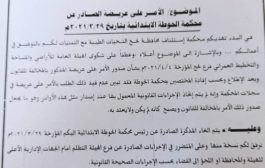منتصر حمادة
كاتب مغربي
كيف نفسر سقوط مجموعة من الإسلاميين سابقاً، كانوا في ما مضى من أتباع المرجعية السلفية الوهابية أو الإخوانية، في مأزق الإلحاد؟ (بصرف النظر عن طبيعة هذا الإلحاد، وإن كنا نعتقد أنّه إلحاد نفسي أو معرفي أو ثقافي، ولا علاقة له بالإلحاد الديني الشائع في المجال الغربي على الخصوص).
كيف نقرأ حالة الداعية السلفي الجهادي المغربي الذي كان في زمن ما، من رموز “السلفية الجهادية” في المغرب، وخاصة في فاس، قبل أن يُصبح اليوم من دعاة التنوير الإسلامي، ولكن عبر الإدلاء أحياناً بمواقف تكاد تقترب من “النموذج السعودي” الحالي في الإصلاح؟
كيف نفسر ازدواجية البرلمانية الإسلامية الحركية في ارتداء اللباس بين الداخل والخارج؟ (لا يهمنا هنا ذكر الأسماء، بقدر ما يهمنا البحث عن المسببات النظرية لهذه الظواهر؛ لأنّ الأمر لا يتعلق بحالة فردية)؟
ما معنى تحول بعض الإسلاميين سابقاً، من مقام “المراهقة السلفية الجهادية” نحو مقام “المراهقة الإلحادية”، عبر تمرير وجهات نظر ساخرة من النصوص القرآنية، مع أنّهم إلى وقت قريب، كانوا يتعاملون من النصوص ذاتها على غرار تعامل عامة وخاصة المسلمين؟
كيف نقرأ إصرار بعض الإسلاميين سابقاً ــ كما نعاين في العالم الرقمي ــ على الظهور بمواقف ومظاهر تصب في خانة “إعلان البراءة” من التجربة الإسلامية الحركية سابقاً، ولو تطلب الأمر توجيه بعض الانتقادات العابرة، من باب إبراء الذمة؟
كيف نفسر وجود مجموعة من القواسم المشتركة بين أعمال إسلاميين سابقاً، دون أن يكون هذا يعرف ذلك؟ (نستحضر هنا مضامين كتاب “لماذا انفصلت عن الإخوان المسلمين؟” للباحث المغربي المقيم في فرنسا، محمد لويزي، ورواية “كنت إسلامياً” للإعلامي والباحث المغربي عمر العمري، حيث نعاين مجموعة من هذه القواسم، لعل أهمها الإقرار بأنّ الانفصال عن التجربة الإسلامية الحركية، أشبه بإعادة اعتناق الإسلام من جديد، إضافة إلى الإقرار في العملين معاً بأنّ خطاب التجربة الإسلامية، في نسختها الإخوانية، كان همه التمكين السياسي، أولاً وأخيراً).
هذه الأسئلة غيض من فيض، وتهم الأحوال النفسية والروحية للمتديّن الإسلامي الذي أخذ مسافة نهائية من المشروع، في شقيه النظري والتنظيمي، والغرض منها المساهمة المتواضعة في تسليط الضوء على بعض ضرائب المرور على هذه التجربة.
نحن لا نبخس حق أي متديّن في اعتناق أي مرجعية أيديولوجية، فهذا مقام من مقام حرية المعتقد، ولكن بخلاف السائد مع باقي الأيديولوجيات، المادية على الخصوص، عندما يتعلق الأمر بالأيديولوجية الإسلامية الحركية، فإننا نتحدث عن مرجعية تنهل من الدين، وبالتالي تنهل من المقدس، حيث يكاد يتماهى التديّن مع الدين، فيُصبح المتديّن في مرحلة الانفصال، ضحية مرحلة الانتماء، فيؤدي، شاء أم كره، بعضاً أو مجموعة ضرائب أو قل مضاعفات جانبية، على غرار المضاعفات الجانبية التي تطال تناول الأدوية، حيث نقرأ بالضرورة، في أي ورقة تعريفية مصاحبة للدواء المعني، وخاصة الأدوية الاصطناعية، أن هناك احتمالات قائمة، انطلاقاً من نتائج التجارب الطبية، أن تتسبب عملية تناول الدواء المعني، في ظهور مضاعفات ما، وقس على ذلك، ما نعاينه مع دواء سلوكي إسلامي، عنوانه الانفصال النهائي، النظري والتنظيمي معاً، عن المشروع الإسلامي الحركي، وقد أحصينا أربعة مضاعفات على الأقل كما أشرنا في مقالات سابقة، وهي مضاعفات نفسية وروحية وأخلاقية وعقلية، مع الإشارة إلى أنّ التفطن إلى هذه المعضلة لم يصدر من فراغ، وإنما جاء انطلاقاً من تأمل الحالة النفسية والسلوكية للعديد من الإسلاميين الذين انفصلوا بشكل نهائي عن المشروع المعني، وهذا ما تؤكده بالوقائع، وعلى سبيل المثال لا الحصر، تفاعلاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
الشاهد هنا أنّ هذا المتديّن لن يتحرّر نهائياً من آثار التجربة بين ليلة وضحاها؛ لأنّ المسألة تستغرق الكثير من الوقت، ما دامت تهم جهازه المفاهيمي. ليس هذا وحسب، وكما نعاين أيضاً على أرض الواقع، نلاحظ أنه كلما طالت مرحلة التجربة، كانت ضرائب مرحلة الانفصال أكبر، بمعنى آخر، الضرائب سالفة الذكر عند المتديّن الذي قضى بضعة أشهر أو بعض سنين مع المشروع، أقل نوعاً وكماً مقارنة مع الضرائب ذاتها عند متدين قضى بضعة عقود في المشروع.
بل إنّ هذه الظاهرة نعاينها حتى عند الذين كانوا من أتباع مشروع علمي ما، لهذا المفكر أو غيره، هنا في المنطقة أو في الخارج، ولكن عند مرحلة الفطام أو الانفصال أو أخذ مسافة من معالم المشروع، إما عن قناعة أو بسبب صدمات نفسية أو شيء من هذا القبيل، يمر هؤلاء فيما يُشبه مرحلة نقاهة فكرية، قد تطول هي الأخرى، بحسب حالة كل “مريد فكري”، وبالتالي، من باب أولى أن نعاين نفس المعضلة مع أتباع الإسلاموية، سواء كانت دعوية أو سياسية أو قتالية، خاصة أنّها تنهل من المقدس، وبالتالي من المفترض أن تكون المضاعفات سالفة الذكر أكبر وأعقد.
واضح أننا نتحدث هنا عن الذين أخذوا مسافة نهاية من المشروع، ولا نتحدث عن الذين يزعمون أنهم أخذوا مسافة، ولكنهم لا زالوا مع المشروع، إما لاعتبارات شخصية أو براغماتية أو أمنية أو غيرها، ولا نتحدث أيضاً عن الذين يوجدون في مقام وسط، لا هم داخل المشروع، ولا هم خارجه.
موضوع المضاعفات هذا ينطلق من فرضية، قد تكون صحيحة وقد لا تكون كذلك، ولذلك أوردنا مجموعة من الأسئلة التي نعتقد أنّها تساعدنا على الاقتراب من مقام الصحة والابتعاد بالتالي عن مقام الخطأ، والذي يبقى حاضراً في جميع الحالات، ولو بشكل نسبي، ولكن الشاهد هنا، أننا إزاء تصرفات وأحوال تطرح علامات استفهام عن أسباب هذا التحول في المواقف في مرحلة ما بعد الانفصال على المشروع، لذلك اصطلحنا على مُجمل هذه الأسباب المضاعفات أو الضرائب المركبة للمرور عبر التجربة الإسلامية الحركية.
وإذا صحت هذه الفرضية، وانطلاقاً من الاشتغال على الأسئلة أعلاه، كيف نفسر عدم انتباه المتديّن الإسلامي الحركي لهذه الظواهر؟ وهل وصل تأثير أدبيات المشروع على جهازه المفاهيمي، إلى درجة يعتقد معها أنه في غنى عن تأمل هذه الظاهرة؟
نعتقد أنّ البحث عن أجوبة وجيهة على هذه الأسئلة، يقتضي الكثير من التأمل والتفكر، وربما نجد بعض مقدمات أجوبة في اجتهادات بعض أعلام الساحة، لعل أحدها، تأثير ما كان يصطلح عليه الراحل محمد أركون بـ”السياج الدغمائي المغلق” حسب ترجمة هاشم صالح.
وإن كانت لأركون قراءات مغايرة للمقصود بالسياج الدغمائي المغلق، فالذي يهمنا هنا، في حالة قراءة ظاهرة الحركات الإسلامية، هو خلع هذا السياج على مُجمل أدبيات هذا المشروع، والتي تعود لعقود مضت، لأسماء مشرقية على الخصوص، ومن عدة مرجعيات، نذكر منها فتحي يكن وسعيد حوى وأبو الأعلى المودودي وسيد قطب ومحمد قطب ويوسف القرضاوي واللائحة تطول، وواضح أنّ الطفل أو المراهق أو الشاب الذي تربى على هذا الكم الكبير من المراجع الإسلامية، يصعب أن يتحرّر من آثارها المفاهيمية، بمجرد إعلانه أخذ مسافة من الأدبيات ومن المشروع، بل يلزمه الوقت الكثير حتى يبتعد عن بعض تطبيقات تلك الأدبيات، سواء تعلق الأمر بتوحيد الفكرة من خلال تأسيس حركات وجماعات إسلامية، أو كان مرتبطاً بالتفاعل مع الواقع (العائلة، المجتمع، الدولة، العالم، الإنسان)، انطلاقاً من الأعين الدينية شبه الضيقة لهذه الأدبيات وغيرها.
نقلآ عن حفريات