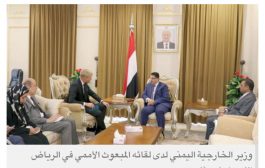محمد الصياد
عند التقصي الشديد لوقائع حرق الكتب في التراث الإسلامي؛ نجد أن أغلبية حوادث هذه الظاهرة المُستهجَنة تعود إلى فعل السلطة وغوائل السياسة، فكل سلطة مستبدة نلاقي عندها نزوعا ضد المعرفة وما تستتبعه من حرية تفكير وتنوير، ويجلّي العلامة عبد الرحمن الكواكبيّ (ت 1320هـ/1902م) ذلك المعنى -في كتابه ‘طبائع الاستبداد‘- بقوله: “فكما أنه ليس من صالح الوصيّ أن يبلغ الأيتامُ رشدَهم، كذلك ليس من غرض المستبد أن تتنور الرعيةُ بالعلم؛ [فـ]ـلا يخفى على المستبد -مهما كان غبيا- أنْ لا استعبادَ ولا اعتسافَ إلا ما دامت الرعية حمقاءَ تَخبط في ظلامةِ جهلٍ وتِيهِ عَمَاءٍ”!!
لقد كان بعض السلطات يتوهم أنه بتلك الأفعال يقوم بعمل تنويري، وذلك بمحاربة المعتقدات الدخيلة تعزيزا لشرعية النظام في أوساط العامة وتقوية لبنيان الجماعة السياسية حولها، وهي تلك الكتب التي كانت تخالف العقيدة القويمة مثل تصانيف التنجيم وما كان يرتبط بها من سحر وطلاسم، فضلا عن بعض الكتب الفقهية والسلوكية التي قد تصفها سلطة ما -في لحظة ما- بأنها قد تفتّت لحمة المجتمع.
ومما يؤكد غلبة العامل السياسي هنا أن تلك المحارق الهوجاء -وحرق أي كتاب هو تأكيدا فعلٌ أهوجُ فالرأي يقارع بالرأي- غالبا ما كانت تحصل في بدايات تأسيس الدول، وأثناء الصراعات بين الأنظمة، وحينما تكون الدول على خطوط النار أو على تماس مع أعدائها، حيث تتلاشى الفواصل بين الاختراق الثقافي واختراق الحدود.
وهكذا نجد أنه على قدر ما كانت تتصف به الدول الإسلامية عموما من رحابة وسمعة طيبة في الحوار المعرفي والإنتاج العلمي؛ نرى تلك الحساسية الشديدة أمام بعض المؤلفات الجديدة والأفكار المختلفة. ومن الغريب حقا أن الأندلس -على ما اشتهرت به من تميز أدبي ومعرفي- كانت من المراكز شديدة التوتر والحساسية تجاه بعض هذه الأفكار، بل إن الموقف الديني من بعض الكتب (فقها وتصوفا وفلسفة) لم يكن ينفصل -أحيانا كثيرة- عن التوظيف السياسي.
لكن المؤرخين المسلمين حاولوا -أثناء رصدهم لتلك الظاهرة- الإشارة إلى سياق تاريخي لها لم تخلُ فيه الأمم السابقة من تلك الوقائع؛ ففي أيام الإغريق مثلا كانت الكتب تُحرق بإشراف كبار الفلاسفة، فالمؤرخ ابن أبي أصَيْبعة (ت 668هـ/1269م) -في ‘عيون الأنباء‘- يذكر أن “أفلاطون (ت 347ق.م) أحرق الكتب التي ألفها [الفيلسوف] ثاسلس (= طاليس الملطي ت نحو 546ق.م) وأصحابه، ومن انتحل رأيا واحدا من [القائلين بـ]ـالتجربة والقياس، وترك الكتب القديمة التي فيها الرأيان جميعا”، لأنه كان يقول بـ”الرأيين جمعيا” وعدم صحة الأخذ بالقياس وحده أو التجربة بمفردها.
ونجد عند ابن أبي أصيبعة أيضا أن جالينوس (ت 210م) كان معارضا لرأي فلاسفة الأطباء -وقد كان الطبّ عندئذ جزءا من الفلسفة- الذين يقولون إنه “لا صناعة غير صناعة الحِيَل وهي صناعة الطب الصحيحة”، فكان ينتقد كتبهم المؤلفة في مذهبهم هذا حتى إنه “أحرق ما وجد منها وأبطل هذه الصناعة الحيلية”.
ولكن يظل من المشاهد العجيبة -التي انطوت عليها تلك الظاهرة- مشهد قيام بعض العلماء والمفكرين المسلمين طوعا بحرق كتبهم أو إهلاكها بأي طريقة كانت (تحريقا أو تغريقا أو تمزيقا)!! ومكمن العجب هنا هو أن يقوم الكاتب بإتلاف ما سطّرته يداه من معارف طوال أزمان وبجهد ومعاناة، ربما للحساسية المفرطة من عدم تقدير المجتمع، أو لتحوّل في مناهج الفكر وطُرُق الوصول إلى المعرفة أو حفظها بأمانة، أو مخافة إثارة شبهات قد لا يتفهمها القارئ العادي!!
وعلى أي حال؛ فقد ظلت تلك العتمات -التي نقف في هذا المقال على أبرز وقائعها ودوافعها- مسحةَ ظُلمةٍ ضئيلةً ومعزولة، لم تؤثر على طاقة النور التي بثّتها الحضارة الإسلامية في أرجائها وفي أنحاء العالم، ناشرةً عبرها تراثها العلمي والثقافي والفني، وميراث الأمم السابقة عليها بعد أن رعته ونقّحته شرحته وكمّلته، وظلت الثمارُ المعرفية لذلك كله تغذّي العقل الإنساني -وخاصة الغربي منه- إلى اللحظة الراهنة.
تأصيل وتعليل
إن أول ما يُمكن أن يجلب الانتباه بشأن ظاهرة حرق الكتب والمكتبات هو أنها تعدّ -منذ القدم وحتى الآن- أحد أساليب القمع والسيطرة التي تستخدمها السلطة السياسية المستبدة ضد خصومها ومعارضيها؛ فالحكومات المستبدة لا تحبّ العلوم ولا استنارة الناس بالمعارف، فلذا تخشاها وتعمل جاهدة على حجب الأفكار، بالقدر الذي يعمل به المصلحون على إنتاجها ونشرها!
ومن أقدم النصوص التي تؤسس لموقف السلطة المستبدة المناهض -أحيانا كثيرة- للعلوم والمعارف؛ ما جاء في وثيقة ‘عهد أَرْدَشِيرْ‘ المنسوب إلى مؤسس الدولة الساسانية الفارسية أَرْدَشِيرْ بن بابَك (ت 242م)؛ إذْ “نصح” من يأتون بعده من الملوك بألا يبالوا بتخريب عقول شعوبهم حتى يضمنوا بقاء مُلكهم! وفي ذلك يقول: “وقد كان مَنْ قبلنا مِن الملوك يحتالون لعقول مَنْ يَحْذرون (= معارضيهم) بتخريبها! فإنّ العاقلَ لا تنفعه جودةُ نحيزتِه (= طبعه) إذا صُيّر عقله خرابا مواتاً”!!
ويجلّي العلامة عبد الرحمن الكواكبيّ (ت 1320هـ/1902م) ذلك المعنى -في كتابه ‘طبائع الاستبداد‘- بقوله: “فكما أنه ليس من صالح الوصيّ أن يبلغ الأيتام رشدهم، كذلك ليس من غرض المستبد أن تتنور الرعيةُ بالعلم؛ [فـ]ـلا يخفى على المستبد -مهما كان غبيا- أنْ لا استعبادَ ولا اعتسافَ إلا ما دامت الرعية حمقاءَ تَخبط في ظلامةِ جهلٍ وتِيهِ عَمَاءٍ”.
وعندما تُقدم الحكومةُ على إحراق كتب أحد العلماء، كلها أو بعضها، فقها أو تصوفا أو فلسفة؛ فإنها تردّ ذلك غالبا إلى ما تزعمه من رعاية للمصلحة العامة وما يخدم الناس على صعيد “جبهة الوعي” و”الأمن الفكري” المؤمِّن لبقاء العروش، وهو في حقيقته قد لا يعدو اعتراضا على موضوعات أو منهجيات كتب معينة ربما تتباين مع الدعاية الرسمية للبلاط.
ومن أقدم ما جاءنا من نماذج إقدام السلطة السياسية على إحراق كتب المخالفين لرؤيتها الدينية والحضارية في الحقب السابقة على الإسلام؛ ما ذكره المؤرخ الطبيب ابن أبي أصَيْبعة (ت 668هـ/1269م) -في ‘عيون الأنباء‘- من أن “الإسكندر (المقدوني ت 323ق.م) لما تملّك مملكة دارا واحتوى على فارس أحرق كتب دين المجوسية، وعمد إلى كتب النجوم والطبّ والفلسفة فنقلها إلى اللسان اليوناني، وأنفذها إلى بلاده وأحرق أصولها”.
أما أقدم ما سجله التاريخ الإسلامي من حرق السلطات للكتب اعتراضا على مضمونها المخالف لدعايتها الرسمية؛ فهو صنيع سليمان بن عبد الملك (ت 99هـ/719م) -عندما كان وليا للعهد- بكتاب في السيرة النبوية ألّفه -بتكليف منه- قاضي المدينة النبوية أَبَانُ بن عثمان بن عفان (ت نحو 105هـ/724م)، لكن سليمان لم يعجبه ما ورد في الكتاب من ذكر لمناقب قبائل الأنصار “فأمر بذلك الكتاب فحُرق”؛ وفقا للمؤرخ النسابة الزبير بن بكار (ت 256هـ/870م) في كتابه ‘الأخبار الموفقيات‘.
وقد لاقى صنيع سليمان هذا إعجابا من والده الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (ت 86هـ/706م) الذي أثنى على قراره بحرق الكتاب، وبرّر ذلك بأنه يخدم مصلحة رعاياهم من أهل الشام؛ فقال: وما حاجتك أن تَقدم [إلى الشام] بكتاب ليس لنا فيه فضل؟ تعرِّف أهلَ الشام أمورا لا نريد أن يعرفوها” من فضائل الأنصار!!
والسياق السياسي لتلك المخاوف يتمثل في كون ثورة أهل المدينة على الأمويين في وقعة الحرة سنة 63هـ/م كانت حينها لا تزال طرية في أذهان الناس، وكان أهل الشام هم رأس حربة الأمويين في سحق الثوار الذين كانوا في معظمهم من الأنصار؛ فكيف يقدم إليهم كتاب يروي فضائلهم وهم كانوا بالأمس القريب هدفا للدعاية الرسمية المشيطنة لهم؟
ذرائع منوعة
وكثيرا ما تذرعت السلطة في كبتها للآراء بكون صاحبها مبتدعاً أو زنديقاً ملحداً، ونحو ذلك من الدعاوى التي ترمي بها إلى تسويغ فعلتها في أعين النخبة والرأي العام المسلم. وهو ما نجد أيضا أصل توظيفه رسميا عند الملك الفارسي أردشير؛ إذْ يقول: “وكانوا يحتالون للطاعنين بالدين على الملوكِ فيسمونهم المبتدِعين، فيكون الدين هو الذي يقتلهم ويُريح الملوكَ منهم، ولا ينبغي للمَلك أن يعترف للعُبّاد والنُّسّاك والمتبتلّين بأن يكونوا أوْلى بالدين ولا أحدب عليه ولا أغضب له منه”!!
والظاهر أن المهدي العباسي (ت 169هـ/787م) كان أول من حاول تأسيس شرعيته في الحكم على قضية التصدي لما كان يسمى “الزنادقة”، حتى إن الإمام الذهبي (ت 748هـ/1347م) يقول عنه -في ‘تاريخ الإسلام‘- إنه “بالغ في إتلاف الزنادقة وأحرق كتبهم لمّا أظهروا المعتقدات الفاسدة”.
ومن هذا النوع أيضا ما حكاه المؤرخون عن مصير جزء كبير من المكتبة الضخمة التي كانت في أيام الخليفة الأموي بالأندلس الحكم المستنصر (ت 366هـ/977م)، وكانت تُدعى “خزانة العلوم والكتب”؛ وفقا للمقّري التلمساني (ت 1041هـ/1631م) في ‘نفح الطِّيب‘.
فقد ذكر المقّري أن المستنصر هذا “كان محبًّا للعلوم مكرِما لأهلها، جمّاعا للكتب في أنواعها بما لم يجمعه أحد من الملوك قبله”!! ثم أضاف أن “عدد [سجلات] الفهارس التي فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة، وفي كل فهرسة عشرون ورقة، ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين (= المصنَّفات) لا غير”!!
وعن مصير القسم الفلسفي من ذخائر هذه المكتبة العظيمة؛ يحدثنا الذهبي -في ‘سير أعلامِ النبلاء‘- أنه بعد وفاة الحَكَم تولى الوزارة المنصور ابن أبي عامر (ت 393هـ/1004م)، الذي صار “حاجب الممالك الأندلسية” وسيد القصر الأموي بقرطبة؛ “فعمد -أولَ تغلُّبه- إلى خزائن كتب الحَكَم، فأبرز ما فيها -بمحضر من العلماء- وأمر بإفراز ما فيها من «تصانيف الأوائل» والفلاسفة حاشا كتب الطب والحساب (= الهندسة)، وأمر بإحراقها فأحرِقت وطُمِر (= دُفِن) بعضُها؛ ففعل ذلك تَحَبُّباً إلى العوام، وتقبيحاً لمذهب الحكم” في اقتناء أمثال هذه الكتب الفلسفية التي وصفها الذهبي بأنها “كانت كثيرة إلى الغاية”!!
وعبارة “أولَ تغلُّبه” -الواردة في النص أعلاه- تلقي لنا ضوءا مهمّا على الهدف السياسي الذي كان في ذهن هذا الوزير الداهية؛ فقد كان حينها لا يزال في صراع مع منافسيه من رجال الدولة الأقوياء على الإمساك بزمام الأمور في البلاد إثر وفاة الخليفة المستنصر، من أمثال الوزير الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي (ت 372هـ/983م) وقائد الجيش غالب بن عبد الرحمن الأموي (ت 371هـ/982م).
وقد استعان المنصور لتحقيق هدفه السياسي بجماعة الفقهاء النافذين أيامها، وبتحالفه مع زوجة الخليفة الراحل واسمها صُبْح البَشْكُنْشية (ت نحو 390هـ/1000م وتنسب إلى بلاد البَشْكُنْش/البَشْكُنْس = اليوم إقليم الباسك الإسباني)، التي اعتلى ابنها الصبي الأمير هشام بن الحَكم (ت 403هـ/1013م) العرش، لكنه ظل تحت وصاية الوزير القوي المنصور العامري.
ومما يؤكد ما ذكره الذهبي من حضور للانتهازية السياسية وراء فعلة الحاجب المنصور هو كونه شخصيا محبًّا للفلسفة؛ طبقا لما يفيدنا به المقّري -في ‘نفح الطِّيب‘- الذي يقول إن أهل الأندلس “كلُّ العلوم لها عندهم حظٌّ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم، فإن لهما حظا عظيما عند خواصهم ولا يُتظاهَر بهما خوف العامة، فإنه كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه العامة اسم ‘زنديق‘ وقيدت عليه أنفاسَه..، وكثيرا ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وُجدت، وبذلك تقرب المنصور بن أبي عامر لقلوبهم أولَ نهوضه [بالإمارة]، وإن كان [هو] غير خالٍ من الاشتغال بذلك (= علوم الفلسفة) في الباطن”!!
تمييز لافت
لقد فرضت كتب العلوم البحتة (الطب والهندسة) احترامها على حارقي الكتب باعتبارها واضحة النفع للجميع، رغم صلتها الوثيقة أيامها بالفلسفة؛ ولكن يبدو أن الدراسات الفلسفية المحضة صارت -تقريبا منذ أواخر القرن الرابع الهجري/الـ10 الميلادي- مستهجنة على نطاق واسع، بحيث عمل السلاطين على تعزيز شرعيتهم بحرقها تقربا إلى الجماهير والنافذين من العلماء المعارضين لها؛ كما رأينا فيما فعله الوزير و”المثقف المستنير” المنصور العامري بالأندلس، وأيضا في ظل حكم نظيره في الثقافة والكاريزما السياسية بالمشرق الإسلامي الوزير البويهي الصاحب ابن عبّاد (ت 385هـ/996م).
فالمؤرخ ياقوت الحموي (ت 626هـ/1229م) يروي -في ‘معجم الأدباء‘- عن عليّ بن الحسن الكاتب (ت بعد 370هـ/981م) قوله عن علاقته بالوزير ابن عبّاد هذا: “فلم أَرَ.. [منه] إلا الخير حتى عراه مَلَلٌ آخرُ [مني] فوضعني في الحبس سنة، وجمع كتبي فأحرقها بالنار وفيها.. مصاحف القرآن وأصول كثيرة في الفقه والكلام، فلم يميّزها من «كُتُب الأوائل» (= كتب الفلسفة والتنجيم)، وأمر بطرح النار فيها من غير تثبّت بل لفرط جهله وشدة نزقه”!!
وقوله “فلم يميّزها من «كُتُب الأوائل»” إشارة منه إلى سبب الحرق الحقيقي، فابن عباد إنما أراد حرق كتب الفلسفة تحديدا! ويؤكد ذلك ما جاء في وصفه عند أبي حيان التوحيدي (ت بعد 400هـ/1010م) الذي يقول عنه في ‘الإمتاع والمؤانسة‘: “والغالب عليه كلام المتكلمين المعتزلة، وكتابته مهجّنة بطرائقهم، ومناظرته مشوبة بعبارة الكُتّاب، وهو شديد التعصّب (= التحامل) على أهل الحكمة (= الفلسفة) والناظرين في أجزائها، كالهندسة والطبّ والتنجم والموسيقى والمنطق والعدد”.
وغير بعيد من عصر ابن أبي عامر وابن عبّاد اللذين كانا من فئة الأمراء العلماء؛ نجد المؤرخ ابن الأثير (ت 630هـ/1233م) يذكر -في كتابه ‘الكامل‘- أن مؤسس الدولة الغزنوية محمود بن سُبُكْتِكِيْن الغزنوي (ت 421هـ/1031م) أطاح سنة 420هـ/1030م بالدولة البويهية في خراسان، ثم “أحرق كتب الفلسفة ومذاهب الاعتزال والنجوم” التي كانت كثيرة في مكتبات ملوكها!
والسياق السياسي لهذه المحرقة يحيل إلى الصراع الفكري المستقوي دائما بوسائل السلطة القائمة، والمتواصل منذ أيام الخليفة المأمون العباسي (ت 218هـ/833م) بين “أهل الحديث” الذين كان محمود الغزنوي يتقرب إليهم بالنصرة والتأييد، وتيار المعتزلة الذي يتبنى خصوم الغزنوي البويهيون آراءه باعتباره امتدادا عقديا لمذهبهم الشيعي الزيدي.
منعطف تاريخي
ثم اشتدت النزعة المستهجنة للفلسفة وخاصة في نهاية القرن الخامس الهجري/الـ11 الميلادي، ولعل مما ساهم في ترسيخ ذلك الاستهجان الهجومَ الذي شنه أيامها الإمام الغزالي (ت 505هـ/1111م) على الفلاسفة في كتابه ‘تهافت الفلاسفة‘، ولم ينفع في تخفيف آثاره ما قدمه لاحقا الإمام أبو الوليد ابن رشد الحفيد (ت 595هـ/1199م) للفلسفة من دفاع وإسناد في كتابيْه: ‘تهافت التهافت‘ و‘فصل المقال‘.
بل إن ابن رشد نفسه نالته محنة عظيمة -أواخر القرن التالي- أيام سلطان الدولة الموحدية المنصور أبي يوسف يعقوب بن يوسف (ت 595هـ/1199م)، رغم أنه كان طبيبه الخاص وبالتالي من أقرب الناس إليه؛ إذ يخبرنا الذهبي -في ‘السِّيَر‘- بأنه “سعى فيه من يناوئه عند يعقوب، فأَرَوْه [كلاما] بخطه حاكيا عن الفلاسفة أن [كوكب] الزهرة أحد الآلهة، فطلبه، فقال: أهذا خطك؟ فأنكر، فقال: لعن الله مَنْ كتبه، وأمر الحاضرين بلعنه، ثم أقامه مُهاناً، وأحرق كتب الفلسفة سوى الطب والهندسة”!!
ويصرّح ابن أبي أصيبعة بأن سبب محنة ابن رشد يعود إلى انشغاله بعلوم الفلسفة؛ فقال إن المنصور “نَقِمَ على أبي الوليد بن رشد.. ونقم أيضا على جماعة أُخَر من الفضلاء الأعيان.. وأظهر أنه فعل بهم ذلك بسبب ما يُدَّعَى فيهم [من] أنهم مشتغلون بالحكمة (= الفلسفة) و«علوم الأوائل»”! ومما ينصر ذلك التعليلَ ما نقله أبو حيان الأندلسي (ت 745هـ/1344م) -في ‘البحر المحيط في التفسير‘- من قول أحد الشعراء “يُغْري منصورَ الموحدين بأهل الفلسفة من قصيدة:
وحرِّقْ كُتْبَهم شرقا وغربا ** ففيها كامِــنٌ شَرُّ العلومِ
يدبّ إلى العقائد من أذاها ** سمومٌ والعقائدُ كالجسومِ”!
وقريبا من زمان تلك الحادثة؛ نلاقي في ترجمة الإمام الآمدي (ت 631هـ/1234م) أنه كان يدرّس الفلسفة والمنطق في الجامع الظافري بالقاهرة ثم إنه رُمي بالانحلال العقدي، حتى إن قاضي القضاة المؤرخ ابن خلّكان (ت 681هـ/1282م) يقول -في ‘وفيات الأعيان‘- إن الفقهاء “وضعوا خطوطهم بما يستباح به الدم [منه]، فخرج [من مصر] مستخفياً ونزل حماة” في الشام.
وربما ذهبت الكتب العلمية ضحية لتصفية السلطة حساباتها مع من لا ترضى عن سلوكهم من كبار الموظفين، أو العلماء المنتقدين لها؛ ومن نماذج ذلك ما وقع ببغداد لقاضي القضاة يحيى بن سعيد ابن المرخّم (ت 555هـ/1164م) الذي كان متهما بالفساد وبأنه “آخذ الرشى”؛ طبقا لابن الجوزي (ت 597هـ/1201م) في ‘المنتظم‘.
ولذلك فإنه صدر قرر باعتقال القاضي ابن المرخّم هذا “واستُصفيت (= صودرت) أموالُه..، وأحرِقت كتبه في الرحبة (= ميدان عام ببغداد) وكان منها كتاب ‘الشفاء‘ [لابن سينا (ت 428هـ/1038م)] و‘إخوان الصفاء‘، وحُبس فمات في الحبس”.
سياق أممي
ويحدثنا المؤرخ ابن خلدون الحضرمي (ت 808هـ/1406م) -في تاريخه- عن أن سلطان الدولة الحفصية في تونس محمد المستنصر (ت 675هـ/1276م) كان ناقما على الإمام الأندلسي محمد بن عبد الله المعروف بابن الأبّار القضاعي (ت 658هـ/1260م)؛ فـ”بعث السلطان إلى داره فرُفعتْ إليه كتبه أجمع، وألْفَى (= وجد) أثناءها -فيما زعموا- رقعةَ بأبياتٍ أولُها:
طغى بتونسَ خَلْفٌ ** سمَّوْهُ ظُلماً: ‘خليفة‘!!
فاستشاط (= غضِب) لها السلطان وأمر بامتحانه ثم بقتله، [فقُتل] قَعْصاً (= طعناً) بالرماح وسط محرم من سنة ثمان وخمسين وستمئة (658هـ/1260م)، ثم أحرِق شِلْوُهُ (= أعضاؤه)، وسيقت مجلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوينه فأحرِقت معه”!!
وعلى كلٍّ؛ فإذا كانت كتب الفلسفة نالتها محارق في بعض عصور التاريخ الإسلامي فإنّ ذلك لم يكن أمرا مبتدعا، وإنما هو تقليد أممي شاع منذ أيام كبار الفلاسفة اليونانيين الذين مارسوه بأنفسهم؛ ولذلك فهي وقائع تكررت في سياق طبيعة تلك العصور والبيئات والثقافات، ولا تعبر بالضرورة عن ضيق أفق يمكن تعميمه على حضارة معينة أو حقبة محددة.
فقد قال مؤرخ الحضارات الأميركي ويل ديورانت (ت 1402هـ/1981م) -في ‘قصة الحضارة‘- إن زعيم المذهب السوفسطائي الفيلسوف اليوناني بروتاغوراس (ت 420ق.م) حين أعلن أفكاره البسيطة القاضية بأن “الحقيقة كلها والخير والجمال أمورٌ نسبية وشخصية”؛ ارتاعت منها “الجمعية الأثينية” التي كانت تُعدّ الهيئة التشريعية المنتخبة لحكم مدينة أثينا، ورأت أنها “تُنْذر بشرٍّ مستطير، فقررت نفي بروتاغوراس، وأُمِرَ الأثينيون.. أن يسلموا كل ما عساه أن يكون لديهم من كتاباته، وأحرقت كتبه في السوق العامة”!!
وذكر ابن أبي أصيبعة -في ‘عيون الأنباء‘- أن “أفلاطون (ت 347ق.م) أحرق الكتب التي ألفها [الفيلسوف] ثاسلس (= طاليس الملطي ت نحو 546ق.م) وأصحابه، ومن انتحل رأيا واحدا من [القائلين بـ]ـالتجربة والقياس، وترك الكتب القديمة التي فيها الرأيان جميعا”، لأنه كان يقول بـ”الرأيين جمعيا” وعدم صحة الأخذ بالقياس وحده أو التجربة بمفردها.
فأفلاطون حرق كتب خصومه في الرأي من الفلاسفة رغم أنه من مؤسسي علم الفلسفة، مما يدل على أنّ حرق الكتب في زمانهم لم يكن يعطي نفس الانطباع الذي يعطيه اليوم، بل ربما كان يُراد به الاعتراض على رأي الخصم لا إفناء مقولته كليا بحرق كتبه، أو يراد به التشنيع على المقولة باعتبارها ساقطة واهية.
ونجد عند ابن أبي أصيبعة أيضا أن جالينوس (ت 210م) كان معارضا لرأي فلاسفة الأطباء -وقد كان الطبّ عندئذ جزءا من الفلسفة- الذين يقولون إنه “لا صناعة غير صناعة الحِيَل وهي صناعة الطب الصحيحة”، فكان ينتقد كتبهم المؤلفة في مذهبهم هذا حتى إنه “أحرق ما وجد منها وأبطل هذه الصناعة الحيلية”.
بل إن اليونانيين تجاوزوا حرق ما لا يرضيهم من كتب الفلسفة والطب إلى حرق دواوين الشعر؛ فهذا المؤرخ ابن العبري (ت 685هـ/1286م) يحكي -في ‘تاريخ مختصر الدول‘- أن الفيلسوف أفلاطون “تميز -في حداثته- في علم الشعر، فلما رأى [أستاذَه] سقراط (ت 399ق.م) يهجِّن (= يعيب) هذا الفن -من جملة العلوم- أحرق كتبه الشعرية”!!
رفضٌ مُغرضٌ
وعلى غرار كتب الفلسفة، وربما لالتصاقها بها في العموم آنذاك؛ مدّ السلاطين المسلمون عسْفَهم إلى كتب التنجيم كما نجد في واقعة حدثت لحفيد مؤسس الطريقة القادرية الصوفية، وهو عبد السلام بن عبد الوهاب ابن الشيخ عبد القادر الجيلي (ت 611هـ/1214م) الذي جاء في ترجمته عند الإمام ابن حجر العسقلاني (ت 852هـ/1448م) -في ‘لسان الميزان‘- أنه “كان مذموم السيرة منجِّما يَدخل في فلسفة الأوائل، فأحرِقت كتبه علانية ببغداد”.
ويقول الذهبي -في ‘تاريخ الإسلام‘- إن عبد السلام هذا “أهِينَ.. بإحراق كتبه النجومية” سنة 588هـ/1192م، وأن ذلك الإحراق كان “في محفل، وكان فيها (= الكتب المحروقة) أن لا مدَبِّرَ للعالم سوى الكواكب وأنها هي الرزَّاقة”!!
ويضيف الذهبي -في ‘السِّيَر‘- أن حرق هذه الكتب تمَّ “بإشارة [من الإمام] ابن الجوزي” لأنه كان “لا ينصف الشيخ عبد القادر [الجيلي] ويغضّ من قدره فأبغضه أولادُه”، وهو ما عرّض ابنَ الجوزي لاحقا لنكبة كبيرة دامت خمس سنين، وذلك حين وصل إلى بلاط الخليفة العباسي ببغداد وزيرٌ مقرَّب من آل عبد القادر الجيلي، فانتقم لهم منه حيث “أحرِقت بعض كتب ابن الجوزي وخُتِم [بالمنع] على بقيتها”؛ طبقا للإمام ابن كثير (ت 774هـ/1372م) في ‘البداية والنهاية‘.
والخلاصة أن غاية المقصد من تلك الوقائع -على مأساويتها- إنما هو الرفض: رفض الخصم أو رفض فكرته، وهو ما يشير إلى نمط الثقافة السائدة حينئذ والتي لا تتعذر محاكمتها بمعايير ثقافة عصرنا اليوم، رغم أنه ما زالت تتكرر فيه -وبصور شتى- ثقافة القتل المعنوي والمادي لخصوم السلطة الفكريين والسياسيين، أو معارضيها من العلماء الناقمين على منهجها في الحكم والتسيير.
لم تقتصر ملاحقة السلطة للمصنفات على ما كانوا يسمونه “كتب الأوائل” من فلسفة وتنجيم ونحوهما؛ بل إن التأليب المذهبي من بعض العلماء أدى إلى حرق كتب زملاء لهم يختلفون معهم في المذهب العلمي والمشرب الفكري، أو حتى في الطرح والاجتهاد داخل المذهب الواحد نفسه.
ولكننا نجد غالبا حضورا للسلطة في تلك الأحداث حين يستغل رجال الدولة تلك المماحكات الطبيعية في الأوساط العلمية فيوظفونها لأهدافهم السياسية، خاصة إذا استعان بهم أحد أطراف الخلاف العلمي لتعزيز موقفه أو مذهبه؛ كما رأينا في قصة علاقة ابن الجوزي بحرق كتب عبد السلام الجيلي. بل ربما قادت آفة التعصب المذهبي أحد السلاطين إلى الأمر بحرق كتب مذهب فقهي بأكمله لأنه مخالف لانتمائه!!
أزمة “الإحياء”
ومن الوقائع المسجلة في ذلك ما حصل أيام سلطان دولة المرابطين بالأندلس والغرب الإسلامي علي بن تاشفين (ت 538هـ/1143م)، الذي وصفه الذهبي -في ‘السِّيَر‘- بأنه “كان معظِّما للعلماء مشاورا لهم، نَفَقَ (= راجَ) في زمانه الفقه والكتب والفروع حتى تكاسلوا عن الحديث والآثار، وأُهِينت الفلسفة ومُجَّ [علم] الكلام ومُقِتَ”.
وكان من آثار تلك الشيطنة للعلوم الكلامية والفلسفية أنْ “دان أهلُ ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخوض في شيء من علوم الكلام، وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين [عليّ بن تاشفين] تقبيحَ علم الكلام، وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه شيء منه، وأنه بدعة في الدين وربما أدى أكثره إلى اختلاف في العقائد”؛ وفقا لرواية عبد الواحد المراكشي (ت 647هـ/1249م) في ‘المُعجِب في تلخيص أخبار المغرب‘.
ويضيف المراكشي أنه في تلك الأجواء العدائية لمباحث الكلام والفلسفة؛ تبنى الأمير علي بن تاشفين مواقف الفقهاء المناهضة لكل ما يخالف المذهب الفقهي الرسمي للبلاد وهو المذهب المالكي، بعد أن “استحكم في نفسه (= الأمير) بغض علم الكلام وأهله، فكان يُكتب عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ الخوض في شيء منه، وتوعّد من وُجد عنده شيء من كتبه. ولما دخلت كتب أبي حامد الغزالي -رحمه الله- المغربَ أمَرَ أميرُ المسلمين بإحراقها، وتقدم بالوعيد الشديد -من سفك الدم واستئصال المال- إلى من وُجد عنده شيء منها؛ واشتد الأمر في ذلك”!
ويبدو أن مفعول القرار الرسمي بحرق كتب الغزالي -وإن كان الحرق الفعلي اقتصر على كتابه ‘إحياء علوم الدين‘- امتد قرابة أربعين سنة، هي مدة حكم الأمير علي بن تاشفين الذي تسلم السلطة سنة 500هـ/1106م؛ فالإمام الذهبي يخبرنا -في ‘السِّيَر‘- عما يبدو أنها حادثة الحرق الأولى لهذا الكتاب، فيقول إنّه في نفس السنة “وصل الخبر [إلى الإسكندرية] بإحراق كتب الغزالي في المَرِيَّة” بالأندلس.
وقد حُرِّقت نسخ الكتاب في عموم البلاد الأندلسية بإشراف من “قاضي الجماعة” (قاضي القضاة) المالكي محمد بن علي ابن حمدين التغلبي (ت 508هـ/1114م)، الذي وصفه الذهبي بأنه “كان يحطُّ (= ينتقد) على الإمام أبي حامد في طريقة التصوف، وألَّف في الرد عليه”.
وفي سنة 538هـ/1147م أصدر هذا الأمير أحد مراسيمه الأخيرة في حياته، فكان مما جاء فيه: “ومتى عثرتم على كتاب بدعة أو صاحب بدعة فإياكم وإياه، وخاصة -وفقكم الله- كتب أبي حامد الغزالي، فليُتَتَبَّعْ أثرُها وليُقطع بالحرق المتتابعِ خبرُها، ويُبحث عليها وتغلظ الإيمان [على] من يُتّهم بكتمانها”!! حسب نص وثيقة القرار التي أوردها المؤرخ المتخصص في تاريخ الأندلس محمد عبد الله عنان (ت 1407هـ/1986م) في كتابه ‘دولة الإسلام في الأندلس‘، نقلا عن مخطوطتها بمكتبة الإسكوريال الإسبانية.
رؤية ثنائية
ويفهم من كلام للقاضي عياض المالكي (ت 544هـ/1149م) أن المضمون الصوفي العميق لكتاب ‘الإحياء‘ كان الدافع الرئيسي وراء حرقه؛ فهو يقول حسبما ينقله عنه الذهبي في ‘السِّيَر‘: “الشيخ أبو حامد [الغزالي] -ذو الأنباء الشنيعة والتصانيف العظيمة- غلا في طريقة التصوف وتجرد لنصر مذهبهم، وصار داعية في ذلك وألَّف فيه تواليفه المشهورة، أُخِذ عليه فيها مواضع، وساءت به ظنون أمة، والله أعلم بسره. ونفذ أمرُ السلطان عندنا بالمغرب وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها، فامتُثِل ذلك”.
ويؤكد الفيلسوف والطبيب أبو الحجّاج ابن طُمْلُوس الأندلسي (ت 620هـ/1223م) -في ‘المدخل لصناعة المنطق‘- ما ذهب إليه القاضي عياض بشأن مركزية العامل الصوفي في حرق كتاب ‘الإحياء‘، مشيرا إلى أن فقهاء الأندلس من المالكية فوجئوا بـ”كتب أبي حامد الغزالي [الـ]ـمتفننة، فقرعت أسماعهم بأشياء لم يألفوها ولا عرفوها، وكلام خرج به عن معتادهم من مسائل الصوفية وغيرهم من سائر الطوائف الذين لم يعتد أهل الأندلس مناظرتهم ولا محاورتهم، فبعدت عن قبوله أذهانهم، ونفرت عنه نفوسهم وقالوا: إن كان في الدنيا كفر وزندقة فهذا الذي في كتب الغزالي هو الكفر والزندقة! وأجمعوا على ذلك..، فأحرِقت كتب الغزالي وهم لا يعرفون ما فيها”!!
ثم يلاحظ ابن طُمْلُوس -وهو كبير تلامذة الفيلسوف ابن رشد- الانقلابَ التاريخي -بالأندلس والغرب الإسلامي عموما- تجاه كتب الغزالي بعد سنوات قليلة من حرقها، ودور العامل المذهبي/السياسي في هذا التحول الكبير، وذلك حين أطيح سنة 541هـ/1146م بالدولة المرابطية على أيدي الموحدين الذين يَعدّون الغزالي شيخا لمؤسس دعوتهم الدينية محمد بن تُومَرْتْ (ت 525هـ/1131م).
ولذا فإنه ما أن استقرت الأمور للموحدين حتى “نُدِب الناس إلى قراءة كتب الغزالي رحمه الله، وعُرف من مذهبه (= ابن تُومَرْتْ) أنه يوافقه (= الغزالي)؛ فأخذ الناس في قراءتها، وأعجبوا بها وبما رأوا فيها من جودة النظام والترتيب الذي لم يروا مثله قط في تأليف، ولم يبق في هذه الجهات من لم يغلب عليه حب كتب الغزالي إلا من غلب عليه إفراط الجمود من غلاة المقلدين، فصارت قراءتها شرعا ودينا بعد أن كانت كفرا وزندقة”!!
على أن الإنصاف المنهجي في عرض الوقائع يقتضي منا الإشارة إلى أن فقهاء المالكية بالأندلس لم يكونوا متفقين على موقف السلطة المناهض لكتب الغزالي؛ فقد عارضت ذلك -منذ اللحظة الأولى لقرار الحرق- جماعة منهم يتقدمهم الإمام علي بن محمد بن عبد الله الجُذَامي البَرْجي (ت 509هـ/1115م)، وأصدروا فتوى مشتركة توجب “تأديب محرقها وتضمينه قيمتها لأنها مالُ مسلمٍ”؛ وفقا لابن الأبّار القضاعي في كتابه ‘معجم أصحاب القاضي أبي علي الصَّدَفي‘.
ومن العجيب أننا نجد بعض العلماء يوسع دائرة الفتوى بمنع حرق الكتب وتضمين قيمتها لمن يحرقها، فيجعلها تشمل حتى كتب غير المسلمين، صيانة لحرية المعتقدات وحفظا للتعايش الديني السلمي بين مكونات المجتمع؛ ومن النصوص الفقهية في ذلك ما جاء في كتاب ‘حاشية البُجَيْرَمِيّ على الخطيب الشِّرْبِيني‘ للعلامة سليمان بن محمد البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي (ت 1221هـ/1806م) الجزمُ بـ”منع حرق كتب الكفار لما فيها من أسماء الله تعالى، ولما فيه من تضييع المال”!
ولذلك نرى مثلا السَّمَوْأل بن يحيى المغربي (ت نحو 570هـ/1174م وكان حبرا يهوديا فأسلم) يسجل -في كتابه ‘بذل المجهود في إفحام اليهود‘- أن طائفة اليهود “بلا شك أعظم الطوائف حظا” من حيث حفظ مؤلفاتها وآثارها، رغم كونها “من أقدم الأمم عهدا، ولكثرة الأمم التي استولت عليها من الكنعانيين والبابليين والفرس واليونان والنصارى والإسلام، وما من هذه الأمم إلا من قصدهم أشد القصد وطلب استئصالهم، وبالغ في إحراق بلادهم وإخرابها وإحراق كتبهم؛ إلا المسلمين” فإنهم حافظوا لهم على حضورهم الديني الحر كبقية الطوائف غير المسلمة!!
ظاهرة عابرة
لم تكن ظاهرة حرق الكتب مقتصرة على طائفة إسلامية بعينها، بل كانت عابرة لحدود الطوائف داخل الساحة العلمية الإسلامية، فمارستها كل طائفة ضد الأخرى بل ونجدها في داخل صفوف الطائفة الواحدة؛ ومن ذلك كثير من الوقائع الواردة هنا في هذا المقال.
ومن أمثلته أيضا ما ذكره القاضي عياض -في ‘ترتيب المدارك‘- من أن السلطة في الدولة الفاطمية امتحنت أحد علماء الإسكندرية يدعى أبا عبد الله محمد بن عبد الله بن عَتّاب ويُعْرَف بابن المقري (ت بعد 358هـ/969م)، فقد “كان فقيها مالكيا من خيار المسلمين ثقة مأمونا، وكان بنو عبيد (= الفاطميين) ضربوه وردُّوه عن السُّنّة، وأحرقوا كتبه”! كما أن الفاطميين -وهم شيعية إسماعيلية- أشعلوا النار في كتب إمام كبير ينتمي إلى مذهب الشيعة الاثنا عشريّة، لأنه ألّف في نقض آراء مذهبهم.
فالإمام الذهبيّ يحدثنا -في ‘السِّيَر‘- أن الإمام الشيعي الجعفري أبا الحسن ثابت بن أسلم الحلبي (ت نحو 460هـ/1069م) كان “فقيهَ الشيعة، ونحويَّ حلب..، تصدّر للإفادة وله مصنَّف في كشف عُوَار (= عُيوب) الإسماعيلية وبدء دعوتهم، وأنها على المخاريق، فأخذه داعي القوم (= مرشدهم الديني بالشام) وحُمِل إلى مصر فصلبه المستنصر (الخليفة الفاطمي ت 487هـ/1094م)؛ فلا رضي الله عمّن قتله، وأحرِقت لذلك خزانة الكتب بحلب وكان فيها عشرة آلاف مجلدة، فرحم الله هذا المبتدع الذي ذبَّ عن الملة”!
وهذا فقه نفيس من الذهبيّ السلفيّ الذي كان -من ناحية التكوين العلمي- حنبليّ الأصول العقدية شافعيّ الفروع الفقهية؛ فرغم وصفه للفقيه الحلبي بأنه “مبتدع”، فإنه نظر إلى المشترَك معه فحمِد له أنه “ذبَّ عن الملة”، وترحّم عليه داعيا بعدم رضا الله عن قاتِله ومنددا بما لاقاه من محنة على أيدي دعاة التشيع الإسماعيلي!
وفي صنيع الذهبي هذا ما فيه من سعة الفهم وفقه الواقع وأولوياته والإدراك العميق لنسبية المواقف وتشابكها. وقد اتُّهم المؤسس الفعلي للدولة الصفوية -وهي شيعية إمامية- السلطان إسماعيل شاه (ت 930هـ/1524م) بأنه “قَتَلَ العلماء وأحرَقَ كُتبَهم”؛ كما في ‘شذرات الذهب‘ لابن العماد الحنبلي (ت 1089هـ/1679م).
ومن الطريف أن نجد حبّ التميز العلمي والصدارة المعرفية ضمن أسباب حرق كتب الغير؛ وهو ما نلاقي له ذكرا فيما يحكيه ظهير الدين البيهقي (ت 565هـ/1170م) -في ‘تتمة صوان الحكمة‘- عن سبب احتراق مكتبة عظيمة كانت تابعة لبلاط الدولة السامانية في عاصمتها بُخارَى؛ فقد اتَّهم بعضُهم الفيلسوفَ المعروف ابن سينا (ت 428هـ/1038م) بأنه “أحرق تلك الكتب ليضيف تلك العلوم والنفائس إلى نفسه، ويقطع أنساب تلك الفوائد عن أربابها”!!
كما كان من العجيب أن يكون التعهد بحرق الكتب الفقهية مادة للدعاية السياسية لدى بعض طلاب السلطة، وضمن “برنامجهم للحكم” في حال وصولهم إلى سدتها؛ فقد ذكر الإمام السخاوي (ت 902هـ/1496م) -في ‘الضوء اللامع‘- أن أحد المماليك يدعى لاجين الجركسي (= الشركسي ت 804هـ/1401م).. كان -بقلة عقله- يزعم أنه يملك الديار المصرية ويُظهر ذلك ولا يتكتَّمه، والجراكسة (من الأمراء) يعظمونه ويعتقدون صحة ذلك، ويَعِدُ بإبطال الأوقاف التي على المساجد والجوامع وإحراق كتب الفقه ومعاقبة الفقهاء، إلى غير ذلك من الهذيانات..، وأن يعيد الأمر إلى ما كان عليه في عهد الخلفاء”!!
محنة حزمية
ومن جملة أسباب حرق الكتب ما كان يقع من غيرة بين بعض علماءِ المذاهب الفقهية، وخصومات واختلافات ومنافسات على التصدر والزعامة، وما يستتبعه ذلك من وشاية بعضهم ببعض عند الملوك والأمراء. ومن ذلك أن فقهاء المالكية بالأندلس كانوا يأخذون على الإمام ابن حزم الأندلسي (ت 456هـ/1065م) أمورا كثيرة في منهاجه الفقهي ومنهجه في المحاججة والخصومة العلمية، بقدر ما كان هو يشدد عليهم النكير ويتهمهم بالتعصب ونبذ نصوص الشرع لصالح آراء البشر.
ولذلك يقول الذهبي -في ترجمته من ‘السِّيَر‘- ملخصا محنة ابن حزم: “وقد امتُحِن لتطويل لسانه في العلماء، وشُرِّد عن وطنه..، وقام عليه جماعة من المالكية..، ونفروا منه ملوك الناحية فأقصته الدولة، وأحرقت مجلدات من كتبه”. وكان ذلك الإحراق بأوامر من كبير أمراء الأندلس أيامها المعتضِد ابن عبّاد (ت 461هـ/1069م) بتحريض من أولئك الفقهاء النافذين.
وعلى نحو ما رأينا من انتصار سلاطين الموحدين لكتب الغزالي بعد محنتها بالإحراق حتى “صارت قراءتها شرعا ودينا بعد أن كانت كفرا وزندقة”، حسب ابن طُمْلُوس؛ فإن كتب ابن حزم وجدت -بعد وفاته بنحو قرن ونصف- في أحد هؤلاء السلاطين من أعاد لها الاعتبار وكَتَبَ لها الانتصار، وهو السلطان المنصور يعقوب بن يوسف الموحدي الذي تقدم هنا خبره مع ابن رشد وحرقه للكتب الفلسفية.
فمؤرخ آداب الأندلس المقّري التلمساني يصف -في ‘نفح الطيب‘- المنصور هذا بأنه كان معجبا بشخصية وآراء ابن حزم، وأنه وقف يوما على قبره ثم قال: “كلُّ العلماء عيالٌ على ابن حزم”! ويبدو أن هذا الإعجاب هو الذي جعله “يثأر” لابن حزم من خصومه الفقهاء، فألزم الناسَ بالمذهب الظاهري وأمَرَ سنة 591هـ/1195م بحرق كتب فروع الفقه المالكي بذريعة ضرورة نبذ التقليد والعودة إلى نصوص الوحي قرآنا وسُنَّة، ليس في الأندلس فحسب وإنما في بلاد المغرب أيضا.
وعن وقائع هذه المحرقة ودوافعها المذهبية الخالصة يحدثنا شاهدُ عِيان على مشهد منها وقع بفاس المغربية، وهو المؤرخ المراكشي الذي يقول في كتابه ‘المُعجِب‘: “أمر [المنصور] بإحراق كتب المذهب [المالكي]..، لقد شهدتُ -وأنا يومئذ بمدينة فاس- يُؤتى منها بالأحمال فتوضع ويُطلق فيها النار…، وكان قصده في الجملة محو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة، وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث. وهذا المقصد بعينه كان مقصدَ أبيه (= أبو يعقوب ت 580هـ/1184م) وجده (= عبد المؤمن ت 558هـ/1163م)، إلا أنهما لم يُظهراه وأظهره يعقوب هذا”.
ولئن عُدَّ صنيع المنصور بكتب المالكية “ثأرا” لكتب ابن حزم؛ فإنه لا يبعد أن يكون الدافع خلف رغبة أبيه وجده في حرقها هو “الانتقام” لحرق كتاب ‘الإحياء‘ للغزالي، وهو -كما سبقت الإشارة- شيخُ مؤسِّسِ دعوتهم الممهدة لقيام دولتهم ابن تُومَرْتْ!!
وإذا كانت كتب الفقه -وخاصة المذهبيْن المالكي والظاهري الذي صار ضمن المذاهب الفقهية المندثرة– قد نالت نصيبها من المحارق على غرار كتب الفلسفة والتنجيم؛ فإنّ كتب التصوف أيضا شملها التحريق في بعض الأعصار والأمصار، كما رأينا في قصة تواصل حرق مصنّف الغزالي الأهم في علم التصوف -وهو كتاب ‘الإحياء‘- بمنطقة المغرب الأقصى والأندلس طوال أربعة عقود هي نصف عُمُر دولة المرابطين.
وبعد ذلك تكررت حوادث حرق مؤلفات الشخصيات الصوفية الجدلية، بل إن بعضهم أحرقت كتبه مرات عديدة، فمثلا “أحرِقت كتبُ محيي الدين ابن عربي (الحاتمي ت 638هـ/1240م) غير مرة”؛ وفقا لما أورده إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 885هـ/1480م) في كتابه ‘تنبيه الغبي‘.
محارق غازية
ومن كبريات المحارق التي أصيبت بها الكتب والمكتبات في الحضارة الإسلامية القديم تلك التي كانت تحصل كلما وقعت ديار الإسلام تحت احتلال أجنبي؛ منذ الهجمة الصليبية من الغرب على بلاد الشام، وحتى اجتياح المغول للأمصار الإسلامية من الشرق الأقصى وصولا إلى قلبه حيث أسقطوا عاصمة خلافته في بغداد؛ وانتهاء بمكتبات الأندلس التي أضرم فيها المسيحيون الإسبان النار كلما أخضعوا مصرا من أمصارها الإسلامية.
فقد ترجم المؤرخ جمال الدين القِفْطي (ت 646هـ/1248م) -في ‘إنباه الرواة‘- لأبي العلاء المعري (ت 449هـ/1058م)، فكان مما قاله عن مصير مكتبته الغنية على أيدي الغزاة الصليبيين: “وأكثر كتب أبي العلاء هذه عُدِمت، وإنما يوجد منها ما خرج عن المعرّة قبل هجْم الكفار (= الصليبيون) عليها (سنة 491هـ/1098م)، وقتْل من قُتل من أهلها، ونهْب ما وُجد لهم؛ فأما الكتب الكبار التي لم تخرج عن المعرة فعُدِمت، وإن وُجد شيء منها فإنّما يوجد البعض من كل كتاب”!!
ومع بداية القرن السادس الهجري/الـ12 الميلادي؛ كانت مدينة طرابلس -الواقعة اليوم شمالي لبنان- تُحْكَم بسلالة بني عمّار الكُتَامية التابعة للدولة الفاطمية، وقد بنوا فيها مكتبة عظيمة الحجم منوعة التصانيف في شتى المعارف والفنون، حتى إنها عُرفت بـ”دار العلم المشهورة في التواريخ”؛ وفقا لوصف لها ورد في كتاب ‘مسالك الأبصار‘ لابن فضل الله العمري (ت 749هـ/1348م).
وقد لاقت تلك المكتبة مصيرا محزنا حين أخضع الصليبيون طرابلس سنة 503هـ/1109م بعد حصار طويل ومؤلم؛ وما أن سقطت في أيديهم حتى “نهبوا ما فيها وأسَرُوا رجالها وسَبَوْا نساءها وأطفالها، وحصل في أيديهم -من أمتعتها وذخائرها ودفاتر (= مصنَّفات) دار عِلْمها (= مكتبتها) وما كان منها في خزائن أربابها- ما لا يُحَدُّ عَدَدُه ولا يُحْصَر فيُذْكَر”!! كما يروي المؤرخ ابن القلانسي التميمي (ت 555هـ/1160م) في ‘تاريخ دمشق‘.
ويكفي لكي ندرك حجم الكارثة التي حلت بهذه المكتبة أن نشير إلى ما يذكره المؤرخ جرجي زيدان (ت 1332هـ/1914م) -في ‘تاريخ التمدن الإسلامي‘- من أنه “لما فتح الإفرنج طرابلس الشام -في أثناء الحروب الصليبية- أحرقوا مكتبتها بأمر الكُونْتْ برترام سنت جيل (= الأمير الفرنسي برتراند بن ريموند سان جيل ت 506هـ/1112م)، وكان قد دخل غرفة فيها نسخٌ كثيرة من القرآن فأمر بإحراق المكتبة كلها، وفيها -على زعمهم- ثلاثة ملايين مجلد”!!
وفي القرن الموالي؛ تتالت المحن على مكتبات العلماء الشخصية كلما اجتاح المغول إحدى مدن الإسلام بدءا من انطلاق غزواتهم المدمرة سنة 616هـ/1221م. ويقدم لنا الإمام الذهبي -في ‘تاريخ الإسلام‘- نموذجا لما كانت تتعرض له تلك المكتبات، فيقول في ترجمته للإمام المحدِّث أبي رشيد الغزال الأصبهاني (ت 631هـ/1234م) إنه كان ثريًّا فـ”جمع شيئا كثيرا من الكتب..، وسكن بُخارَى مدة إلى أن دخلها العدو (= المغول) واستباحوها (سنة 616هـ/1221م)؛ فأحرقت كتبه وراحت أمواله”.
ويفيدنا المؤرخ ابن تَغْري بَرْدي (ت 874هـ/1470م) -في ‘النجوم الزاهرة‘- بأن المغول لما احتلوا العراق سنة 656هـ/1258م “خربت بغداد الخراب العظيم، وأحرِقت كتب العلم التي كانت بها من سائر العلوم والفنون التي ما كانت في الدنيا؛ قيل: إنهم بنوا بها جسرا من الطين والماء عوضاً عن الآجُرّ (= الطين المحروق)”!!
كارثة أندلسية
ومع بداية الثلث الثاني من القرن السابع الهجري نفسه؛ ستبدأ في أقصى الغرب الإسلامي سلسلة محارق فظيعة كان وقودها مكتبات حواضر الأندلس التي تراكم فيها العطاء العلمي بشتى صنوفه على مدى نحو ثمانية قرون، لتتواصل تلك المحارق بتواصل اكتساح الملوك المسيحيين للأقاليم الأندلسية حتى اكتمل سقوط آخر قلاعها في غرناطة.
والحق أن نشأة هذه الظاهرة بالأندلس تعود إلى ما قبل ذلك بقرون لكونها لازمت الصراع الإسلامي المسيحي هناك منذ بدايته؛ فقد قارن الإمام ابن حزم -بأسلوبه اللاذع المعهود- بين ما فعلته دولة بني عبّاد -مدفوعة بتحريض خصومه من الفقهاء- بكتبه من إحراق، وما كان حينها يصنعه المسيحيون بمصاحف القرآن كلما تغلبوا على بلد مسلم؛ فقال في أبياته الشهيرة:
فإن تَحْرِقوا القرطاسَ لا تحرقوا الذي ** تضمّنه القرطاسُ، بل هو في صدري
كذاك النـــــصارى يَحْـرِقون -إذا عَلَتْ ** أكُفُّهم- القــرآنَ في مُــدُن الثَّـغْرِ!
وما حدث حقا أن ملاحظة ابن حزم هذه لتماثل الصنيعين صدقتها الوقائع مرارا في القرون اللاحقة على زمانه؛ ففي كتابه القيم ‘دولة الإسلام في الأندلس‘؛ يروي المؤرخ عبد الله عنان خلاصة وقائع محرقة الكتب الإسلامية في غرناطة بعد استسلامها للإسبان سنة 897هـ/1492م؛ فيقول إن الكردينال فرانثيسكو خيمينيث (ت 923هـ/1517م) وجّه “بارتكاب عمل بربري شائن، هو أنه أمر بجمع كل ما يستطاع جمعه من الكتب العربية من أهالي غرناطة وأرباضها (= ضواحيها)، ونُظمت أكداسا هائلة في ميدان باب الرملة أعظم ساحات المدينة، ومنها كثير من المصاحف البديعة الزخرف، وآلاف من كتب الآداب والعلوم، وأضرمت النيران فيها جميعا”!!
ويضيف عنان أن النيران التهمت تلك الخزائن الهائلة من الكتب “ولم يَستثن منها [الأسقف خيمينيث] سوى ثلاثمئة من كتب الطب والعلوم، حُملت إلى الجامعة التي أنشأها في مدينة ألكالا دي هنارس، وذهبت ضحية هذا الإجراء الهمجي عشرات ألوف من الكتب العربية، هي خلاصة ما بقي من تراث التفكير الإسلامي في الأندلس”!!
ويشير عنان إلى تقديرات المؤرخين لأعداد الكتب التي التهمتها نيران محرقة هذا الأسقف الكاثوليكي المتعصب، والذي كان فعله أكبر معبّر عن جذور الإسلاموفوبيا المسيحية بالأندلس؛ فيقول إنه “يختلف المؤرخون الإسبان في تقدير عدد الكتب العربية التي ذهبت ضحية هذا الإجراء، فيقدرها دي روبلس (ت بعد 1013هـ/1604م).. بمليون وخمسة آلاف كتاب؛ ويقدرها برمندث دى بدراثا (ت بعد 1048هـ/1638م).. بمئة وخمسة وعشرين ألفا؛ ويقدرها البعض الآخر بخمسة آلاف فقط، ويقدرها [المستشرق خوسيه] كوندي (ت 1235هـ/1820م) بثمانين ألفا، وربما كان تقديره أقرب إلى المعقول”.
أما المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه (ت 1420هـ/1999م) فلم تورد سوى رواية الحد الأعلى ولعلها رجحتها على ما سواها؛ فقد قالت -في كتابها ‘شمس الله تشرق على الغرب‘- إنه “أحرِقت كتبٌ يتجاوز عددها المليون والخمسة آلاف كتاب، وهي ثمار حضارة وثقافة عاشت ثمانية قرون”!!
ثم يورد عنان تعليقات لبعض المستشرقين الغربيين تستنكر فعلة الأسقف خيمينيث؛ ومنها تعليق بليغ للمؤرخ الأميركي من أصل إسباني وليم بريسكوت (ت 1275هـ/1859م) يقول فيه: “إن هذا العمل المحزن لم يقم به همجي جاهل وإنما حَبْرٌ مثقف، وقد وقع لا في ظلام العصور الوسطى ولكن في فجر القرن السادس عشر، وفي قلب أمة مستنيرة تدين -إلى أعظم حد- بتقدمها إلى خزائن الحكمة العربية ذاتها”!!
ومن وقائع التاريخ الحديث ذات الصلة بظاهرة محارق المكتبات، مهما كانت درجة مرتكبها على سُلّم الحضارة بل والحداثة بالمفهوم الغربي المعاصر؛ تلك الحادثة الشهيرة المتمثلة في حرق القوات الإنجليزية لمكتبة الكونغرس أثناء اجتياحهم واشنطن سنة 1329هـ/1814م، وهو ما أدى إلى تلف 35 ألف كتاب أي نسبة 60% تقريبا من محتوياتها آنذاك!!
حرق طوعي
لئن كانت أغلبية محارق الكتب في تاريخنا إنما هي جزء من آليات السلطة القائمة المسخَّرة للتحكم في المشهد العلمي والفكري داخل حيزها الجغرافي؛ فإنه قد حصل -أحيانا عديدة- أن كان العلماءُ أنفسهم هم مَن يحرقون كتبهم بأيديهم، وتتعدد الأسباب الدافعة إلى ذلك ما بين الخشية من عواقب الخلاف المذهبيّ والتضييق عليهم من خصومهم المذهبيين، أو الخوف من بطش السلطة السياسيّة، أو بسبب تقلبات المزاج النفسي لأحدهم وضيقه بحاله المعيشية، أو لدواع منهجية علمية حقيقية أو متخيلة.
وقد أدرك هذه الظاهرة الأديب الموسوعي أبو حيان التوحيدي (ت بعد 400هـ/1010م) ورصد تعدد أسبابها؛ فقال مخاطبا صديقه القاضي أبا سهل علي بن محمد (ت بعد 400هـ/1010م) لمّا راسله معاتبا إياه على حرقه كتبه في آخر حياته حين ضاقت به الدنيا: “وافاني (= جاءني) كتابُك.. الذي وصفتَ فيه.. ما نال قلبك والتهب في صدرك من الخبر الذي نُمي إليك فيما كان مني من إحراق كتبي النفيسة بالنار وغسلها بالماء؛ فعجبتُ من انزواء وجه العذر عنك في ذلك”!!
ثم بيّن التوحيدي لصديقه القاضي الأسباب المختلفة الداعية لصنيعه ذاك؛ فكان في طليعتها أنه إنما فعله تأسِّيًا ببعض العلماء الذين أحرقوا كتبهم أو أتلفوها بطرق متنوعة ولدوافع مختلفة؛ فقال: “وبعدُ؛ فلي في إحراق هذه الكتب أسوة بأئمة يقتدى بهم..، منهم أبو عمرو بن العلاء (البصري ت 154هـ/772م) -وكان من كبار العلماء مع زهد ظاهر وورع معروف- دَفَن كتبه في بطن الأرض فلم يوجد لها أثر؛ وهذا داود الطائي (الكوفي ت 162هـ/780م) -وكان من خيار عباد الله زهدا وفقها وعبادة ويقال له ‘تاج الأمة‘- طرح كتبه في البحر..!!
وهذا يوسف بن أسباط (الكوفي ت 195هـ/811م) حمل كتبه إلى غار في جبل وطرحها فيه وسدّ بابه..؛ وهذا أبو سليمان الداراني (ت 215هـ/830م) جمع كتبه في تنّور وسَجَرها (= أشعلها) بالنار، ثم قال: والله ما أحرقتكِ حتى كدتُ أحترق بكِ؛ وهذا سفيان الثوري (ت 161هـ/779م) مزّق ألف جزء وطيّرها في الريح..، وهذا شيخنا أبو سعيد السيرافي (ت 368هـ/979م) سيد العلماء قال لولده محمد: قد تركتُ لك هذه الكتب تكتسب بها خير الآجل، فإذا رأيتها تخونك فاجعلها طُعْمةً للنار”!!
ويرى ياقوت الحموي -الذي حفظ لنا نص رسالة التوحيدي في ‘معجم الأدباء‘- أن أبا حيان إنما “أحرق كتبه في آخر عمره لقلة جدواها [الدنيوية عليه]، وضنا بها على من لا يعرف قدرها بعد موته”!!
والحق أن الحموي إنما لخص ببراعة ما عرضه التوحيدي نفسه في رسالته المذكورة؛ فقال إن “هذه الكتب حوت من أصناف العلم سرَّه وعلانيته: فأما ما كان سرّا فلم أجد له من يتحلّى بحقيقته راغبا، وأما ما كان علانية فلم أصب من يحرص عليه طالبا، على أني جمعت أكثرها للناس ولطلب المَثَالة (= الاحترام) منهم، ولعقد الرياسة بينهم ولمدّ الجاه عندهم؛ فحُرِمتُ ذلك كله..، وكرهت مع هذا وغيره أن تكون حجة عليّ لا لي”!!
دوافع نفسية
ثمّ يبسط التوحيدي الدوافع النفسية التي جعلته يحرق كتبه؛ فيقول: “ومما شحذ العزم على ذلك ورفع الحجاب عنه أني فقدت ولدا نجيبا، وصديقا حبيبا، وصاحبا قريبا، وتابعا أديبا، ورئيسا مُثيباً (= مكافِئا بالجوائز)، فشق عليّ أن أدعها لقوم يتلاعبون بها ويدنّسون عرضي إذا نظروا فيها، ويشمتون بسهوي وغلطي إذا تصفحوها، ويتراءون نقصي وعيبي من أجلها..، وكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة فما صحّ لي من أحدهم وداد، ولا ظهر لي من إنسان منهم حِفاظ (= عهد)، ولقد اضطررت بينهم -بعد الشهرة والمعرفة-.. إلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة، وإلى بيع الدين والمروءة”!!
ويحدثنا المؤرخون أن ممن حرقوا كتبهم بأنفسهم خشية الخصوم الفكريين: الإمام ابن عقيل الحنبلي (ت 513هـ/1119م)، وفي ذلك يقول ابن الجوزي في ‘المنتظم‘: “وكان أصحابنا [الحنابلة] قد نقموا عليه (= ابن عقيل) تردده إلى أبي علي بن الوليد (المعتزلي ت 478هـ/1085م) لأجل أشياء كان يقولها..، واتفق أنه (= ابن عقيل) مرض فأعطى رجلا [ممن كان] يلوذ به يقال له: معالي الحائك بعض كتبه، وقال له: إن متُّ فأحرقها بعدي!!
فاطَّلع عليها ذلك الرجل فرأى فيها ما يدل على تعظيم المعتزلة..، فمضى ذلك الحائك فأطْلع على ذلك الشريف أبا جعفر (بن أبي موسى الهاشمي إمام الحنابلة ت 470هـ/1077م) وغيره، فاشتد ذلك على أصحابنا وراموا الإيقاع به فاختفى..”. فابن عقيل إنما أمر الحائك بحرق كتبه بعد موته لخوفه من سطوة خصومه الحنابلة وما كانوا يستقوون به من علاقة بسلطة البلاط العباسي في بغداد.
وثمّة أسباب أخرى كالتغير الذي يعتري بعض العلماء في أمزجتهم العلمية والسلوكية؛ ومثله ما سبق نقله عن التوحيدي بشأن سبب إتلاف أبي عمرو بن العلاء النحوي لكتبه، وهو ما يؤكده القِفْطي -في ‘إنباه الرواة‘- بقوله: “كان أبو عمرو أعلمَ النّاس بالعرب والعربيّة وبالقرآن والشّعر..، وكانت كتبه -التي كتب عن العرب الفصحاء- قد ملأت بيتا له إلى قريب من السّقف، ثمّ إنه تغيَّر فأحرقها كلّها، فلمّا رجع إلى علمه الأوّل لم يكن عنده إلا ما حفظه بعلمه”.
ويوضح لنا الإمام الذهبي -في ‘السِّيَر‘- طبيعة هذا “التغير” الذي طرأ على هذا العالم الكبير؛ فيقول إنه “كانت دفاتره ملْءَ بيت إلى السقف، ثم تَنَسَّك فأحرقها”!! فابن العلاء عندما تنسَّك وانقطع للعبادة الشعائرية ارتأى أنه يجب التخلص من كتبه باعتبارها ملهيات عن التفرغ لتوجهه الجديد، إذْ “يختلج في صدره [حبُّ] النظر والمطالعة في وقت ما، وذلك مشغلة بما سوى الله سبحانه وتعالى”؛ وفقا لتعليل حاجي خليفة (ت 1067هـ/1656م) في ‘كشف الظنون‘.
ومثل ذلك ما ذكره المؤرخ محمد خليل الحسيني (ت 1206هـ/1791م) -في ‘سلك الدرر‘- عن العلامة عبد الجواد الكيالي الشافعي (ت 1192هـ/1778م)؛ إذْ يقول إنه “كانت له معرفة تامة ويدٌ طُولَى في الفنون الغريبة والاشتغال بها وتآليفه جليلة فيها، لكنه لم يتظاهر بمعرفة شيء، وأحرق جميعها ولم يُبق شيئا لا له ولا لغيره، وأعرض عن ذلك كله، وكان كلما حدث بشيء من ذلك يبكي ويستغفر، وأقبل على الاشتغال بعلم السادة الصوفية ومطالعة كتبهم، ولم يكن قبل ذلك مشتغلاً بالعلوم المذكورة، بل كان مُكِبًّا على العلوم الرسمية (= العقلية)”.
ويلفت الإمام الخطيب البغدادي (ت 463هـ/1072م) انتباهنا إلى سبب منهجي هو خشيتهم مما يخِلُّ بالأمانة العلمية بعدهم، وكثيرا ما دفع قدماء العلماء إلى إتلاف مصنفاتهم؛ فيقول في كتابه ‘تقييد العلم‘: “وكان غير واحد من المتقدمين إذا حضرته الوفاة أتلف كتبه أو أوصى بإتلافها، خوفا من أن تصير إلى من ليس من أهل العلم فلا يَعرِفُ أحكامَها، ويَحْمل جميعَ ما فيها على ظاهره، وربما زاد فيها ونقص فيكون ذلك منسوبا إلى كاتبها في الأصل؛ وهذا كله وما أشبهه قد نُقل عن المتقدمين الاحتراسُ منه”.
عوامل “منهجية”
وسواء أكان إحراق الكتب بفعل طوعي من مؤلفها ومالكها، أو جاء عقوبة من خصومه أيا كانوا؛ فقد تعددت النصوص المشيرة إلى تأثير ذلك أحيانا على مكانتهم ومصداقيتهم العلمية، كما شاعت ظاهرة اغتمام العلماء بسبب حرق كتبهم، وكأنهم جراء ذلك يصابون باكتئاب نفسي يغير أمزجتهم ونفسياتهم فلا تكون أهلا لأداء أمانة العلم وحقوق طلابه.
فقد ترجم الإمام تاج الدين السبكي (ت 771هـ/1369م) -في ‘طبقات الشافعية الكبرى‘- للقاضي المحدّث الفقيه عبد الله بن محمد القَزْويني الشافعي (ت 315هـ/927م) فذكر أنه كان “يجتمع في داره الحُفّاظ ويملي عليهم، ويجتمع في مجلسه جمع عظيم..، [ثم] خلّط في آخر عمره ووضع الأحاديث على متون؛ فافتُضح وأحرِقت كتبه في وجهه” عقوبةً له على إخلاله بالأمانة العلمية بتزويره أسانيد ومتون الأحاديث النبوية.
ومن هذا القبيل أيضا ما عَلَّل به الإمام ابن حجر العسقلاني -حسبما نقله عنه حاجي خليفة في ‘كشف الظنون‘- إتلافَ بعض قدماء علماء الحديث كتبهم بالحرق وغيره؛ فقال إنه بسبب أنهم كانوا “يرون أنه إذا رواها أحد بالوِجادة (= رواية الكتب بغير إجازة معتمدة) يُضعَّف [عند المحدِّثين]، فرأوا أن مفسدة إتلافها أخفُّ من مفسدة تضعيف [رواة الحديث] بسببهم”!
ومن نماذج اغتمامهم بحرق كتبهم ما جاء عند ياقوت الحموي في ‘معجم الأدباء‘: “قال عثمان بن جِنِّيّ (ت 392هـ/1003م): حدثنا شيخنا أبو علي (الفارسي ت 377هـ/988م) أنه وقع حريقٌ بمدينة السلام (= بغداد) فذهب به جميعُ علم البصريين؛ قال: وكنتُ كتبتُ ذلك كله بخطّي وقرأتُه على أصحابنا، فلم أجد من الصندوق الذي احترق شيئا البتَّةَ إلا نصف كتاب الطلاق عن محمد بن الحسن (الشيباني ت 189هـ/805م)! وسألتُه عن سَلْوَتِه وعَزائِه [في ذلك]، فنظر إليَّ عاجباً ثمّ قال: بقيتُ شهرين لا أُكلّم أحداً حزناً وهمًّا”!!
وترجم الحافظ سِبْط ابن العجمي الشافعي سبط ابن العجمي (ت 841هـ/1437م) -في كتابه ‘الاغتباط بمعرفة من رُمي بالاختلاط‘- للإمام عمر بن علي ابن المُلَقِّن الشافعي (ت 804هـ/1401م)، فقال إنه “اختلط [عقله] قبل موته بسبب احتراق كتبه”؛ أي بسبب حزنه واغتمامه من احتراقها.
ويضيف السخاوي -في كتابه ‘التوضيح الأبهر‘- أن اختلاط ابن المُلَقِّن كان “سبباً في حَجْب ابنه له عن التحديث”. وهذا الاغتمام بحرق الكتب دليل بالغ القوة على مدى ارتباط العلماء بكتبهم التي أفنوا أعمارهم في جمعها وتحصيلها وتدوينها، وقراءتها ومذاكرتها وتدريسها!!
المصدر : الجزيرة